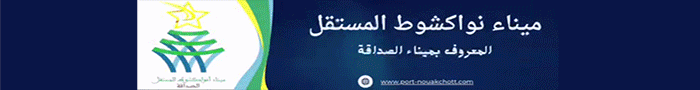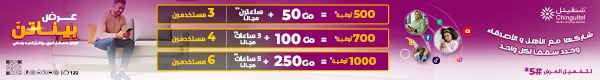..ليس من اليسير على الباحث أن يحدّد تاريخاً مُعيّناً لبداية العلاقة بين الجزيرة العربية وبلاد السودان بوجه عام، وبلدان وادي النيل بشكل خاص، بيد أنّ هناك شبه إجماع بين المؤرخين والباحثين على أنّ هذه العلاقة مُوغلة في القِدَم، تعود إلى آماد بعيدة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه حتمية تؤيدها الحقائق الجغرافية والروايات التاريخية، ذلك أنّ البحر الأحمر لم يكن في وقت من الأوقات حاجزاً يمنع الاتصال بين شواطئه الآسيوية العربية وشواطئه الإفريقية، إذ لا يزيد اتساع البحر على مائة وعشرين ميلاً عند السودان، ويبدو بهذا أنه ليس من الصعب اجتيازه بالسفن الصغيرة (1)
البرتغال ودور الأمير هنري الملاح في كشف إفريقيا- حول البدايات الأولى للكشوف الجغرافية الأوروبية الحديثة
700 عام على رحلة حج منسا موسى 1324م: قراءة في هوامش تاريخ الصلات الإفريقية-العربية
الرحلات الإفريقية للحج
وفي الجنوب يضيق البحر الأحمر لدرجة كبيرة عند (بوغاز) باب المندب، حتى لا يزيد على عشرة أميال، وهو الطريق الذي سلكته السلالات والأجناس إلى القارة الإفريقية منذ آماد بعيدة (2).
وتذهب بعض الروايات التاريخية إلى أنّ المصريين القدماء الذين عبدوا الإله حورس كانوا عرباً هاجروا من الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر عن طريق مصوع(3)، وتابعوا سيرهم عن طريق وادي الحمامات شمالاً إلى مصر، وأنّ معبد الشمس الذي بُني قرب ممفيس إنما بنته جاليات عربية، وصلت إلى هناك في وقت غير معروف، ووُجدت آثار لجاليات عربية كبيرة تسكن المنطقة المحاذية للنيل من أسوان شمالاً إلى مروى جنوباً(4)، وقد دلت الأبحاث الأثرية والتاريخية على أنّ هجرات عربية قدمت من جنوب الجزيرة واليمن عبر البحر الأحمر، يعود بعضها إلى القرن الخامس قبل الميلا د، وثبّتت بعض هذه الجاليات العربية أقدامها في بعض جزر البحر الأحمر (مثل: دهلك) منذ عدة قرون قبل الإسلام(5)، ولم يقتصر وجود الجاليات العربية على الساحل الإفريقي، بل إنّ أفراد هذه الجاليات قد توغّلوا في الداخل، ووصل بعضهم إلى ضفاف النيل، وأقاموا شبكة من طرق القوافل التجارية بين ساحل البحر الأحمر والمناطق الداخلية، وقد وصلت العرب إلى أقطار وادي النيل عن الطريق الشمالي البري المارّ عبر سيناء إلى مصر، ثم انحدرت جنوباً إلى بلاد البجة والنوبة(6).
هذا، وقد كانت التجارة تمثّل أحد أهم وسيلة لهذه الاتصالات؛ إذ نشطت حركة تجارة العاج، والصمغ، واللبان، والذهب بين الجزيرة العربية من ناحية وبين موانئ مصر والسودان والحبشة من ناحية ثانية، مما يؤكد أهميتها في حركة الاتصال، والتواصل النشط بين سواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية(7) .
وقد بلغـت هذه الهجرات أقصاها فيما بين 1500 ق.م – 300 ق.م، في عهد دولتي: (معين، وسبأ) وحمل المعينيون والسبئيون لواء التجارة في البحر الأحمر، ووصلوا في توغلهم غرباً إلى وادي النيل، ونشطت حركة التجار العرب، خصوصاً زمن البطالمة والرومان، ولا شك أنّ عدداً غير قليل من هؤلاء استقروا في أجزاء مختلفة من حوض النيل، ولحق بهم عدد من أقاربهم وأهليهم(8)، وفي القرنين السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميريين مضيق باب المندب، فاستقر بعضهم في الحبشة، وتحرك بعضهم الآخر متتبعاً النيل الأزرق ونهر عطبرة ليصلوا عن هذه الطريق إلى بلاد النوبة، كما يرجّح أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل قد انداحوا في هجرتهم حتى المناطق الغربية لسودان وادي النيل(9).
وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أنّ هناك حملات عسكرية قام بها الحميريون في وادي النيل الأوسط وشمال إفريقيا، وتركت هذه الحملات وراءها جماعات استقرت في بلاد النوبة وأرض البجة، وشمال إفريقيا(10)، كما تشير بعض الروايات إلى حملة قادها (أبرهة ذي المنار بن ذي القرنين الحميري) على السودان وبلاد النوبة والمغرب في أوائل القرن الأول قبل الميلاد، ثم إلى حملة أخرى قادها ابنه (إفريقيش) إلى شمال إفريقيا، وقد داخلت تلك الجماعات المهاجرة الوطنيين من أصحاب تلك البلاد التي هاجروا إليها، وأصبح لهم وجود معتبر فيها، ولعل وجود العمامة ذات القرنين التي كانت شارة من شارات (السلطة الكوشية) دليل على ذلك الوجود الحميري المبكر(11)، إضافة إلى عدد من القرائن الأخرى الدالة على هذا الوجود.
كذلك وردت إشارات إلى وجود جماعات من الحضارمة عبروا البحر الأحمر إلى ساحله الإفريقي في القرن السادس الميلادي، ثم اختلطوا بالبجة، وكوّنوا طبقة حاكمة خضع لها البجة، وقد عرفوا عند العرب –الحداربة – الذين استقروا في إقليم العتباي في الشمال، ثم اضطروا إلى الانتقال جنوباً في القرن الخامس عشر الميلادي، حيث أسّسوا مملكة البلو (مملكة بني عامر) في إقليم (طوكر)(12) .
على أنه من المهم الإشارة إلى نزوح بعض الجماعات النوبية والسودانية عن مواطنها إلى الجزيرة العربية، حيث تأثرت بعادات سكانها قبل الإسلام وتقاليدهم، بل مشاركتها في الحياة الاجتماعية والثقافية هناك، فقد أشار ابن هشام إلى استعانة المكّيين بنجّار قبطي في أثناء إعادتهم بناء الكعبة قبل البعثة المحمدية(13).
كما أنّ بعض المصادر تشير إلى وجود قديم لجاليات حبشية ونوبية وسودانية في بعض مناطق الحجاز في تلك الفترة أيضاً(14)، وتذكر أنّ عدد الأحباش والنوبيين كان كبيراً في عددٍ من مُدنه، وأدى وجودهم إلى أن يتعلم بعض العرب لغتهم، إذ ثبت أنّ عدداً من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلّموا بعضاً من تلك اللغات، وأنّ زيد بن ثابت وحنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي الأسدي رضي الله عنهما كانا يترجمان للنبي صلى الله عليه وسلم بالقبطية والحبشية، وقد تعلّماها من أهلها بالمدينة(15).
وتمضي هذه المصادر؛ فتذكر أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مولى نوبي اسمه (يسار)، أصابه في غزوة بني عبد بن ثعلبة فأعتقه، وهو الذي قتله (العرنيون) الذين أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، قطعوا رجله ويده، وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات(16).
وعلى الرغم من ثبوت الوجود العربي المبكر، والاتصال ببلاد النوبة والسودان في فترة ما قبل الإسلام، إلا أنه لم يكن ذا تأثير واضح في سكان البلاد، ويرجع ذلك إلى أنّ العرب وقتها لم يحملوا عقيدة واحدة واضحة، ولم يكن لهم هدف محدد سوى العمل في التجارة، والبحث عن مناخات وفرص أفضل لكسب العيش في تلك المناطق، كما هو الحال عندما جاء العرب المسلمون الذين يحملون عقيدة واحدة، ويتكلمون لغة واحدة، ويمثلون دولة واحدة، وينشدون أهدافاً موحّدة، ويكادون يتفقون في السلوك العام المنضبط بتعاليم الإسلام.
على أنّ أهم نقطة تحوّل في تاريخ العلاقة بين العرب المسلمين وبين منطقـة وادي النيل وبلاد النوبة والسودان حدثت بعد الفتح الإسلامي لمصر سنة 21ه، في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقيادة الصحابي عمرو بن العاص(17) رضي الله عنه، وكانت هي توقيع المسلمين (معاهدة البقط)(18) مع ملوك النوبة والسودان من النصارى الذين كانوا يقيمون في شمالي السودان وحاضرتهم مدينة (دنقلة)، ذلك أنّ هذه المعاهدة تضمّنت بنوداً مهمة، سهّلت وسمحت في مجملها للقبائل العربية بالهجرة، والتدفق نحو بلاد النوبة والسودان بشكل كبير لم يحدث له مثيل(19)، مما مكّنها مستقبلاً من الإحاطة بالكيانات النوبية المسيطرة، وتحوّل النوبيين وأهل السودان من النصرانية إلى الإسلام.
منافذ الهجرات العربية:
اتخذت تلك الهجرات عدداً من المنافذ، ظلت ترد عن طريقها القبائل العربية باتجاه بلاد النوبة والسودان، منها ثلاثة منافذ رئيسة، هي: المنفذ الشرقي عن طريق البحر الأحمر من الجزيرة العربية، والمنفذ الشمالي عن طريق نهر النيل من مصر، والمنفذ الشمالي الغربي، أو الطريق الليبي، عبر الصحراء الكبرى.
أولاً: المنفذ الشرقي من الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر:
يعدّ هذا المنفذ من أقدم الطرق التي سلكتها الهجرات العربية إلى بلاد النوبة وأقصرها، خصوصاً إلى القارة الإفريقية عامّة، وقد عرفه العرب قبل الإسلام، وامتدوا على ساحله الشرقي، ومنه أنشؤوا طرق قوافل تسير عليها الإبل إلى المناطق الداخلية في القارة الإفريقية، كما سلكته كثير من القبائل العربية في هجرتها وتجارتها مع القبائل التي تسكن في ساحله الغربي، مثلما فعل (الحضارمة) وقبائل (بلي) التي ساكنت (البجة) في الشرق، واختلطوا بهم.
وحين جاءت الفتوحات الإسلامية توسعت حركة الهجرة من الجزيرة العربية إلى بلاد العالم كافّة، وإلى بلدان إفريقيا على وجه الخصوص، وانفتحت منافذ أخرى للهجرة للسودان غير هذا المنفذ(20)، إلا أنّ ذلك لم يقلل من قيمته كمنفذ من المنافذ التي ساهمت بقسط كبير في الهجرة إلى بلاد إفريقيا بعامّة وإلى بلاد النوبة بوجه خاص.
ثانياً: المنفذ الشمالي عبر النيل، وبمحاذاته من مصر:
عرفت المنطقة هذا المنفذ منذ قديم الزمان؛ إذ إنه كان يمثّل الطريق التجاري الذي يربط مصر بوسط إفريقيا وبلاد النوبة والبجة، وازدادت أهميته بعد توقيع المعاهدة، حيث كفلت بعض بنودها للتجار والمهاجرين والقوافل حقّ التحرك الحُرّ فيه، وأعطتهم أماناً للتوغل في أعماق البلاد، وأصبح مدخلاً للقبائل العربية إلى بلاد النوبة(21).
ويرى أحد الباحثين أنّ هذا المنفذ كان سبباً مباشراً في تعريب بلاد النوبة(22)، وأنه أعظم خطراً وأهم دوراً من المنفذ الشرقي في أمر هجرة القبائل إلى بلاد النوبة، سواء كان ذلك قبل الإسلام أو في زمن التوسع الإسلامي(23)، وإنّ كثرة الحديث عن الهجرة العربية عبر البحر الأحمر كانت بسبب أنّ بعض القبائل العربية في السودان تدّعي أنّ أسلافها وصلوا من جزيرة العرب مباشرة إلى السودان عبر البحر الأحمر لتأييد دعواهم في الانتساب إلى أصل شريف أموي أو عباسي، أو أنهم سلالة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم(24).
إلا أنّ على الباحث ألا يغفل عن أهمية المنفذ الشرقي في دفع حركة الهجرة إلى بلاد النوبة وتوسعها(25)، خصوصاً في العهد المملوكي الذي نشطت فيه حركة الملاحة البحرية بين المواني الغربية للبحر الأحمر وبين موانيه الشرقية، بسبب الاعتداءات الصليبية المتكررة على طريق (برزخ السويس)، وهو الأمر الذي أدى لإنعاش مينائي: (عيذاب، وسواكن) اللذين وضع المماليك أيديهم عليهما تماماً، بعد تكرار الاعتداء على ممتلكات التجار المصريين المتوفين هناك(26)، هذا، ولم يقتصر تأثير المنفذ الشرقي على الجهات التي تقابل الجزيرة العربية فقط، بل تجاوزتها إلى السودان الأوسط وبلاد السودان الغربي أيضاً(27).
ومهما يكن من أمر؛ فإنّ هذين المنفذين الشرقي والشمالي يعدّان أهم المنافذ التي سلكتها القبائل العربية المهاجرة إلى بلاد النوبة في تلك الفترة.
ثالثاً: المنفذ الشمالي الغربي، أو الطريق الليبي:
سلكته القبائل العربية في هجرتها نحو بلاد النوبة والسودان، بعد أنّ تمكن الإسلام في معظم المناطق الشمالية من القارة الإفريقية، ويسير باتجاه السهول والبراري الواقعة بين النوبة وكردفان ودارفور، وقد ازدادت شهرته بعد أن قامت في مصر وشمال إفريقية دول إسلامية مستقلة عن الخلافة العباسية(28)، ولم يكن له دور فاعل ومؤثر في حركة الهجرة نحو بلاد النوبة لجفافه وصعوبته، بسبب الصحراء، وقلّة الماء؛ على أنه كان هناك عدد من الطرق والمنافذ سلكتها القبائل العربية من هذا الاتجاه، ومنها الطريق الذي يبدأ من شنقيط وينتهي إلى تمبكتو، فجاو، وزندر، وكوكوا، وبيدا، ومسنيا، وأبشي، والفاشر، ثم يخترق سهول الجزيرة، حتى ينتهي إلى سواكن، وقد اشتهر هذا الطريق لكونه قد رفد بلاد السودان والنوبة بأعداد كبيرة من العلماء والدعاة الذين ساهموا مساهمات كبيرة في نشر الدعوة الإسلامية، وتوطينها في تلك المناطق.
دوافع الهجرات العربية:
ولا شك أنّ هذه الهجرات إلى بلاد النوبة لم تتم في فترة واحدة محددة، ولم تحركها ظروف واحدة، كذلك، بل تمّت على فترات متقطعة، تنشط حيناً، وتخمد حيناً آخر، وتتحكم فيها عدد من الدوافع أو العوامل الدينية والسياسية والتجارية والاقتصادية، يمكن تناولها على النحو الآتي:
أولاً: الدوافع الدينية:
كان معظم جنود الحملات العسكرية التي سيّرها ولاة المسلمين في مصر نحو بلاد النوبة من رجال القبائل العربية، وممن شاركوا في الفتح الإسلامي لمصر، أو من المدد الذي ظلّ يصل تباعاً إلى مصر من الجزيرة العربية لتقوية السلطة، وحماية الدولة، والتوسع في الفتوح(29).
ومن الواضح أنّ الولاة في مصر لم يكونوا يترددون في تسيير الحملات العسكرية تجاه النوبة كلما أغاروا على الحدود والمدن الجنوبية للدولة، أو كلما تمردوا عن دفع ما عليهم من: (بقط والتزام)، فكان من الأهداف الرئيسة التي حرّكت أولئك المقاتلين هو الجهـاد في سبيل الله تعإلى لرد كيد الأعداء، والدفاع عن الدولة المسلمة، وحمل لواء الدعوة الإسلامية، وتبليغها للعباد، تدفعهم لذلك نصوص صريحة من القرآن الكريم، وترغّبهم في ذلك، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (التوبة: 20)، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنكبوت : 69)، وقوله تعالى: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ… ﴾ (النساء : 95).
ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَن مات ولم يغز ولم يحدّث نفســه بالغـزو مات على شـعبة مــن نفــاق»(30)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المجاهد في سبيل الله مضمون على الله؛ إمّا إلى مغفرته ورحمته، وإمّا أن يرجعه بأجر وغنيمة، ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع»(31).
فهذه النصوص الواضحة الصريحة من الكتاب والسنّة كانت هي الدافع الحقيقي لمشاركة هؤلاء الرجال في هذه الحملات الجهادية، إضافة إلى حماسهم لأجل تبليغ الدعوة الإسلامية، إلا أنّ كثيراً من المؤرخين المحدثين، الذين كتبوا عن تاريخ الهجرات العربية إلى بلاد النوبة، قد أغفلوا هذا الدافع ضمن ما ذكروا من دوافع للهجرة، على الرغم من أنه هو الدافع الرئيس لها.
ثانياً: الدوافع السياسية:
وهذه تختلف وتتباين بحسب الأوضاع في البلدين (مصر والنوبة)، فمنها دوافع خاصة بتأمين النظام السياسي في مصر وتقوية شوكته، حيث عمد عدد من الولاة في مصر إلى جلب قبائل عربية بأسرها إلى مصر لتكون قوة لهم، وسنداً يحميهم ويغطي ظهرهم عند الخطر.
وقـد أشار عدد من المؤرخين إلى أنّ عبيد الله بن الحبحاب، حين تولّى مصر من قِبَل هشام بن عبد الملك سنة 109هـ، أرسل يستأذنه في قدوم قبيلة قيس فأذن له، فقدم عليه نحو مائة من أهل بيت هوازن، ومائة من أهل بيت بني عامر، ومائة من أهل بيت بني سليم، فتوالدوا، وعندما تولّى مصر الحوارثة بن سهيل الباهلي، في خلافة مروان بن محمد، أقبلت إليه قيس وهي يومئذ ثلاثة آلاف بيت(32)، وقد شاركت أعداد كبيرة من هذه القبائل في الحملات التي أُرسلت لبلاد النوبة، فاستقرت أعداد كبيرة منهم هناك.
ومن الدوافع السياسية كذلك أنّ النوبة ظلت ملجأً لكثير من الهاربين من مصر، أو من الجزيرة العربية، بسبب الثورات، وتغيّر نظام الحكم، ويقدم هؤلاء القادة الهاربون عادة في أعداد ضخمة وكبيرة من أتباعهم وأهلهم وعبيدهم، وحوادث التاريخ تبين أنه حين اجتاحت قوات العباسيين الولايات الإسلامية هرب آخر الخلفاء الأمويين إلى مصر، حيث قُتل هناك، ثم هرب أبناء عبيد الله جنوباً إلى النوبة مصحوبين بعدد من الأقارب، والأتباع البالغ عددهم نحو 400 شخص، واستجار الأمويون بملك النوبة آملين أن يبقيهم في بلاده، لكن الملك النوبي رفض ذلك، وطلب منهم الرحيل، فتوجّهوا شرقاً مارّين بأرض البجة إلى ميناء باضع، وتعرضوا للجوع والعطش والتعب؛ فهلك عدد منهم، من بينهم عبيد الله بن مروان، ومضى أخوه إلى ميناء باضع على ساحل البحر الأحمر، حيث عبر إلى جدة، ومنها سار إلى مكة المكرمة فقُبض عليه، وأُرسل إلى بغداد، حيث بقي سجيناً حتى أيام الخليفة هارون الرشيد الذي أمر بإخراجه بعد أن أصبح كهلاً ضريراً(33).
هذا، ولا يُستبعد أن يكون رجال البجة باتفاق مع النوبيين قد غدروا بهؤلاء الأمويين تقرّباً للعباسيين، حيث كشفت الحفريات الأثرية الحديثة عن قبور هؤلاء الأمويين الفارّين على طول الطريق الذي سلكوه من النوبة إلى ميناء باضع البجاوي(34).
ويبدو أنّ بعض من نجا من هؤلاء الأمويين قد استقر على الساحل السوداني للبحر الأحمر قرب باضع، حيث اختلطوا بالسكان المحليين، وتزوجوا منهم، وأصبح لهم شأن كبير تبعاً لأصلهم القرشي، وقد كان لبقاء هؤلاء الأمويين في تلك المنطقة أثر في ادّعاء بعض الأسر السودانية بأنها تنحدر من أصل أموي، ومن الأمثلة على ذلك (أسرة الفونج)(35) المشهورة، إضافة لدور من استقر من تلك القبائل في نشر دعوة الإسلام بين سكان البلاد، وظلت بلاد النوبة تمثّل دائماً ملجأً للسياسيين والأمراء الفارّين من مصر، يلجؤون إليها لترتيب أمورهم وصفوفهم من جديد، ريثما يبدؤون محاولة الثورة والمقاومة مرة أخرى، مثل: هروب عبد الله وعبيد الله – ابني مروان بن الحكم – إلى بلاد النوبة، ومثلما فعل الثائر الأموي أبو ركوة في عهد الفاطميين(36).
ومن الدوافع السياسية، التي ساهمت في دعم الهجرة العربية إلى النوبة وتوسيعها، تلك الحملات الحربية التي سيّرها ولاة المسلمين من مصر – بعد إعدادها ودعمها -؛ إمّا بسبب انقطاع النوبة عن دفع (البقط) المقرر عليهم، وإمّا بسبب هجومهم على منطقة الحدود جنوبي مصر، وقد كانت هذه الحملات تصل إلى أعماق بلاد النوبة، ثم تستقر أعداد من المشاركين فيها في البلاد، فيساهمون في نشر الدعوة، والثقافة الإسلامية في المنطقة، ونقل الدماء العربية للنوبيين بالتزوج من ومصاهرتهم.
ومن الدوافع السياسية أيضاً تحوّل سياسة العباسيين تجاه العرب؛ إذ المعروف أنه مع الفتح الإسلامي لمصر ظلت القبائل العربية تفد إليها بأعداد كبيرة جداً، سواء دعاهم الولاة كما سبق، أو بتحرك تلقائي من قبلهم نحو مصر، فأصبحت أعدادهم كبيرة جداً، وصار لهم نفوذ مهم في الدولة، وتسيير أمورها، واستقرت جماعات منهم في الريف، ومارست الزراعة(37)، إلا أنه بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية بدأ العباسيون في استرضاء الموالي، والاعتماد على الجنود الأتراك، وعلى وجه الخصوص في عهد الخليفة المعتصم (218ه – 227هـ) فأثبتهم في الديوان، وأمر واليه في مصر (كيدر بن نصر الصفدي) بإسقاط مَن في ديوان مصر من العرب، وقطع العطاء عنهم(38).
وأدى هذا القرار الخطير إلى ثورة عربية ضد الوالي، انتهت بأسر زعمائها من القبائل العربية(39)، وبهذا «انقرضت دولة العرب في مصر، وصار جندها العجم المَوالي، من عهد المعتصم إلى أن ولي الأمير أبو العباس أحمد بن طولون، فاستكثر من العبيد»(40)؛ ففقد العرب بهذا نفوذهم القديم، وأبدوا استياءهم الشديد لهذا التحوّل في سياسة الدولة، وكثرت ثوراتهم في أول قرن للدولة العباسية، وقامت ثورات يقودها أمراء أمويون في صعيد مصر، أيدتها كثير من القبائل العربية، ولم تفلح الحكومة المركزية في إخمادها إلا بعد جهود كبيرة(41)، وأعلنت كذلك قبائل قيس العصيان، ورفضت دفع الخراج المقرّر عليها(42).
فكان طبعياً أن يتبع هذه الاضطرابات نزاعات كثيرة، بين هؤلاء الذين امتنعوا عن دفع الخراج المقرر عليهم – مع التمتع بملكية الأراضي التي يفلحونها وخيراتها – وبين ولاة الأمر في مصر، وأدى ذلك في النهاية إلى توسيع الشقّة بين العرب والولاة من حكام مصر، فكان لهذا التوتر في العلاقة، ولهذا الضغط السياسي والاقتصادي، أسوأ الأثر في نفوس العرب، الذين فقدوا مصدر رزق مهمٍّ بالنسبة لهم، ولم يبقَ أمامهم إلا أحد أمرين: إمّا أن يذعنوا للأمر ويسلّموا بهذا الواقع، وإمّا أن ينزحوا نحو صعيد مصر بعيداً عن سلطة الوالي؛ فآثروا الأمر الثاني، وأخذوا منذ أوائل القرن الثالث الهجري ينزحون للصعيد المصري، ومنه لبلاد النوبة في مجموعات صغيرة، دون أن تسترعي انتباه أحد، أو يسجل التاريخ تفاصيلها، والأغرب من ذلك أنهم قد اجتازوا الحدود بين مصر والنوبة في هدوء شديد، لم يلفت إليهم صاحب الجبل والي الإقليم الشمالي من قبل النوبة الموكل بحفظ الحدود الشمالية لبلاده، والذي يحول دون دخول أي شخص للبلاد دون تصريح رسمي يسمح له بذلك(43).
ثالثاً: الدوافع التجارية والاقتصادية:
ظلت العلاقات التجارية بين مصر والنوبة مزدهرة منذ قديم الزمان، وذلك لحاجة البلدين؛ إذ كانت مصر تحتاج إلى كثير من المنتجات التي لا تتوفر فيها، مثل: الأخشاب، والعاج، والأبنوس، وبعض التوابل.. وغيرها، فخرجت قوافل تجارتها منذ قديم الزمان إلى الجنوب منها، حتى وصلت إلى أجزاء نائية من القارة الإفريقية(44).
وارتبطت مصر مع بلاد النوبة بصلات تجارية قوية؛ فكانت مدينة أسوان مجمعاً للتجار من أهل السودان ومن النوبة، وكان التجار النوبيون يقدمون إلى أسوان عن طريق النيل حتى الجنادل، ثم يتحولون إلى ظهور الإبل حتى يصلوا إلى أسوان(45)، وقد سكنها كثير من العرب لمناخها الذي يقارب مناخ الجزيرة العربية ولمركزها التجاري(46)، إضافة إلى أنّ النوبة كانت تصدّر عن طريق أسواقها أهم منتجاتها من: (الذهب والزمرد) الذي ينتج في وادي العلاقي(47)، إضافة إلى الرقيق، والعاج، والأخشاب الصلبة، والأبنوس، وسنّ الفيل لصناعة العاج، الذي يُستخدم في الزينة، وريش النعام، والحديد الذي يُستخرج ويصهر بالقرب من نباتا ومروى(48)، وكانت ترد إلى النوبة المنسوجات، والقمح، والنحاس من مصر(49).
وحين وقّع عبد الله بن سعد (عهد الصلح) مع ولاة النوبة نصّ صراحة على حقّ الترحال لرعايا البلدين في البلد الآخر دون الإقامة الدائمة؛ فساق هذا الحقّ التجار المسلمون إلى أعماق النوبة مع بضاعتهم، وتجارتهم، وعقيدتهم الإسلامية، واستطاعوا بما اكتسبوا من معرفةٍ بأحوال البلاد تمهيد الطريق لهجرة القبائل العربية في أعداد كبيرة، بل نجد أنّ أعداداً منهم قد استقرت في فترة مبكرة في (سوبا) عاصمة (مملكة علوة) النصرانية جنوب المقرة، حتى أصبح لهم حيٌّ كامل يُعرف بهم(50).
ومن الدوافع الاقتصادية كذلك التي ساهمت في دفع القبائل العربية للهجرة نحو جنوب مصر، في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، سماع القبائل بمعدني: (الذهب، والزمرد) عبر الصحراء الشرقية لبلاد النوبة، واشتهار أمرهما، خصوصاً في وادي العلاقي من أرض البجة، فأدى ذلك إلى اجتذاب كثير من القبائل العربية المختلفة إلى هذه الأوطان للعمل فيها، واستغلال مناجمها(51)، وأدى استقرارهم هناك إلى اختلاطهم بقبائل البجة عن طريق المصاهرة، فنقلوا إليهم العقيدة الإسلامية، وتغيّرت كثير من عاداتهم وتقاليدهم بهذا النسب الجديد(52).
إضافة لذلك؛ فإنّ المعلوم عن مراعي النوبة وأراضيها أنها أكثر خصوبة من أراضي شبه الجزيرة العربية ومراعيها، وعلى وجه الخصوص النوبة الجنوبية(علوة) التي كانت أكثر اتساعاً وأخصب أرضاً وأوفر ثروة من المقرة(53)، إضافة إلى أنّ مناخ النوبة الشمالية (المقرة) يشابه مناخ شبه الجزيرة العربية وبيئتها(54)، وهو ما يوائم حياتهم التي جُبلوا عليها في حبّ الترحال والتنقل، وقد كان لهذا التشابه في المناخ وطبيعة البلاد والأرض المسطحة أثره في دفع هذه القبائل للتقدّم نحو الجنوب، وهي قبائل بدوية رعوية، أو شبه رعوية، لا تستطيع التقدّم إلا في السهول المكشوفة؛ فكان تدفقهم في كلّ أرض وصلوها يقف عند اصطدامهم بعقبات طبيعية: كالبحار، والجبال، والغابات، وهذا ما حدث بالضبط؛ إذ إنّ تلك القبائل لم تتوقف في زحفها إلا عند المناطق التي تسوء فيها الطرق، وتتفشى فيها الأمراض الفتاكة، بيد أنّ هذه الجماعات العربية المهاجرة اختلطت بالعناصر النوبية والبجاوية في تلك المناطق، وأدى هذا الاختلاط إلى تأثر هؤلاء بالدماء العربية التي كانت تتجدد باستمرار مع توالي وصول عناصر عربية جديدة إلى هذه الجهات(55)، إضافة إلى اعتناق عدد منهم للإسلام في هذه الفترة بالرغم من جهلهم باللغة العربية(56)، والراجح أنّ العرب تعلّموا لغة النوبيين بعد أن اختلطوا بهم، واستطاعوا بذلك نشر ثقافتهم الإسلامية في بلاد النوبة(57).
أشهر القبائل العربية المهاجرة:
هذا، وقد تعاظمت أعداد القبائل العربية المهاجرة، وانتشرت أحياء العرب من جهينة في بلادهم – أي النوبة -، واستوطنوها وملكوها(58).
وذلك في المراحل الأخيرة للمملكة النوبية النصرانية، والتي أصابها الضعف والوهن بسبب خلافاتها الداخلية، وبسبب الضغط القوي للقبائل العربية التي سارت في زحفها حتى بلغت أرض البطانة(59) والجزيرة(60)، ثم عبر بعضها نهر النيل إلى كردفان ودارفور، وهناك التقت هذه الموجة المهاجرة بموجة أخرى، كانت قد تابعت شاطئ النيل الغربي حتى دنقلة، فوادي المقدم(61)، ووادي الملك، حتى بلغت في مسارها مملكة (كانم برنو)، حيث كان الإسلام قد بلغ تلك الجهات من بلاد المغرب وشمال إفريقيا(62).
واستقر بعض هؤلاء المهاجرين في سهول أواسط البلاد، وانفتحوا على السكان الوطنيين من النوبة وغيرهم من البجة والزنج، فصاهروهم، وعندما بلغوا كردفان ودارفور اضطر جزء منهم أن يتخلوا عن إبلهم، ويعتمدوا على الأبقار في ترحالهم، ومِنْ ثَمّ عرفوا باسم (عرب البقارة)(63).
وبرغم الخلاف الواسع بين الباحثين في أعداد القبائل العربية التي هاجرت إلى بلاد النوبة، وفي أنسابهم، فإنه يمكن القول بما اتفق عليه معظم الباحثين: إنّ الجماعات العربية التي هاجرت إلى بلاد النوبة قد اشتملت على المجموعتين العربيتين، وهما مجموعتا: (العدنانيين)، و (القحطانيين)(64)؛ حيث يمثّل العدنانيون: (الكواهلة)، والمجموعة (الجعلية)، وبعض القبائل الأخرى، في حين يمثّل القحطانيون: المجموعة (الجهنية)(65).
أشهر القبائل العدنانية: يُقال: إنّ (الكواهلة) ينتسبون إلى كاهل بن أسد بن خزيمة، وإنهم قدموا إلى بلاد النوبة من جزيرة العرب مباشرة عبر البحر الأحمر، واستقروا في الإقليم الساحلي بين سواكن وعيذاب(66)، ويُنسب إليهم كذلك (البشاريون) و (الأمرار) و (بنو عام)(67)، ومن المؤكد أنّ أولاد كاهل قد عاشوا زمناً في الأقاليم الساحلية الشرقية، والمناطق التي تليها، ثم انتشروا انتشاراً تدريجياً نحو الغرب(68).
أمّا المجموعة (الجعلية)؛ فيقال: إنهم ينتسبون إلى إبراهيم الملقب بـ (جعل)، من نسل العباس عمّ النبي صلى الله عليه وسلم، وترجع أسباب هذه التسمية إلى أنّ إبراهيم هذا كان جواداً مضيافاً، وأنه كان يقول للوطنيين وغيرهم من العرب: «إنا جعلناكم منّا، أي أصبحتم منا»(69)، وتدل هذه العبارة، وكثرة ترديدها، على أن التوغّل العربي الإسلامي في المنطقة كان توغّلاً سلميّاً مبنيّاً على التودد والصلات الحسنة مع السكان الوطنيين من النوبيين وغيرهم، إلا أنّ هناك مصدراً آخر يشير إلى أنّ سبب هذه التسمية، أو هذا اللقب، سمة إبراهيم الشديدة ومنظره(70)، والواقع أنه لم يرد لفظ «جعل» ومشتقاته في أسماء قبائل العرب القديمة إلا في قبيلتين: إحداهما جعال بن ربيعة، أقطعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرض إرم من ديار جذام، والأخرى: بنو حرام بن جعل بطن من بلى من قضاعة، وهم بنو حرام بن عمرو بن حبشم(71)، فاللفظ إذن معروف في الجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة العرب، أي في الموطن الأول الذي أمدّ مصر بموجاته العربية المتلاحقة.
وتؤكد رواية أخرى أنّ من بين الصحابة الذين نزلوا مصر حزام بن عوف البلوي، وكان من بني جعل من بلى، وهو ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في رهط من قومه بني جعل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صخر ولا جعل، أنتم بنو عبد الله»(72)، على أنه من الصعب القول بإيجاد صلة بين الجعليين الذين هاجروا إلى بلاد النوبة وبين القبيلة المذكورة هنا.
والراجح أنّ الجعليين لم يكونوا قبيلة واحدة، بل هم مجموعة من القبائل ذات نسب متقارب، هاجرت على دفعات، وعلى مدى عدة قرون، وأهم هذه القبائل: الميرفاب، والرباطاب، والمناصير، والشايقية، والجوايرة، والركابية، والجموعية، والجمع، والجوامعة، والبديرية، والغديان، والبطاحين(73)، ومن القبائل العدنانية كذلك: قيس عيلان، وكنانة، وبنو حنيفة، وربيعة، وبنو فزارة، وبنو سليم، وبنو يونس(74).
أما أشهر القبائل القحطانية التي هاجرت إلى بلاد النوبة: فهي قبائل بلي، وجهينة، وقد ذكر المؤرخون أنّ الصعيد الأعلى في هذه المرحلة – خلافة المعتصم – سكنته جموع كبيرة من عرب سبأ، ونزل منهم أرض المعدن خلق كثير، كانت بلي وجهينة من جملتهم(75).
وينتسب هؤلاء الجهنيون إلى عبد الله الجهني الصحابي رضي الله عنه، وهو وإن لم يكن من جهينة مباشرة فإنه من قضاعة التي تنتسب إليها جهينة(76)، وتضم قبائلها: قبائل رفاعة، واللحويين، والعوامرة، والشكرية، وقد سكن هؤلاء في النصف الشرقي من سودان وادي النيل، وعلى شاطئ النيل الأزرق والبطانة، وفي كردفان، مثل قبائل دار حامد، وبني جرار، والزيادية، والبزعة، والشنابلة، والمعاليا، وفي غرب كردفان ودارفور تشمل قبائل الدويحية، والمسلمية، والحمر، والكبابيش، والمحاميد، والماهرية، والمغاربة، والبقارة(77).
ومن القبائل القحطانية كذلك: قبيلة بهراء، وهي بطن من قضاعة التي انتشرت بين صعيد مصر وبلاد الحبشة، وكان لهم فضل كبير في تقويض دعائم المملكة النوبية(78).
ومـا يخرج به الباحث من خلال تتبّع هجرة القبائل العربية في بلاد النوبة، هي سرعة اختلاطهم بالسكان النوبيين وغيرهم من الوطنيين في فترة وجيزة، كذلك لا تكاد تجد أسماء من القبائل العربية في مصر إلا وتجد له نظيراً في بلاد النوبة؛ مما يؤكد أهمية المنفذ الشمالي القادم من مصر عن طريق النيل في أمر الهجرة وتوسّعها، إضافة إلى ذلك فإنّ هذه الهجرات لم تتم في وقت معلوم محدّد بفترة زمنية معينة، يمكن إحصاؤها وتقديرها.
أهم الآثار الثقافية للهجرات العربية:
ظلّ سجل الثقافة النوبية حتى دخول العرب – المسلمين – بأعداد كبيرة يتأرجح في تفاعل بين ثقافتي الزنوج والحاميين من جهة، وما طرأ عليها من مؤثرات خارجية على رأس الأثر المصري من جهة أخرى.
فقد كان للحضارات المصرية التي قامت على حوض النيل الشمالي أثر كبير في الشعوب التي سكنت من حولها بوجه عامّ، وبلاد النوبة على وجه الخصوص، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في مقدمة هذه الدراسة، حيث أدت تلك العلاقة إلى تسرّب الأفكار، والمعتقدات، والطقوس، والعادات، والتقاليد، كنتاج طبيعي أو حتمي للصلات الفكرية والتجارية التي كانت قائمة بين البلدين، فكان قدماء المصريين يعتبرون ديار جيرانهم إلى الجنوب مصدراً مهمّاً للمنتجات الإفريقية، ومدخلاً رئيساً لها، فتوغلت القوافل التجارية منذ الدولة المصرية القديمة محمّلة بأدوات الزينة والحلي والأسلحة، وكانت تعود بالذهب والزمرد والرقيق والأبنوس والعاج.
وبازدهار هذه العلائق التجارية؛ توغّل التجار جنوباً، وأثروا تأثيراً حضارياً كبيراً، مما جعل بعض المؤرخين يذهبون إلى أنّ هذه الأجزاء من النوبة خضعت لفترات طويلة للاحتلال المصري المباشر، وقد تجلّى ذلك في كثير من مظاهر الحياة النوبية في جانبها الثقافي والحضاري، مما لا تزال مشاهده وآثاره باقية في أشكال الأواني الفخارية, ومدافن الموتى, وطريقة الدفن، وبناء قصور الملوك, إضافة إلى انتشار المعابد المصرية والرسومات الهيروغليفية, وتفشي عبادة الآلهة المصرية جنباً إلى جنب مع بعض الآلهة الوطنية المحلية, كما بقيت الأهرامات, وطريقة دفن النوبيين لموتاهم في البركل، ومروى، وكبوشية(79), خير شاهد على ذلك الأثر الثقافي المصري القديم(80).
وما أن ازدهرت الديانة النصرانية في العهد النصراني في بلاد النوبة, حتى صبغت البلاد بكثير من مظاهر ثقافتها، وتمثّل ذلك في تحويل المعابد القديمة إلى كنائس, وتمّ تشييد الكاتدرائيات التي مُلئت بالزخارف والنقوش, وبعض المشاهد من الإنجيل وصور القديسين(81).
ويظهر الأثر البيزنطي في التحف الفنية التي عُثر عليها في (كنيسة فرس)، إضافة لقطع الفخار وصور الحيوانات التي ظلت تمثّل تقليداً وطنياً كان منتشراً في (مملكة علوة)(82).
كذلك يُلاحظ الأثر النصراني القبطي في استخدام اللغة القبطية في أداء الطقوس الدينية الكنسية، وقد تُرجمت فيما بعد إلى اللغة النوبية(83), وكان كل ذلك بسبب هيمنة الكنيسة المصرية على الكنيسة النوبية, بل أضحت الكنيسة المصرية هي التي تقوم بتعيين الأساقفة وإرسالهم للكنيسة النوبية(84), ومع ذلك بقيت بعض العادات والتقاليد النوبية الوثنية سائدة في المجتمع النوبي(85)، وهذا ما يؤكد ما وصلت الإشارة إليه سابقاً من أنّ العقيدة النصرانية لم تتفاعل مع مشاعر الجماهير، بل إنها فُرضت على الناس فرضاً, إلا أنّ ذلك لا يمنع من القول: إنّ النصرانية قد ساهمت في تعديل كثير من العادات والتقاليد الوثنية النوبية وتهذيبها، وبسطت بعض مفرداتها اللغوية والثقافية في البلاد, وعاشت جنباً إلى جنب في المجتمع النوبي مع الموروثات الثقافية الوثنية, حتى تمكّن الإسلام في البلاد.
ولعلّه من المهم جداً أن يدرك دارسو حركة مسار الدعوة الإسلامية أنّ انتشار الإسلام: يعني حقيقة: انتشاراً لظواهر ثلاث متلازمة، هي:
1 – انتشار الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية.
2 – انتشار الثقافة العربية الإسلامية.
3 – انتشار اللغة العربية، باعتبارها لغة القرآن الكريم، والخطاب الإسلامي.
«ولا يفهم من ذكر هذه الظواهر على هذه الصورة أنّ كلّ ظاهرة منها كانت منفصلة عن الأخرى تماماً, إنما كانت مختلطة متشابكة، تسير جنباً إلى جنب، وتتفاعل كلها في وقت واحد، وتخضع لمؤثرات تكاد أن تكون واحدة»(86).
وقد خضعت الثقافة الإسلامية, وانتشارها، للظروف نفسها التي خضعت لها الحضارة الإسلامية, ومرّت بالتطورات نفسها التي مرّت بها الحضارة الإسلامية.
فقد جابهت الثقافة الإسلامية في إفريقيا المشكلة نفسها العامّة التي جابهتها الثقافة الإسلامية في العصور الوسطى, وهي مشكلة أو ظاهرة الالتقاء الثقافي, بل هي المشكلة نفسها التي تواجهها الحضارات الإنسانية عموماً حين تلتقي وتختلط وتتبادل التأثيرات، فمثلاً في مصر التقت الثقافة الإسلامية الوافدة بثقافات إغريقية مصطبغة بصيغة الحضارة المصرية القديمة(87), هذا الالتقاء أظهر طرازاً من الحضارة الإسلامية متأثراً في طابعه العام ببعض هذه الثقافات، أي أنّ ذلك يعني «أنّ الإسلام أخذ وأعطى، ومن هذا الأخذ والعطاء ظهرت الحضارة الإسلامية في مصر»(88).
وقد ورد في أمر النوبة آنفاً أنها وقّعت مع المسلمين (عهد البقط) بشرائطه تلك, وذلك العهد يمثّل نوعاً من الاتصال الدائم بين المسلمين والنوبة مدة ستة قرون ونيف, تسربت خلالها المؤثرات الإسلامية مع القبائل العربية التي بدأت تتغلغل هناك منذ القرن الثاني للهجرة، على الرغم من أنّ المعاهدة كانت تعطيهم حقّ الدخول في النوبة، مجتازة لا مقيمة, إلا أنّ هذه القبائل تقدّمت في هجرتها وتوغلت جنوباً, واستقرت قطاعات عريضة منها في شرق ووسط وغرب السودان, حتى وصل هذا الوجود إلى بلاد الحبشة ودارفور في أواخر القرن السادس الهجري(89).
وخلاصة الأمر:
إنّ الوجود العربي الإسلامي في بلاد النوبة لم يظلّ حبيس المناطق الشمالية, بل ظلّ يمتد على الدوام, ويتوسع جنوباً في كل ركب نازح, أو هجرة لقبيلة, أو جماعة من المسلمين، تدفعهم إلى ذلك دواعي نشر العقيدة الإسلامية, وبسط دعوتها, إضافة إلى دوافع أخرى أمنية وسياسية واقتصادية, وانفتحوا على السكان الأصليين من نوبيين, وبجة, وزنج, وغيرهم, فصاهروهم وأحدثوا مؤثرات كبيرة في حياة النوبيين، بما حملوه معهم من دعوة, وثقافة, ولغة, ونظام حياة, وقد قويت شوكتهم, وأصبحوا مستظهرين على جميع من جاورهم هناك من النوبة والبجة إلى سنة أربع ومائتين(90).
ثم إنّ المعاهدة ضمنت للمسلمين فتح بلاد النوبة للتجارة، والسماح لتجارتهم بارتياد البلاد على ألا يقيموا فيها، فكان التجار من أهم وسائل نشر الثقافة الإسلامية في بلاد النوبة, وهو دور لا يُستبعد أن يكون ولاة المسلمين قد توقّعوه من هذه الفئة المعروفة بنشاطها في مجال نشر الدعوة(91), وعلى إثر ذلك الاتفاق توغّل التجار إلى أعماق بلاد النوبة، ومع أنهم كانوا منصرفين إلى الأعمال التجارية في المقام الأول إلا أنهم كانوا رواداً في نشر العقيدة الإسلامية بين الوطنيين, واستطاعوا بما كسبوا من معرفة بأحوال البلاد, ونقلهم تلك المعرفة لمواطنيهم، تمهيد الطريق لهجرة القبائل العربية في أعداد كبيرة(92).
كذلك من أهم وسائل انتقال الثقافة الإسلامية، وانتشارها وسط النوبيين، الأفراد والمجموعات التي شاركت في الحملات التأديبية التي سيّرها سلاطين المسلمين وولاتهم على النوبة، عند إغارتها على جنوب مصر، أو عند تمردها على التزامها بدفع ما عليها من (بقط)، حيث كانت أعظم هذه الحملات، وأكثرها على بلاد النوبة في العهد المملوكي(93), وقد استغل هؤلاء الجنود فرض الأمن والحماية, وحقّ التوغّل التي كفلها لهم (عهد البقط)؛ فاستقروا هناك بعد أن خلعوا عنهم صفات الجندية الرسمية, وهو الأمر الذي طمأن النوبيين, فزوجوهم من بناتهم, وتوثقت الصلات بينهم، فنقل إليهم هؤلاء المحاربون القدامى كثيراً من المؤثرات الثقافية الإسلامية.
بالإضافة لهذه الجهود كانت هناك جهود بذلها الدعاة الذين حملوا هم الدعوة, ونقلوا كثيراً من مظاهر الثقافة الإسلامية للنوبيين, والتاريخ مليء بالشواهد الدالة على مدى توفيقهم في دعوتهم، ولذلك أسباب، منها حماسهم الديني، وما اتصف به الإسلام من بساطة ووضوح, وإضافة إلى أنهم في كثير من الأحوال كانوا يصاهرون القبائل الوثنية، فيعينهم حقّ الأم على توطيد مراكزهم في الأسر(94).
وقد ساهمت كلّ تلك العوامل في نشر الثقافة الإسلامية وسط أهل النوبة المسلمين الذين تأثروا بها تأثرّاً مباشراً, بل تجاوز هذا التأثير الإسلامي هؤلاء المسلمين إلى غيرهم من الذين بقوا على نصرانيتهم وإلى الوثنيين منهم.
وهذا لا يعني أنّ الثقافة الإسلامية قد قضت تماماً على الموروثات الثقافية النوبية, إذ إنّ ما حدث كان نوعاً من التأثير الثقافي من حضارة قوية وافدة على حضارة نصرانية ضعيفة، تتخللها بعض الموروثات من العادات والتقاليد الوثنية الضاربة في أعماق البلاد، لذلك لم تتخل النوبة عن كلّ ما هو قديم وتليد، لأنّ ذلك فطرة الإنسان من حيث هو كائن, يرعى تراث الآباء والأسلاف ويفاخر بما خلّفوه له, بل ينظر إليه على أساس أنه تراث يجب حفظه, والدفاع عن بقائه، إضافة إلى أنّ الإسلام لم يطلب من الذين اعتنقوه وأقبلوا عليه التخلّي عن كلّ موروثاتهم القديمة ما دامت لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وقد أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض من عادات العرب في الجاهلية ما لم تكن مخالفة لتعاليم الإسلام – كما سبقت الإشارة إليه –، بل إنه أثنى على بعض تلك الموروثات، وأشار إلى أنه لو دُعي إليها في الإسلام لاستجاب وشارك فيها، مثل (حلف الفضول) الذي حضره الرسول صلى الله عليه وسلم في دار عبد الله بن جدعان بمكة المكرمة قبل مبعثه(95).
إضافة إلى أنّ منهج الإسلام في التعامل مع ذلك الموروث هو العمل على تهذيبه، وتنقيته مما يتعارض مع الدين, وهذا ما حدث في كلّ المناطق التي أقبلت على الإسلام في إفريقيا, ونشأت بذلك بيئات حضارية محلية، لكلّ بيئة مقوماتها الخاصة، واتجاهاتها الخاصة كذلك, ولكن تجمعها في إطار واحد صفات إسلامية مشتركة من وحدة الدين, واللغة, والمُثُل(96).
ويمكن أن نسمّي ما حدث في النوبة نوعاً من الملاءمة – أو المثاقفة – بين المحلّي الموروث وبين الإسلامي المكتسب, وقد تبدّت بعض مظاهر تلك الثقافة الوليدة عند سلاطين إفريقيا الغربية في طريقة جلوس السلطان للمظالم, وفي لباسه، وفي المحطين به, واستخدام الطبول المصنوعة من القصب والقرع(97), إضافة لما ذكره بعض المؤرخين الذين شهدوا تلك الممالك, ومن وصف للقصر ولحياة السلطان, واستخدامه لبعض المناصب والمصطلحات الإدارية, مثل: نائب السلطان, والفرادية الأمراء, والتراجمة(98), وقد أشار بعض المؤرخين إلى تفشي هذه الظواهر نفسها عند السلاطين الذين ورثوا الممالك النوبية, فيبدو الأثر الإسلامي واضحاً في عاداتهم وأخلاقهم، وفي الألقاب, والنُّظُم والرسوم(99).
أيضاً من مظاهر تأثّرهم بالثقافة الإسلامية ما عُثر عليه في منطقة مينارتي – شمال دنقلة – من كتابات عربية على شواهد بعض القبور، تحمل أسماء عربية في القرنين الثاني والثالث الهجريّين(100), وفي منطقة كلابسة ترجع إلى سنة 317هـ / 927م(101), كما عُثر في المنطقة نفسها على مقابر نوبية عليها كتابات باللغة القبطية, تحمل تاريخاً مزدوجاً من التقويمين: القبطي, والهجري, ويبدو أنها من آثار جاليات عربية, ثبت أنها استقرت هناك من القرن الثالث الهجري(102), بل تظهر بعدها كتابات لا تحمل سوى التاريخ الهجري، وترجع إلى القرن نفسه(103).
وإذا كان هذا الأثر الإسلامي قد تبدّى فيما كُتب على شواهد القبور هذه، فإنه يتوقّع أن يكون هذا الأثر قد صاحب كلّ المراحل التي تمر بها جنازة المتوفى، بدءاً من غسله وتكفينه حسب السنّة النبوية، ثمّ الصلاة عليه، فانتهاءً بدفنه في اتجاه القبلة.
ومن مظاهر انتشار الثقافة الإسلامية وسط النوبيين اتخاذهم للأسماء العربية, وتسميتهم بها, فتتحدث المصادر عن أنّ حاكم إقليم الجبل النوبي اسمه (قمر الدولة كشي)(104), وعن بعض علماء المسلمين من النوبة، مثل: يزيد بن أبي حبيب، وذو النون المصري (النوبي الأصل)(105)، وتحية النوبية الزاهدة(106)، وغيرهم ممن تسمّوا بالأسماء العربية بدلاً من اتخاذهم الأسماء النوبية.
كذلك من المؤثرات الثقافية التي انتقلت إلى النوبيين من المسلمين اتخاذهم الحوادث التاريخية الشهيرة مناسبات، يؤرخون بها، إذ كان العرب يؤرخون بالحوادث العظيمة في حياتهم، كسيل العرم، وبناء الكعبة، وحرب البسوس، ويوم حليمة، وغيرها(107)، فاتخذ النوبيون والعرب المستعربون في بلاد النوبة حوادث: كسنة البعوضة، وسنة الفار، وقتلة العقال، وأصبحوا يؤرخون بها(108).
وفي مجال العقوبات والجنايات بدا الأثر الثقافي الإسلامي واضحاً في حياة النوبيين الذين كان من أعرافهم الاجتماعية طرد مَن يرتكب جريمة السرقة من القرية(109), إضافة إلى أنّ النوبي كان إذا خامره شك في زوجته حملها ليلاً إلى النهر وأغمد مديته في صدرها، ثم يقذف بها في النيل، بينما أنه في حالة الطلاق يستولي على جهاز مطلقته, ثم يحلق رأسها, ووجود هذه الشرائع والأعراف في المجتمع النوبي يؤكّد ضعف الأثر النصراني في البلاد, إذ أنها شرائع وأعراف تتنافى مع التعاليم النصرانية وشرائعها, إلا أنهم سرعان ما تأثروا بشريعة الإسلام, وآدابه في التعامل مع هذه المواقف, والجنايات, فتقلّصت إلى حدٍّ كبير تلك الثقافات الوثنية التي ظلت سائدة تحكم الحياة النوبية وتوجهها.
هذا، ولم يقف أثر الثقافة الإسلامية على عامّة النوبيين فحسب, بل نجده قد تجاوزهم إلى ملوكهم وحكامهم الذين عرفوا الكثير عن الإسلام وأركانه, وفرائضه, وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم, وعن سيرته صلى الله عليه وسلم, وعن أنساب القرشيين وقرابة الصحابة, والأسر الحاكمة بعضها من بعض, فيتضح ذلك من نصّ الحوار الذي دار بين عبيد الله بن مروان بن محمد (آخر الولاة الأمويين على مصر)، حين فرّ إلى بلاد النوبة خوفاً من العباسيين الذين أرسلوا في طلبه، وبين ملك النوبة حين علم بقدوم عبيد الله ودخوله أرض بلاده، إذ يبدو الأثر الإسلامي واضحاً في سؤال الملك النوبي لعبيد الله عن: «كيف سُلبتم ملككم, وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم؟»، فقال عبد الله: «إنّ الذي سلب منا ملكنا أقرب إلى نبينا منا (يقصد بذلك بني العباس)»، قال له ملك النوبة: «فكيف أنتم تلوذون إلى نبيكم بقرابة وأنتم تشربون ما حرم عليكم من الخمور، وتلبسون الديباج وهو محرم عليكم, وتركبون في السروج الذهب والفضة وهي محرمة عليكم، ولم يفعل نبيكم شيئاً من هذا؟»(110).
كما أنّ النوبيين كانوا ينظرون إلى المسلمين على أنهم أصحاب حضارة وثقافة أرقى وأسمى، فما كانوا ليترددوا في الإقبال عليها والأخذ منها، ومما يؤكد نظرتهم تلك مبادرة الملك النوبي إلى يد الأمير عبيد الله وتقبيلها حين التقيا(111), بالرغم من أنّ عبيد الله لم يكن رأس الدولة الإسلامية, وإنما هو أمير من الأمراء، أو والي من الولاة، بينما كان النوبي ملكاً على البلاد كلها.
انتشار اللغة العربية:
لقد سبقت الإشارة إلى أنّ انتشار الدعوة الإسلامية في الحقيقة هو انتشار لثلاث ظواهر: انتشار للعقيدة الإسلامية والشريعة، وانتشار للثقافة العربية الإسلامية، وانتشار للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم والدعوة، وهذا لا يعني بحالٍ أنّ كلّ ظاهرة من هذه الظواهر منفصلة عن الأخرى، بل هي ظواهر متداخلة تسير جنباً إلى جنب، وتتفاعل كلها في وقت واحد، وتخضع لمؤثرات واحدة كذلك(112).
وقد انتشرت اللغة العربية وازدهرت بعد توقيع (معاهدة البقط)، وفتح بلاد النوبة لهجرة القبائل العربية مع حركة الفتوح الإسلامية، ولم يحدث ذلك في يسر وسهولة، بل صارعت كثيراً من اللغات واللهجات التي كانت سائدة في تلك المناطق ونافستها، وخرجت من صراعها ذلك متغلبة عليها على مرّ الأجيال, وعبر الحقب التاريخية المختلفة.
وقد ساعدت عوامل كثيرة في ذلك الانتشار، أهمها الآتي:
العامل الديني: فحيثما انتشر الإسلام واستقرت قواعده انتشرت اللغة العربية، وقد ساعد على ذلك ما أجمع عليه أغلب أئمة المسلمين من عدم جواز ترجمة القرآن الكريم، وعدم جواز كتابته بغير اللغة العربية، وعدم جواز القراءة بغير اللغة العربية في الصلاة(113)، فهي لغة العبادة في الإسلام، لذا أقبلت عليها الشعوب المختلفة التي اعتنقت الإسلام، تحاول تعلّمها، ومعرفة ألفاظها ومعانيها، ومعاني القرآن الكريم، حتى تصحّ العبادة، وتُؤدى على الوجه الصحيح المطلوب.
وهناك عوامل لغوية أيضاً: ساهمت في انتشار العربية؛ لأن انتشار الدين وحده ليس كافياً في تعليل سرعة هذا الانتشار؛ إذ إنّ انتشار الإسلام كان أسبق من تعلّم اللغة العربية بعدة قرون, وهذا العامل هو وجه القرابة بين اللغة العربية وبين أخواتها الساميات في كثير من المظاهر الصوتية واللفظية والنحوية من جهة, وبين اللغات السامية والحامية من جهة أخرى, مثل ذلك التشابه بين اللغات السامية والقبطية في الضمائر, وأسماء العدد والتثنية وقواعد الصرف(114).
إضافة لذلك هناك العامل الحضاري: فالمعلوم أنه إذا التقت لغة ذات تراث حضاري متفوق مع أخرى حظها من التراث قليل فإنّ الأمر ينتهي بسيادة اللغة العريقة التراث والثقافة، وهذا ما حدث في كثير من المناطق التي انتشر فيها الإسلام في القارة الإفريقية.
وبالنسبة لبلاد النوبة؛ فإنّ (معاهدة البقط) قد ظلت تمثّل الركن الأساسي في مسار العلاقة بين البلدين، وفي فترة سريانها تسربت المؤثرات الإسلامية في هدوء، أدى في نهاية الأمر إلى تغيير مسارها الديني والسياسي والاجتماعي، ولم يحدث ذلك التأثير إلا عبر مراحل مختلفة، وفترات طويلة من المجاهدات والإسهامات التي قدّمها المهاجرون من الدعاة والتجار والأفراد والرعاة، وقد تبدّت تلك المؤثرات في كثير من مظاهر الحياة النوبية.
أما ظاهرة انتشار اللغة العربية؛ فقد كانت محدودة في أول الأمر, وبدأت الجماعات العربية الأولى التي استقرت في بلاد النوبة نشر الإسلام وسط النوبيين بعد أن تعلموا لغتهم، فسهلت مهمتهم بذلك(115).
وليس معنى هذا أنّ اللغة العربية لم تنتشر بين النوبيين في هذه الفترة المبكرة، ذلك أننا نجد كثيراً من الدلائل تشير إلى انتشارها في البلاد، منها وجود كتابات في مقابر نوبية باللغة القبطية، تحمل تاريخاً مزدوجاً من التقويمين القبطي والهجري، ثم تظهر بعد ذلك كتابات من هذا النوع لا تحمل سوى التاريخ الهجري(116), ثم في مراحل متقدمة تظهر شواهد قبور مكتوبة بالخط العربي تحمل أسماء عربية ترجع إلى القرن الثالث الهجري(117).
وفي هذه الفترة المبكرة ظلت اللغة العربية الفصحى لغة العبادة فقط إلى جانب اللهجة المحلية الدارجة لكلّ قبيلة(118), أما لغة الأدب والخطابة والمحادثة فكانت الدارجة وحدها، وقد ساعد على احتجازها في هذا الجانب قلّة عدد المتعلمين منهم، واشتداد العصبية القبلية، وصعوبة الاتصال بين الجماعات المتناثرة في أنحاء النوبة المختلفة(119), إضافة إلى أنّ اللغة النوبية كانت متمكنة في البلاد، إذ إنها تمثل إحدى اللغات الحامية التي هاجرت إلى النوبة في فترة ترجع إلى القرن الثالث قبل ميلاد المسيح(120), ومع تحوّل ملوك النوبة للنصرانية تُرجمت بعض النصوص الدينية إلى اللغة النوبية، لكنها لم تكن لغة الشعائر والطقوس, إذ ظلت اليونانية والقبطية هما لغتا الكنيسة النوبية(121), لكنها لم تتمكن من نفوس النوبيين برغم كونها لغات حية لها آدابها وعراقتها ووسعها، وذلك بسبب أنها بقيت لغة للشعائر الدينية محصورة في الكنيسة، فلم تغادرها أصلاً، فضلاً عن عدم فهم النوبة لها وتجاوبهم معها.
ولم يعرف النوبيون الذين اعتنقوا الإسلام في هذه الفترة المبكرة أداء الشعائر الإسلامية المفروضة على الوجه التام المطلوب، ففي الصلاة مثلاً لم يعرف قطاع كبير منهم من الصلاة إلا التهليل والتكبير(122), ومرد ذلك إلى قلّة الفقهاء والمتعلمين، أو المتخصصين في علوم اللغة ممن وفد إلى النوبة، إضافة إلى أنّ البلاد لم تشهد حركة علمية واسعة لها نشاطها، ولم تكن كذلك ثرية ثراء الحركات العلمية التي قامت في بقية البلدان الإسلامية، ولم يكن لعلمائها شهرة وصيت مثلما كان للعلماء في تلك البلاد(123).
إلا أنّ ذلك لم يحل دون تسرّب كثير من المفردات والألفاظ العربية إلى اللغة النوبية، حتى أضحت في فترات متقدمة تمثّل 30% من مجموع ألفاظ اللغة النوبية ومفرداتها(124), ومع مرور الزمن, وكثرة اختلاط العناصر العربية مع النوبيين، تحولت اللغة العربية من كونها لغة عبادة وشعائر إلى أن تصبح لغة ثانية بعد اللغة العامية النوبية، وأصبح النوبي يتحدث بها في معاملته التجارية مع التجار العرب، والتجار الآخرين القادمين من بلاد البجة وعلوة وغيرها؛ فأصبحت العربية بذلك لغة تخاطب بينهم، وقاسماً مشتركاً بين النوبيين أنفسهم، حيث يتكلم بها النوبي إضافة إلى لغته المحلية(125).
على أنّ اللغة العربية التي انتشرت في النوبة لم تكد تخلو من ظهور بعض الاختلافات الشكلية بين اللهجات العربية القبلية, ويظهر أنّ هذا التعدد يعود بأصولها إلى لهجات أقدم منها عاشت في شبه الجزيرة العربية(126)، بيد أنّ هذه الاختلافات الشكلية بين اللهجات العربية لا تعدو أن تكون تغيّراً طفيفاً في النطق, أو تغييراً لبعض الحروف والحركات بالإبدال أو الحذف.
وقد حصر بعض الباحثين هذه الاختلافات الشكلية في أربعة مسائل(127):
1 – تغيير نطق بعض الحروف.
2 – تغيير الحركات.
3 – حذف بعض الأصوات.
4 – تغيير مدلول الكلمة.
إلا أنّ هذه الفروق لا تمثّل اختلافاً جوهرياً يحول دون قيام ثقافة ذات مضمون وجوهر واحد, إضافة إلى كونها فوارق لا تمثل حاجزاً لغوياً يقف حائلاً دون وحدة الثقافة، والدليل على ذلك ما يشاهد اليوم في سودان وادي النيل، فبرغم ما بين اللهجات العامية من فوارق في النطق والحركات والأصوات, وأـحياناً تغيير مدلول الألفاظ والكلمات، إلا أنّ أهل السودان تنتظمهم ثقافة واحدة, هي الثقافة الإسلامية العربية(128).
هذا، وقد ظلت اللغة العربية تتقدم في المنطقة تبعاً لتقدم الإسلام الذي استمر انتشاره تبعاً لتوغل القبائل العربية في بلاد النوبة، حتى عمّ أجزاء كبيرة في شرقي ووسط وغربي بلاد السودان، حيث يلاحظ أنّ هذا الوجود قد وصل إلى بلاد الحبشة شرقاً، ودارفور في غرب السودان في أواخر القرن السادس الهجري(129)، وتمكنت اللغة العربية بذلك من محاصرة اللغة النوبية تماماً، وعزلها عن تلك المجتمعات(130).
إضافة إلى ذلك فقد أسهم الشيوخ – من الدعاة الذين وفدوا إلى النوبة، واستقروا في دنقلة، وقرروا البقاء هناك – مساهمة كبيرة في نشر تعاليم الإسلام واللغة العربية، بعد أن هالهم ما رأوا من جهل مستشر بتعاليم الدين والعقيدة الصحيحة، فأخذوا يعمرون المساجد، وينشؤون المدارس وحلقات تعليم القرآن الكريم وحفظه(131).
فكان لتلك الحركة العلمية على بساطتها، وضعفها أثر واضح في انتشار اللغة العربية، وذلك بإقبال الأهالي على هؤلاء الدعاة للتعلّم منهم، والتتلمذ على أيديهم.
على أنّ اللغة العربية لم تسلم من دخول بعض المفردات النوبية عليها، لكنها بقيت واضحة كألفاظ غريبة ودخيلة عليها، ولم تؤث ذر في جوهرها، وتتمثل في أسماء بعض الأدوات والصناعات التي لم يعرفها العرب في جزيرتهم، فظلت هذه الأسماء مستعملة في اللغة العربية في معظم سودان وادي النيل.
الهجرات العربية إلى بلاد النوبة والسودان الشرقي .. وآثارها الثقافية والحضارية
..ليس من اليسير على الباحث أن يحدّد تاريخاً مُعيّناً لبداية العلاقة بين الجزيرة العربية وبلاد السودان بوجه عام، وبلدان وادي النيل بشكل خاص، بيد أنّ هناك شبه إجماع بين المؤرخين والباحثين على أنّ هذه العلاقة مُوغلة في القِدَم، تعود إلى آماد بعيدة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه حتمية تؤيدها الحقائق الجغرافية والروايات التاريخية، ذلك أنّ البحر الأحمر لم يكن في وقت من الأوقات حاجزاً يمنع الاتصال بين شواطئه الآسيوية العربية وشواطئه الإفريقية، إذ لا يزيد اتساع البحر على مائة وعشرين ميلاً عند السودان، ويبدو بهذا أنه ليس من الصعب اجتيازه بالسفن الصغيرة (1)
البرتغال ودور الأمير هنري الملاح في كشف إفريقيا- حول البدايات الأولى للكشوف الجغرافية الأوروبية الحديثة
700 عام على رحلة حج منسا موسى 1324م: قراءة في هوامش تاريخ الصلات الإفريقية-العربية
الرحلات الإفريقية للحج
وفي الجنوب يضيق البحر الأحمر لدرجة كبيرة عند (بوغاز) باب المندب، حتى لا يزيد على عشرة أميال، وهو الطريق الذي سلكته السلالات والأجناس إلى القارة الإفريقية منذ آماد بعيدة (2).
وتذهب بعض الروايات التاريخية إلى أنّ المصريين القدماء الذين عبدوا الإله حورس كانوا عرباً هاجروا من الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر عن طريق مصوع(3)، وتابعوا سيرهم عن طريق وادي الحمامات شمالاً إلى مصر، وأنّ معبد الشمس الذي بُني قرب ممفيس إنما بنته جاليات عربية، وصلت إلى هناك في وقت غير معروف، ووُجدت آثار لجاليات عربية كبيرة تسكن المنطقة المحاذية للنيل من أسوان شمالاً إلى مروى جنوباً(4)، وقد دلت الأبحاث الأثرية والتاريخية على أنّ هجرات عربية قدمت من جنوب الجزيرة واليمن عبر البحر الأحمر، يعود بعضها إلى القرن الخامس قبل الميلا د، وثبّتت بعض هذه الجاليات العربية أقدامها في بعض جزر البحر الأحمر (مثل: دهلك) منذ عدة قرون قبل الإسلام(5)، ولم يقتصر وجود الجاليات العربية على الساحل الإفريقي، بل إنّ أفراد هذه الجاليات قد توغّلوا في الداخل، ووصل بعضهم إلى ضفاف النيل، وأقاموا شبكة من طرق القوافل التجارية بين ساحل البحر الأحمر والمناطق الداخلية، وقد وصلت العرب إلى أقطار وادي النيل عن الطريق الشمالي البري المارّ عبر سيناء إلى مصر، ثم انحدرت جنوباً إلى بلاد البجة والنوبة(6).
هذا، وقد كانت التجارة تمثّل أحد أهم وسيلة لهذه الاتصالات؛ إذ نشطت حركة تجارة العاج، والصمغ، واللبان، والذهب بين الجزيرة العربية من ناحية وبين موانئ مصر والسودان والحبشة من ناحية ثانية، مما يؤكد أهميتها في حركة الاتصال، والتواصل النشط بين سواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية(7) .
وقد بلغـت هذه الهجرات أقصاها فيما بين 1500 ق.م – 300 ق.م، في عهد دولتي: (معين، وسبأ) وحمل المعينيون والسبئيون لواء التجارة في البحر الأحمر، ووصلوا في توغلهم غرباً إلى وادي النيل، ونشطت حركة التجار العرب، خصوصاً زمن البطالمة والرومان، ولا شك أنّ عدداً غير قليل من هؤلاء استقروا في أجزاء مختلفة من حوض النيل، ولحق بهم عدد من أقاربهم وأهليهم(8)، وفي القرنين السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميريين مضيق باب المندب، فاستقر بعضهم في الحبشة، وتحرك بعضهم الآخر متتبعاً النيل الأزرق ونهر عطبرة ليصلوا عن هذه الطريق إلى بلاد النوبة، كما يرجّح أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل قد انداحوا في هجرتهم حتى المناطق الغربية لسودان وادي النيل(9).
وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أنّ هناك حملات عسكرية قام بها الحميريون في وادي النيل الأوسط وشمال إفريقيا، وتركت هذه الحملات وراءها جماعات استقرت في بلاد النوبة وأرض البجة، وشمال إفريقيا(10)، كما تشير بعض الروايات إلى حملة قادها (أبرهة ذي المنار بن ذي القرنين الحميري) على السودان وبلاد النوبة والمغرب في أوائل القرن الأول قبل الميلاد، ثم إلى حملة أخرى قادها ابنه (إفريقيش) إلى شمال إفريقيا، وقد داخلت تلك الجماعات المهاجرة الوطنيين من أصحاب تلك البلاد التي هاجروا إليها، وأصبح لهم وجود معتبر فيها، ولعل وجود العمامة ذات القرنين التي كانت شارة من شارات (السلطة الكوشية) دليل على ذلك الوجود الحميري المبكر(11)، إضافة إلى عدد من القرائن الأخرى الدالة على هذا الوجود.
كذلك وردت إشارات إلى وجود جماعات من الحضارمة عبروا البحر الأحمر إلى ساحله الإفريقي في القرن السادس الميلادي، ثم اختلطوا بالبجة، وكوّنوا طبقة حاكمة خضع لها البجة، وقد عرفوا عند العرب –الحداربة – الذين استقروا في إقليم العتباي في الشمال، ثم اضطروا إلى الانتقال جنوباً في القرن الخامس عشر الميلادي، حيث أسّسوا مملكة البلو (مملكة بني عامر) في إقليم (طوكر)(12) .
على أنه من المهم الإشارة إلى نزوح بعض الجماعات النوبية والسودانية عن مواطنها إلى الجزيرة العربية، حيث تأثرت بعادات سكانها قبل الإسلام وتقاليدهم، بل مشاركتها في الحياة الاجتماعية والثقافية هناك، فقد أشار ابن هشام إلى استعانة المكّيين بنجّار قبطي في أثناء إعادتهم بناء الكعبة قبل البعثة المحمدية(13).
كما أنّ بعض المصادر تشير إلى وجود قديم لجاليات حبشية ونوبية وسودانية في بعض مناطق الحجاز في تلك الفترة أيضاً(14)، وتذكر أنّ عدد الأحباش والنوبيين كان كبيراً في عددٍ من مُدنه، وأدى وجودهم إلى أن يتعلم بعض العرب لغتهم، إذ ثبت أنّ عدداً من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلّموا بعضاً من تلك اللغات، وأنّ زيد بن ثابت وحنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي الأسدي رضي الله عنهما كانا يترجمان للنبي صلى الله عليه وسلم بالقبطية والحبشية، وقد تعلّماها من أهلها بالمدينة(15).
وتمضي هذه المصادر؛ فتذكر أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مولى نوبي اسمه (يسار)، أصابه في غزوة بني عبد بن ثعلبة فأعتقه، وهو الذي قتله (العرنيون) الذين أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، قطعوا رجله ويده، وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات(16).
وعلى الرغم من ثبوت الوجود العربي المبكر، والاتصال ببلاد النوبة والسودان في فترة ما قبل الإسلام، إلا أنه لم يكن ذا تأثير واضح في سكان البلاد، ويرجع ذلك إلى أنّ العرب وقتها لم يحملوا عقيدة واحدة واضحة، ولم يكن لهم هدف محدد سوى العمل في التجارة، والبحث عن مناخات وفرص أفضل لكسب العيش في تلك المناطق، كما هو الحال عندما جاء العرب المسلمون الذين يحملون عقيدة واحدة، ويتكلمون لغة واحدة، ويمثلون دولة واحدة، وينشدون أهدافاً موحّدة، ويكادون يتفقون في السلوك العام المنضبط بتعاليم الإسلام.
على أنّ أهم نقطة تحوّل في تاريخ العلاقة بين العرب المسلمين وبين منطقـة وادي النيل وبلاد النوبة والسودان حدثت بعد الفتح الإسلامي لمصر سنة 21ه، في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقيادة الصحابي عمرو بن العاص(17) رضي الله عنه، وكانت هي توقيع المسلمين (معاهدة البقط)(18) مع ملوك النوبة والسودان من النصارى الذين كانوا يقيمون في شمالي السودان وحاضرتهم مدينة (دنقلة)، ذلك أنّ هذه المعاهدة تضمّنت بنوداً مهمة، سهّلت وسمحت في مجملها للقبائل العربية بالهجرة، والتدفق نحو بلاد النوبة والسودان بشكل كبير لم يحدث له مثيل(19)، مما مكّنها مستقبلاً من الإحاطة بالكيانات النوبية المسيطرة، وتحوّل النوبيين وأهل السودان من النصرانية إلى الإسلام.
منافذ الهجرات العربية:
اتخذت تلك الهجرات عدداً من المنافذ، ظلت ترد عن طريقها القبائل العربية باتجاه بلاد النوبة والسودان، منها ثلاثة منافذ رئيسة، هي: المنفذ الشرقي عن طريق البحر الأحمر من الجزيرة العربية، والمنفذ الشمالي عن طريق نهر النيل من مصر، والمنفذ الشمالي الغربي، أو الطريق الليبي، عبر الصحراء الكبرى.
أولاً: المنفذ الشرقي من الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر:
يعدّ هذا المنفذ من أقدم الطرق التي سلكتها الهجرات العربية إلى بلاد النوبة وأقصرها، خصوصاً إلى القارة الإفريقية عامّة، وقد عرفه العرب قبل الإسلام، وامتدوا على ساحله الشرقي، ومنه أنشؤوا طرق قوافل تسير عليها الإبل إلى المناطق الداخلية في القارة الإفريقية، كما سلكته كثير من القبائل العربية في هجرتها وتجارتها مع القبائل التي تسكن في ساحله الغربي، مثلما فعل (الحضارمة) وقبائل (بلي) التي ساكنت (البجة) في الشرق، واختلطوا بهم.
وحين جاءت الفتوحات الإسلامية توسعت حركة الهجرة من الجزيرة العربية إلى بلاد العالم كافّة، وإلى بلدان إفريقيا على وجه الخصوص، وانفتحت منافذ أخرى للهجرة للسودان غير هذا المنفذ(20)، إلا أنّ ذلك لم يقلل من قيمته كمنفذ من المنافذ التي ساهمت بقسط كبير في الهجرة إلى بلاد إفريقيا بعامّة وإلى بلاد النوبة بوجه خاص.
ثانياً: المنفذ الشمالي عبر النيل، وبمحاذاته من مصر:
عرفت المنطقة هذا المنفذ منذ قديم الزمان؛ إذ إنه كان يمثّل الطريق التجاري الذي يربط مصر بوسط إفريقيا وبلاد النوبة والبجة، وازدادت أهميته بعد توقيع المعاهدة، حيث كفلت بعض بنودها للتجار والمهاجرين والقوافل حقّ التحرك الحُرّ فيه، وأعطتهم أماناً للتوغل في أعماق البلاد، وأصبح مدخلاً للقبائل العربية إلى بلاد النوبة(21).
ويرى أحد الباحثين أنّ هذا المنفذ كان سبباً مباشراً في تعريب بلاد النوبة(22)، وأنه أعظم خطراً وأهم دوراً من المنفذ الشرقي في أمر هجرة القبائل إلى بلاد النوبة، سواء كان ذلك قبل الإسلام أو في زمن التوسع الإسلامي(23)، وإنّ كثرة الحديث عن الهجرة العربية عبر البحر الأحمر كانت بسبب أنّ بعض القبائل العربية في السودان تدّعي أنّ أسلافها وصلوا من جزيرة العرب مباشرة إلى السودان عبر البحر الأحمر لتأييد دعواهم في الانتساب إلى أصل شريف أموي أو عباسي، أو أنهم سلالة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم(24).
إلا أنّ على الباحث ألا يغفل عن أهمية المنفذ الشرقي في دفع حركة الهجرة إلى بلاد النوبة وتوسعها(25)، خصوصاً في العهد المملوكي الذي نشطت فيه حركة الملاحة البحرية بين المواني الغربية للبحر الأحمر وبين موانيه الشرقية، بسبب الاعتداءات الصليبية المتكررة على طريق (برزخ السويس)، وهو الأمر الذي أدى لإنعاش مينائي: (عيذاب، وسواكن) اللذين وضع المماليك أيديهم عليهما تماماً، بعد تكرار الاعتداء على ممتلكات التجار المصريين المتوفين هناك(26)، هذا، ولم يقتصر تأثير المنفذ الشرقي على الجهات التي تقابل الجزيرة العربية فقط، بل تجاوزتها إلى السودان الأوسط وبلاد السودان الغربي أيضاً(27).
ومهما يكن من أمر؛ فإنّ هذين المنفذين الشرقي والشمالي يعدّان أهم المنافذ التي سلكتها القبائل العربية المهاجرة إلى بلاد النوبة في تلك الفترة.
ثالثاً: المنفذ الشمالي الغربي، أو الطريق الليبي:
سلكته القبائل العربية في هجرتها نحو بلاد النوبة والسودان، بعد أنّ تمكن الإسلام في معظم المناطق الشمالية من القارة الإفريقية، ويسير باتجاه السهول والبراري الواقعة بين النوبة وكردفان ودارفور، وقد ازدادت شهرته بعد أن قامت في مصر وشمال إفريقية دول إسلامية مستقلة عن الخلافة العباسية(28)، ولم يكن له دور فاعل ومؤثر في حركة الهجرة نحو بلاد النوبة لجفافه وصعوبته، بسبب الصحراء، وقلّة الماء؛ على أنه كان هناك عدد من الطرق والمنافذ سلكتها القبائل العربية من هذا الاتجاه، ومنها الطريق الذي يبدأ من شنقيط وينتهي إلى تمبكتو، فجاو، وزندر، وكوكوا، وبيدا، ومسنيا، وأبشي، والفاشر، ثم يخترق سهول الجزيرة، حتى ينتهي إلى سواكن، وقد اشتهر هذا الطريق لكونه قد رفد بلاد السودان والنوبة بأعداد كبيرة من العلماء والدعاة الذين ساهموا مساهمات كبيرة في نشر الدعوة الإسلامية، وتوطينها في تلك المناطق.
دوافع الهجرات العربية:
ولا شك أنّ هذه الهجرات إلى بلاد النوبة لم تتم في فترة واحدة محددة، ولم تحركها ظروف واحدة، كذلك، بل تمّت على فترات متقطعة، تنشط حيناً، وتخمد حيناً آخر، وتتحكم فيها عدد من الدوافع أو العوامل الدينية والسياسية والتجارية والاقتصادية، يمكن تناولها على النحو الآتي:
أولاً: الدوافع الدينية:
كان معظم جنود الحملات العسكرية التي سيّرها ولاة المسلمين في مصر نحو بلاد النوبة من رجال القبائل العربية، وممن شاركوا في الفتح الإسلامي لمصر، أو من المدد الذي ظلّ يصل تباعاً إلى مصر من الجزيرة العربية لتقوية السلطة، وحماية الدولة، والتوسع في الفتوح(29).
ومن الواضح أنّ الولاة في مصر لم يكونوا يترددون في تسيير الحملات العسكرية تجاه النوبة كلما أغاروا على الحدود والمدن الجنوبية للدولة، أو كلما تمردوا عن دفع ما عليهم من: (بقط والتزام)، فكان من الأهداف الرئيسة التي حرّكت أولئك المقاتلين هو الجهـاد في سبيل الله تعإلى لرد كيد الأعداء، والدفاع عن الدولة المسلمة، وحمل لواء الدعوة الإسلامية، وتبليغها للعباد، تدفعهم لذلك نصوص صريحة من القرآن الكريم، وترغّبهم في ذلك، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (التوبة: 20)، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنكبوت : 69)، وقوله تعالى: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ… ﴾ (النساء : 95).
ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَن مات ولم يغز ولم يحدّث نفســه بالغـزو مات على شـعبة مــن نفــاق»(30)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المجاهد في سبيل الله مضمون على الله؛ إمّا إلى مغفرته ورحمته، وإمّا أن يرجعه بأجر وغنيمة، ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع»(31).
فهذه النصوص الواضحة الصريحة من الكتاب والسنّة كانت هي الدافع الحقيقي لمشاركة هؤلاء الرجال في هذه الحملات الجهادية، إضافة إلى حماسهم لأجل تبليغ الدعوة الإسلامية، إلا أنّ كثيراً من المؤرخين المحدثين، الذين كتبوا عن تاريخ الهجرات العربية إلى بلاد النوبة، قد أغفلوا هذا الدافع ضمن ما ذكروا من دوافع للهجرة، على الرغم من أنه هو الدافع الرئيس لها.
ثانياً: الدوافع السياسية:
وهذه تختلف وتتباين بحسب الأوضاع في البلدين (مصر والنوبة)، فمنها دوافع خاصة بتأمين النظام السياسي في مصر وتقوية شوكته، حيث عمد عدد من الولاة في مصر إلى جلب قبائل عربية بأسرها إلى مصر لتكون قوة لهم، وسنداً يحميهم ويغطي ظهرهم عند الخطر.
وقـد أشار عدد من المؤرخين إلى أنّ عبيد الله بن الحبحاب، حين تولّى مصر من قِبَل هشام بن عبد الملك سنة 109هـ، أرسل يستأذنه في قدوم قبيلة قيس فأذن له، فقدم عليه نحو مائة من أهل بيت هوازن، ومائة من أهل بيت بني عامر، ومائة من أهل بيت بني سليم، فتوالدوا، وعندما تولّى مصر الحوارثة بن سهيل الباهلي، في خلافة مروان بن محمد، أقبلت إليه قيس وهي يومئذ ثلاثة آلاف بيت(32)، وقد شاركت أعداد كبيرة من هذه القبائل في الحملات التي أُرسلت لبلاد النوبة، فاستقرت أعداد كبيرة منهم هناك.
ومن الدوافع السياسية كذلك أنّ النوبة ظلت ملجأً لكثير من الهاربين من مصر، أو من الجزيرة العربية، بسبب الثورات، وتغيّر نظام الحكم، ويقدم هؤلاء القادة الهاربون عادة في أعداد ضخمة وكبيرة من أتباعهم وأهلهم وعبيدهم، وحوادث التاريخ تبين أنه حين اجتاحت قوات العباسيين الولايات الإسلامية هرب آخر الخلفاء الأمويين إلى مصر، حيث قُتل هناك، ثم هرب أبناء عبيد الله جنوباً إلى النوبة مصحوبين بعدد من الأقارب، والأتباع البالغ عددهم نحو 400 شخص، واستجار الأمويون بملك النوبة آملين أن يبقيهم في بلاده، لكن الملك النوبي رفض ذلك، وطلب منهم الرحيل، فتوجّهوا شرقاً مارّين بأرض البجة إلى ميناء باضع، وتعرضوا للجوع والعطش والتعب؛ فهلك عدد منهم، من بينهم عبيد الله بن مروان، ومضى أخوه إلى ميناء باضع على ساحل البحر الأحمر، حيث عبر إلى جدة، ومنها سار إلى مكة المكرمة فقُبض عليه، وأُرسل إلى بغداد، حيث بقي سجيناً حتى أيام الخليفة هارون الرشيد الذي أمر بإخراجه بعد أن أصبح كهلاً ضريراً(33).
هذا، ولا يُستبعد أن يكون رجال البجة باتفاق مع النوبيين قد غدروا بهؤلاء الأمويين تقرّباً للعباسيين، حيث كشفت الحفريات الأثرية الحديثة عن قبور هؤلاء الأمويين الفارّين على طول الطريق الذي سلكوه من النوبة إلى ميناء باضع البجاوي(34).
ويبدو أنّ بعض من نجا من هؤلاء الأمويين قد استقر على الساحل السوداني للبحر الأحمر قرب باضع، حيث اختلطوا بالسكان المحليين، وتزوجوا منهم، وأصبح لهم شأن كبير تبعاً لأصلهم القرشي، وقد كان لبقاء هؤلاء الأمويين في تلك المنطقة أثر في ادّعاء بعض الأسر السودانية بأنها تنحدر من أصل أموي، ومن الأمثلة على ذلك (أسرة الفونج)(35) المشهورة، إضافة لدور من استقر من تلك القبائل في نشر دعوة الإسلام بين سكان البلاد، وظلت بلاد النوبة تمثّل دائماً ملجأً للسياسيين والأمراء الفارّين من مصر، يلجؤون إليها لترتيب أمورهم وصفوفهم من جديد، ريثما يبدؤون محاولة الثورة والمقاومة مرة أخرى، مثل: هروب عبد الله وعبيد الله – ابني مروان بن الحكم – إلى بلاد النوبة، ومثلما فعل الثائر الأموي أبو ركوة في عهد الفاطميين(36).
ومن الدوافع السياسية، التي ساهمت في دعم الهجرة العربية إلى النوبة وتوسيعها، تلك الحملات الحربية التي سيّرها ولاة المسلمين من مصر – بعد إعدادها ودعمها -؛ إمّا بسبب انقطاع النوبة عن دفع (البقط) المقرر عليهم، وإمّا بسبب هجومهم على منطقة الحدود جنوبي مصر، وقد كانت هذه الحملات تصل إلى أعماق بلاد النوبة، ثم تستقر أعداد من المشاركين فيها في البلاد، فيساهمون في نشر الدعوة، والثقافة الإسلامية في المنطقة، ونقل الدماء العربية للنوبيين بالتزوج من ومصاهرتهم.
ومن الدوافع السياسية أيضاً تحوّل سياسة العباسيين تجاه العرب؛ إذ المعروف أنه مع الفتح الإسلامي لمصر ظلت القبائل العربية تفد إليها بأعداد كبيرة جداً، سواء دعاهم الولاة كما سبق، أو بتحرك تلقائي من قبلهم نحو مصر، فأصبحت أعدادهم كبيرة جداً، وصار لهم نفوذ مهم في الدولة، وتسيير أمورها، واستقرت جماعات منهم في الريف، ومارست الزراعة(37)، إلا أنه بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية بدأ العباسيون في استرضاء الموالي، والاعتماد على الجنود الأتراك، وعلى وجه الخصوص في عهد الخليفة المعتصم (218ه – 227هـ) فأثبتهم في الديوان، وأمر واليه في مصر (كيدر بن نصر الصفدي) بإسقاط مَن في ديوان مصر من العرب، وقطع العطاء عنهم(38).
وأدى هذا القرار الخطير إلى ثورة عربية ضد الوالي، انتهت بأسر زعمائها من القبائل العربية(39)، وبهذا «انقرضت دولة العرب في مصر، وصار جندها العجم المَوالي، من عهد المعتصم إلى أن ولي الأمير أبو العباس أحمد بن طولون، فاستكثر من العبيد»(40)؛ ففقد العرب بهذا نفوذهم القديم، وأبدوا استياءهم الشديد لهذا التحوّل في سياسة الدولة، وكثرت ثوراتهم في أول قرن للدولة العباسية، وقامت ثورات يقودها أمراء أمويون في صعيد مصر، أيدتها كثير من القبائل العربية، ولم تفلح الحكومة المركزية في إخمادها إلا بعد جهود كبيرة(41)، وأعلنت كذلك قبائل قيس العصيان، ورفضت دفع الخراج المقرّر عليها(42).
فكان طبعياً أن يتبع هذه الاضطرابات نزاعات كثيرة، بين هؤلاء الذين امتنعوا عن دفع الخراج المقرر عليهم – مع التمتع بملكية الأراضي التي يفلحونها وخيراتها – وبين ولاة الأمر في مصر، وأدى ذلك في النهاية إلى توسيع الشقّة بين العرب والولاة من حكام مصر، فكان لهذا التوتر في العلاقة، ولهذا الضغط السياسي والاقتصادي، أسوأ الأثر في نفوس العرب، الذين فقدوا مصدر رزق مهمٍّ بالنسبة لهم، ولم يبقَ أمامهم إلا أحد أمرين: إمّا أن يذعنوا للأمر ويسلّموا بهذا الواقع، وإمّا أن ينزحوا نحو صعيد مصر بعيداً عن سلطة الوالي؛ فآثروا الأمر الثاني، وأخذوا منذ أوائل القرن الثالث الهجري ينزحون للصعيد المصري، ومنه لبلاد النوبة في مجموعات صغيرة، دون أن تسترعي انتباه أحد، أو يسجل التاريخ تفاصيلها، والأغرب من ذلك أنهم قد اجتازوا الحدود بين مصر والنوبة في هدوء شديد، لم يلفت إليهم صاحب الجبل والي الإقليم الشمالي من قبل النوبة الموكل بحفظ الحدود الشمالية لبلاده، والذي يحول دون دخول أي شخص للبلاد دون تصريح رسمي يسمح له بذلك(43).
ثالثاً: الدوافع التجارية والاقتصادية:
ظلت العلاقات التجارية بين مصر والنوبة مزدهرة منذ قديم الزمان، وذلك لحاجة البلدين؛ إذ كانت مصر تحتاج إلى كثير من المنتجات التي لا تتوفر فيها، مثل: الأخشاب، والعاج، والأبنوس، وبعض التوابل.. وغيرها، فخرجت قوافل تجارتها منذ قديم الزمان إلى الجنوب منها، حتى وصلت إلى أجزاء نائية من القارة الإفريقية(44).
وارتبطت مصر مع بلاد النوبة بصلات تجارية قوية؛ فكانت مدينة أسوان مجمعاً للتجار من أهل السودان ومن النوبة، وكان التجار النوبيون يقدمون إلى أسوان عن طريق النيل حتى الجنادل، ثم يتحولون إلى ظهور الإبل حتى يصلوا إلى أسوان(45)، وقد سكنها كثير من العرب لمناخها الذي يقارب مناخ الجزيرة العربية ولمركزها التجاري(46)، إضافة إلى أنّ النوبة كانت تصدّر عن طريق أسواقها أهم منتجاتها من: (الذهب والزمرد) الذي ينتج في وادي العلاقي(47)، إضافة إلى الرقيق، والعاج، والأخشاب الصلبة، والأبنوس، وسنّ الفيل لصناعة العاج، الذي يُستخدم في الزينة، وريش النعام، والحديد الذي يُستخرج ويصهر بالقرب من نباتا ومروى(48)، وكانت ترد إلى النوبة المنسوجات، والقمح، والنحاس من مصر(49).
وحين وقّع عبد الله بن سعد (عهد الصلح) مع ولاة النوبة نصّ صراحة على حقّ الترحال لرعايا البلدين في البلد الآخر دون الإقامة الدائمة؛ فساق هذا الحقّ التجار المسلمون إلى أعماق النوبة مع بضاعتهم، وتجارتهم، وعقيدتهم الإسلامية، واستطاعوا بما اكتسبوا من معرفةٍ بأحوال البلاد تمهيد الطريق لهجرة القبائل العربية في أعداد كبيرة، بل نجد أنّ أعداداً منهم قد استقرت في فترة مبكرة في (سوبا) عاصمة (مملكة علوة) النصرانية جنوب المقرة، حتى أصبح لهم حيٌّ كامل يُعرف بهم(50).
ومن الدوافع الاقتصادية كذلك التي ساهمت في دفع القبائل العربية للهجرة نحو جنوب مصر، في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، سماع القبائل بمعدني: (الذهب، والزمرد) عبر الصحراء الشرقية لبلاد النوبة، واشتهار أمرهما، خصوصاً في وادي العلاقي من أرض البجة، فأدى ذلك إلى اجتذاب كثير من القبائل العربية المختلفة إلى هذه الأوطان للعمل فيها، واستغلال مناجمها(51)، وأدى استقرارهم هناك إلى اختلاطهم بقبائل البجة عن طريق المصاهرة، فنقلوا إليهم العقيدة الإسلامية، وتغيّرت كثير من عاداتهم وتقاليدهم بهذا النسب الجديد(52).
إضافة لذلك؛ فإنّ المعلوم عن مراعي النوبة وأراضيها أنها أكثر خصوبة من أراضي شبه الجزيرة العربية ومراعيها، وعلى وجه الخصوص النوبة الجنوبية(علوة) التي كانت أكثر اتساعاً وأخصب أرضاً وأوفر ثروة من المقرة(53)، إضافة إلى أنّ مناخ النوبة الشمالية (المقرة) يشابه مناخ شبه الجزيرة العربية وبيئتها(54)، وهو ما يوائم حياتهم التي جُبلوا عليها في حبّ الترحال والتنقل، وقد كان لهذا التشابه في المناخ وطبيعة البلاد والأرض المسطحة أثره في دفع هذه القبائل للتقدّم نحو الجنوب، وهي قبائل بدوية رعوية، أو شبه رعوية، لا تستطيع التقدّم إلا في السهول المكشوفة؛ فكان تدفقهم في كلّ أرض وصلوها يقف عند اصطدامهم بعقبات طبيعية: كالبحار، والجبال، والغابات، وهذا ما حدث بالضبط؛ إذ إنّ تلك القبائل لم تتوقف في زحفها إلا عند المناطق التي تسوء فيها الطرق، وتتفشى فيها الأمراض الفتاكة، بيد أنّ هذه الجماعات العربية المهاجرة اختلطت بالعناصر النوبية والبجاوية في تلك المناطق، وأدى هذا الاختلاط إلى تأثر هؤلاء بالدماء العربية التي كانت تتجدد باستمرار مع توالي وصول عناصر عربية جديدة إلى هذه الجهات(55)، إضافة إلى اعتناق عدد منهم للإسلام في هذه الفترة بالرغم من جهلهم باللغة العربية(56)، والراجح أنّ العرب تعلّموا لغة النوبيين بعد أن اختلطوا بهم، واستطاعوا بذلك نشر ثقافتهم الإسلامية في بلاد النوبة(57).
أشهر القبائل العربية المهاجرة:
هذا، وقد تعاظمت أعداد القبائل العربية المهاجرة، وانتشرت أحياء العرب من جهينة في بلادهم – أي النوبة -، واستوطنوها وملكوها(58).
وذلك في المراحل الأخيرة للمملكة النوبية النصرانية، والتي أصابها الضعف والوهن بسبب خلافاتها الداخلية، وبسبب الضغط القوي للقبائل العربية التي سارت في زحفها حتى بلغت أرض البطانة(59) والجزيرة(60)، ثم عبر بعضها نهر النيل إلى كردفان ودارفور، وهناك التقت هذه الموجة المهاجرة بموجة أخرى، كانت قد تابعت شاطئ النيل الغربي حتى دنقلة، فوادي المقدم(61)، ووادي الملك، حتى بلغت في مسارها مملكة (كانم برنو)، حيث كان الإسلام قد بلغ تلك الجهات من بلاد المغرب وشمال إفريقيا(62).
واستقر بعض هؤلاء المهاجرين في سهول أواسط البلاد، وانفتحوا على السكان الوطنيين من النوبة وغيرهم من البجة والزنج، فصاهروهم، وعندما بلغوا كردفان ودارفور اضطر جزء منهم أن يتخلوا عن إبلهم، ويعتمدوا على الأبقار في ترحالهم، ومِنْ ثَمّ عرفوا باسم (عرب البقارة)(63).
وبرغم الخلاف الواسع بين الباحثين في أعداد القبائل العربية التي هاجرت إلى بلاد النوبة، وفي أنسابهم، فإنه يمكن القول بما اتفق عليه معظم الباحثين: إنّ الجماعات العربية التي هاجرت إلى بلاد النوبة قد اشتملت على المجموعتين العربيتين، وهما مجموعتا: (العدنانيين)، و (القحطانيين)(64)؛ حيث يمثّل العدنانيون: (الكواهلة)، والمجموعة (الجعلية)، وبعض القبائل الأخرى، في حين يمثّل القحطانيون: المجموعة (الجهنية)(65).
أشهر القبائل العدنانية: يُقال: إنّ (الكواهلة) ينتسبون إلى كاهل بن أسد بن خزيمة، وإنهم قدموا إلى بلاد النوبة من جزيرة العرب مباشرة عبر البحر الأحمر، واستقروا في الإقليم الساحلي بين سواكن وعيذاب(66)، ويُنسب إليهم كذلك (البشاريون) و (الأمرار) و (بنو عام)(67)، ومن المؤكد أنّ أولاد كاهل قد عاشوا زمناً في الأقاليم الساحلية الشرقية، والمناطق التي تليها، ثم انتشروا انتشاراً تدريجياً نحو الغرب(68).
أمّا المجموعة (الجعلية)؛ فيقال: إنهم ينتسبون إلى إبراهيم الملقب بـ (جعل)، من نسل العباس عمّ النبي صلى الله عليه وسلم، وترجع أسباب هذه التسمية إلى أنّ إبراهيم هذا كان جواداً مضيافاً، وأنه كان يقول للوطنيين وغيرهم من العرب: «إنا جعلناكم منّا، أي أصبحتم منا»(69)، وتدل هذه العبارة، وكثرة ترديدها، على أن التوغّل العربي الإسلامي في المنطقة كان توغّلاً سلميّاً مبنيّاً على التودد والصلات الحسنة مع السكان الوطنيين من النوبيين وغيرهم، إلا أنّ هناك مصدراً آخر يشير إلى أنّ سبب هذه التسمية، أو هذا اللقب، سمة إبراهيم الشديدة ومنظره(70)، والواقع أنه لم يرد لفظ «جعل» ومشتقاته في أسماء قبائل العرب القديمة إلا في قبيلتين: إحداهما جعال بن ربيعة، أقطعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرض إرم من ديار جذام، والأخرى: بنو حرام بن جعل بطن من بلى من قضاعة، وهم بنو حرام بن عمرو بن حبشم(71)، فاللفظ إذن معروف في الجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة العرب، أي في الموطن الأول الذي أمدّ مصر بموجاته العربية المتلاحقة.
وتؤكد رواية أخرى أنّ من بين الصحابة الذين نزلوا مصر حزام بن عوف البلوي، وكان من بني جعل من بلى، وهو ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في رهط من قومه بني جعل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صخر ولا جعل، أنتم بنو عبد الله»(72)، على أنه من الصعب القول بإيجاد صلة بين الجعليين الذين هاجروا إلى بلاد النوبة وبين القبيلة المذكورة هنا.
والراجح أنّ الجعليين لم يكونوا قبيلة واحدة، بل هم مجموعة من القبائل ذات نسب متقارب، هاجرت على دفعات، وعلى مدى عدة قرون، وأهم هذه القبائل: الميرفاب، والرباطاب، والمناصير، والشايقية، والجوايرة، والركابية، والجموعية، والجمع، والجوامعة، والبديرية، والغديان، والبطاحين(73)، ومن القبائل العدنانية كذلك: قيس عيلان، وكنانة، وبنو حنيفة، وربيعة، وبنو فزارة، وبنو سليم، وبنو يونس(74).
أما أشهر القبائل القحطانية التي هاجرت إلى بلاد النوبة: فهي قبائل بلي، وجهينة، وقد ذكر المؤرخون أنّ الصعيد الأعلى في هذه المرحلة – خلافة المعتصم – سكنته جموع كبيرة من عرب سبأ، ونزل منهم أرض المعدن خلق كثير، كانت بلي وجهينة من جملتهم(75).
وينتسب هؤلاء الجهنيون إلى عبد الله الجهني الصحابي رضي الله عنه، وهو وإن لم يكن من جهينة مباشرة فإنه من قضاعة التي تنتسب إليها جهينة(76)، وتضم قبائلها: قبائل رفاعة، واللحويين، والعوامرة، والشكرية، وقد سكن هؤلاء في النصف الشرقي من سودان وادي النيل، وعلى شاطئ النيل الأزرق والبطانة، وفي كردفان، مثل قبائل دار حامد، وبني جرار، والزيادية، والبزعة، والشنابلة، والمعاليا، وفي غرب كردفان ودارفور تشمل قبائل الدويحية، والمسلمية، والحمر، والكبابيش، والمحاميد، والماهرية، والمغاربة، والبقارة(77).
ومن القبائل القحطانية كذلك: قبيلة بهراء، وهي بطن من قضاعة التي انتشرت بين صعيد مصر وبلاد الحبشة، وكان لهم فضل كبير في تقويض دعائم المملكة النوبية(78).
ومـا يخرج به الباحث من خلال تتبّع هجرة القبائل العربية في بلاد النوبة، هي سرعة اختلاطهم بالسكان النوبيين وغيرهم من الوطنيين في فترة وجيزة، كذلك لا تكاد تجد أسماء من القبائل العربية في مصر إلا وتجد له نظيراً في بلاد النوبة؛ مما يؤكد أهمية المنفذ الشمالي القادم من مصر عن طريق النيل في أمر الهجرة وتوسّعها، إضافة إلى ذلك فإنّ هذه الهجرات لم تتم في وقت معلوم محدّد بفترة زمنية معينة، يمكن إحصاؤها وتقديرها.
أهم الآثار الثقافية للهجرات العربية:
ظلّ سجل الثقافة النوبية حتى دخول العرب – المسلمين – بأعداد كبيرة يتأرجح في تفاعل بين ثقافتي الزنوج والحاميين من جهة، وما طرأ عليها من مؤثرات خارجية على رأس الأثر المصري من جهة أخرى.
فقد كان للحضارات المصرية التي قامت على حوض النيل الشمالي أثر كبير في الشعوب التي سكنت من حولها بوجه عامّ، وبلاد النوبة على وجه الخصوص، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في مقدمة هذه الدراسة، حيث أدت تلك العلاقة إلى تسرّب الأفكار، والمعتقدات، والطقوس، والعادات، والتقاليد، كنتاج طبيعي أو حتمي للصلات الفكرية والتجارية التي كانت قائمة بين البلدين، فكان قدماء المصريين يعتبرون ديار جيرانهم إلى الجنوب مصدراً مهمّاً للمنتجات الإفريقية، ومدخلاً رئيساً لها، فتوغلت القوافل التجارية منذ الدولة المصرية القديمة محمّلة بأدوات الزينة والحلي والأسلحة، وكانت تعود بالذهب والزمرد والرقيق والأبنوس والعاج.
وبازدهار هذه العلائق التجارية؛ توغّل التجار جنوباً، وأثروا تأثيراً حضارياً كبيراً، مما جعل بعض المؤرخين يذهبون إلى أنّ هذه الأجزاء من النوبة خضعت لفترات طويلة للاحتلال المصري المباشر، وقد تجلّى ذلك في كثير من مظاهر الحياة النوبية في جانبها الثقافي والحضاري، مما لا تزال مشاهده وآثاره باقية في أشكال الأواني الفخارية, ومدافن الموتى, وطريقة الدفن، وبناء قصور الملوك, إضافة إلى انتشار المعابد المصرية والرسومات الهيروغليفية, وتفشي عبادة الآلهة المصرية جنباً إلى جنب مع بعض الآلهة الوطنية المحلية, كما بقيت الأهرامات, وطريقة دفن النوبيين لموتاهم في البركل، ومروى، وكبوشية(79), خير شاهد على ذلك الأثر الثقافي المصري القديم(80).
وما أن ازدهرت الديانة النصرانية في العهد النصراني في بلاد النوبة, حتى صبغت البلاد بكثير من مظاهر ثقافتها، وتمثّل ذلك في تحويل المعابد القديمة إلى كنائس, وتمّ تشييد الكاتدرائيات التي مُلئت بالزخارف والنقوش, وبعض المشاهد من الإنجيل وصور القديسين(81).
ويظهر الأثر البيزنطي في التحف الفنية التي عُثر عليها في (كنيسة فرس)، إضافة لقطع الفخار وصور الحيوانات التي ظلت تمثّل تقليداً وطنياً كان منتشراً في (مملكة علوة)(82).
كذلك يُلاحظ الأثر النصراني القبطي في استخدام اللغة القبطية في أداء الطقوس الدينية الكنسية، وقد تُرجمت فيما بعد إلى اللغة النوبية(83), وكان كل ذلك بسبب هيمنة الكنيسة المصرية على الكنيسة النوبية, بل أضحت الكنيسة المصرية هي التي تقوم بتعيين الأساقفة وإرسالهم للكنيسة النوبية(84), ومع ذلك بقيت بعض العادات والتقاليد النوبية الوثنية سائدة في المجتمع النوبي(85)، وهذا ما يؤكد ما وصلت الإشارة إليه سابقاً من أنّ العقيدة النصرانية لم تتفاعل مع مشاعر الجماهير، بل إنها فُرضت على الناس فرضاً, إلا أنّ ذلك لا يمنع من القول: إنّ النصرانية قد ساهمت في تعديل كثير من العادات والتقاليد الوثنية النوبية وتهذيبها، وبسطت بعض مفرداتها اللغوية والثقافية في البلاد, وعاشت جنباً إلى جنب في المجتمع النوبي مع الموروثات الثقافية الوثنية, حتى تمكّن الإسلام في البلاد.
ولعلّه من المهم جداً أن يدرك دارسو حركة مسار الدعوة الإسلامية أنّ انتشار الإسلام: يعني حقيقة: انتشاراً لظواهر ثلاث متلازمة، هي:
1 – انتشار الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية.
2 – انتشار الثقافة العربية الإسلامية.
3 – انتشار اللغة العربية، باعتبارها لغة القرآن الكريم، والخطاب الإسلامي.
«ولا يفهم من ذكر هذه الظواهر على هذه الصورة أنّ كلّ ظاهرة منها كانت منفصلة عن الأخرى تماماً, إنما كانت مختلطة متشابكة، تسير جنباً إلى جنب، وتتفاعل كلها في وقت واحد، وتخضع لمؤثرات تكاد أن تكون واحدة»(86).
وقد خضعت الثقافة الإسلامية, وانتشارها، للظروف نفسها التي خضعت لها الحضارة الإسلامية, ومرّت بالتطورات نفسها التي مرّت بها الحضارة الإسلامية.
فقد جابهت الثقافة الإسلامية في إفريقيا المشكلة نفسها العامّة التي جابهتها الثقافة الإسلامية في العصور الوسطى, وهي مشكلة أو ظاهرة الالتقاء الثقافي, بل هي المشكلة نفسها التي تواجهها الحضارات الإنسانية عموماً حين تلتقي وتختلط وتتبادل التأثيرات، فمثلاً في مصر التقت الثقافة الإسلامية الوافدة بثقافات إغريقية مصطبغة بصيغة الحضارة المصرية القديمة(87), هذا الالتقاء أظهر طرازاً من الحضارة الإسلامية متأثراً في طابعه العام ببعض هذه الثقافات، أي أنّ ذلك يعني «أنّ الإسلام أخذ وأعطى، ومن هذا الأخذ والعطاء ظهرت الحضارة الإسلامية في مصر»(88).
وقد ورد في أمر النوبة آنفاً أنها وقّعت مع المسلمين (عهد البقط) بشرائطه تلك, وذلك العهد يمثّل نوعاً من الاتصال الدائم بين المسلمين والنوبة مدة ستة قرون ونيف, تسربت خلالها المؤثرات الإسلامية مع القبائل العربية التي بدأت تتغلغل هناك منذ القرن الثاني للهجرة، على الرغم من أنّ المعاهدة كانت تعطيهم حقّ الدخول في النوبة، مجتازة لا مقيمة, إلا أنّ هذه القبائل تقدّمت في هجرتها وتوغلت جنوباً, واستقرت قطاعات عريضة منها في شرق ووسط وغرب السودان, حتى وصل هذا الوجود إلى بلاد الحبشة ودارفور في أواخر القرن السادس الهجري(89).
وخلاصة الأمر:
إنّ الوجود العربي الإسلامي في بلاد النوبة لم يظلّ حبيس المناطق الشمالية, بل ظلّ يمتد على الدوام, ويتوسع جنوباً في كل ركب نازح, أو هجرة لقبيلة, أو جماعة من المسلمين، تدفعهم إلى ذلك دواعي نشر العقيدة الإسلامية, وبسط دعوتها, إضافة إلى دوافع أخرى أمنية وسياسية واقتصادية, وانفتحوا على السكان الأصليين من نوبيين, وبجة, وزنج, وغيرهم, فصاهروهم وأحدثوا مؤثرات كبيرة في حياة النوبيين، بما حملوه معهم من دعوة, وثقافة, ولغة, ونظام حياة, وقد قويت شوكتهم, وأصبحوا مستظهرين على جميع من جاورهم هناك من النوبة والبجة إلى سنة أربع ومائتين(90).
ثم إنّ المعاهدة ضمنت للمسلمين فتح بلاد النوبة للتجارة، والسماح لتجارتهم بارتياد البلاد على ألا يقيموا فيها، فكان التجار من أهم وسائل نشر الثقافة الإسلامية في بلاد النوبة, وهو دور لا يُستبعد أن يكون ولاة المسلمين قد توقّعوه من هذه الفئة المعروفة بنشاطها في مجال نشر الدعوة(91), وعلى إثر ذلك الاتفاق توغّل التجار إلى أعماق بلاد النوبة، ومع أنهم كانوا منصرفين إلى الأعمال التجارية في المقام الأول إلا أنهم كانوا رواداً في نشر العقيدة الإسلامية بين الوطنيين, واستطاعوا بما كسبوا من معرفة بأحوال البلاد, ونقلهم تلك المعرفة لمواطنيهم، تمهيد الطريق لهجرة القبائل العربية في أعداد كبيرة(92).
كذلك من أهم وسائل انتقال الثقافة الإسلامية، وانتشارها وسط النوبيين، الأفراد والمجموعات التي شاركت في الحملات التأديبية التي سيّرها سلاطين المسلمين وولاتهم على النوبة، عند إغارتها على جنوب مصر، أو عند تمردها على التزامها بدفع ما عليها من (بقط)، حيث كانت أعظم هذه الحملات، وأكثرها على بلاد النوبة في العهد المملوكي(93), وقد استغل هؤلاء الجنود فرض الأمن والحماية, وحقّ التوغّل التي كفلها لهم (عهد البقط)؛ فاستقروا هناك بعد أن خلعوا عنهم صفات الجندية الرسمية, وهو الأمر الذي طمأن النوبيين, فزوجوهم من بناتهم, وتوثقت الصلات بينهم، فنقل إليهم هؤلاء المحاربون القدامى كثيراً من المؤثرات الثقافية الإسلامية.
بالإضافة لهذه الجهود كانت هناك جهود بذلها الدعاة الذين حملوا هم الدعوة, ونقلوا كثيراً من مظاهر الثقافة الإسلامية للنوبيين, والتاريخ مليء بالشواهد الدالة على مدى توفيقهم في دعوتهم، ولذلك أسباب، منها حماسهم الديني، وما اتصف به الإسلام من بساطة ووضوح, وإضافة إلى أنهم في كثير من الأحوال كانوا يصاهرون القبائل الوثنية، فيعينهم حقّ الأم على توطيد مراكزهم في الأسر(94).
وقد ساهمت كلّ تلك العوامل في نشر الثقافة الإسلامية وسط أهل النوبة المسلمين الذين تأثروا بها تأثرّاً مباشراً, بل تجاوز هذا التأثير الإسلامي هؤلاء المسلمين إلى غيرهم من الذين بقوا على نصرانيتهم وإلى الوثنيين منهم.
وهذا لا يعني أنّ الثقافة الإسلامية قد قضت تماماً على الموروثات الثقافية النوبية, إذ إنّ ما حدث كان نوعاً من التأثير الثقافي من حضارة قوية وافدة على حضارة نصرانية ضعيفة، تتخللها بعض الموروثات من العادات والتقاليد الوثنية الضاربة في أعماق البلاد، لذلك لم تتخل النوبة عن كلّ ما هو قديم وتليد، لأنّ ذلك فطرة الإنسان من حيث هو كائن, يرعى تراث الآباء والأسلاف ويفاخر بما خلّفوه له, بل ينظر إليه على أساس أنه تراث يجب حفظه, والدفاع عن بقائه، إضافة إلى أنّ الإسلام لم يطلب من الذين اعتنقوه وأقبلوا عليه التخلّي عن كلّ موروثاتهم القديمة ما دامت لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وقد أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض من عادات العرب في الجاهلية ما لم تكن مخالفة لتعاليم الإسلام – كما سبقت الإشارة إليه –، بل إنه أثنى على بعض تلك الموروثات، وأشار إلى أنه لو دُعي إليها في الإسلام لاستجاب وشارك فيها، مثل (حلف الفضول) الذي حضره الرسول صلى الله عليه وسلم في دار عبد الله بن جدعان بمكة المكرمة قبل مبعثه(95).
إضافة إلى أنّ منهج الإسلام في التعامل مع ذلك الموروث هو العمل على تهذيبه، وتنقيته مما يتعارض مع الدين, وهذا ما حدث في كلّ المناطق التي أقبلت على الإسلام في إفريقيا, ونشأت بذلك بيئات حضارية محلية، لكلّ بيئة مقوماتها الخاصة، واتجاهاتها الخاصة كذلك, ولكن تجمعها في إطار واحد صفات إسلامية مشتركة من وحدة الدين, واللغة, والمُثُل(96).
ويمكن أن نسمّي ما حدث في النوبة نوعاً من الملاءمة – أو المثاقفة – بين المحلّي الموروث وبين الإسلامي المكتسب, وقد تبدّت بعض مظاهر تلك الثقافة الوليدة عند سلاطين إفريقيا الغربية في طريقة جلوس السلطان للمظالم, وفي لباسه، وفي المحطين به, واستخدام الطبول المصنوعة من القصب والقرع(97), إضافة لما ذكره بعض المؤرخين الذين شهدوا تلك الممالك, ومن وصف للقصر ولحياة السلطان, واستخدامه لبعض المناصب والمصطلحات الإدارية, مثل: نائب السلطان, والفرادية الأمراء, والتراجمة(98), وقد أشار بعض المؤرخين إلى تفشي هذه الظواهر نفسها عند السلاطين الذين ورثوا الممالك النوبية, فيبدو الأثر الإسلامي واضحاً في عاداتهم وأخلاقهم، وفي الألقاب, والنُّظُم والرسوم(99).
أيضاً من مظاهر تأثّرهم بالثقافة الإسلامية ما عُثر عليه في منطقة مينارتي – شمال دنقلة – من كتابات عربية على شواهد بعض القبور، تحمل أسماء عربية في القرنين الثاني والثالث الهجريّين(100), وفي منطقة كلابسة ترجع إلى سنة 317هـ / 927م(101), كما عُثر في المنطقة نفسها على مقابر نوبية عليها كتابات باللغة القبطية, تحمل تاريخاً مزدوجاً من التقويمين: القبطي, والهجري, ويبدو أنها من آثار جاليات عربية, ثبت أنها استقرت هناك من القرن الثالث الهجري(102), بل تظهر بعدها كتابات لا تحمل سوى التاريخ الهجري، وترجع إلى القرن نفسه(103).
وإذا كان هذا الأثر الإسلامي قد تبدّى فيما كُتب على شواهد القبور هذه، فإنه يتوقّع أن يكون هذا الأثر قد صاحب كلّ المراحل التي تمر بها جنازة المتوفى، بدءاً من غسله وتكفينه حسب السنّة النبوية، ثمّ الصلاة عليه، فانتهاءً بدفنه في اتجاه القبلة.
ومن مظاهر انتشار الثقافة الإسلامية وسط النوبيين اتخاذهم للأسماء العربية, وتسميتهم بها, فتتحدث المصادر عن أنّ حاكم إقليم الجبل النوبي اسمه (قمر الدولة كشي)(104), وعن بعض علماء المسلمين من النوبة، مثل: يزيد بن أبي حبيب، وذو النون المصري (النوبي الأصل)(105)، وتحية النوبية الزاهدة(106)، وغيرهم ممن تسمّوا بالأسماء العربية بدلاً من اتخاذهم الأسماء النوبية.
كذلك من المؤثرات الثقافية التي انتقلت إلى النوبيين من المسلمين اتخاذهم الحوادث التاريخية الشهيرة مناسبات، يؤرخون بها، إذ كان العرب يؤرخون بالحوادث العظيمة في حياتهم، كسيل العرم، وبناء الكعبة، وحرب البسوس، ويوم حليمة، وغيرها(107)، فاتخذ النوبيون والعرب المستعربون في بلاد النوبة حوادث: كسنة البعوضة، وسنة الفار، وقتلة العقال، وأصبحوا يؤرخون بها(108).
وفي مجال العقوبات والجنايات بدا الأثر الثقافي الإسلامي واضحاً في حياة النوبيين الذين كان من أعرافهم الاجتماعية طرد مَن يرتكب جريمة السرقة من القرية(109), إضافة إلى أنّ النوبي كان إذا خامره شك في زوجته حملها ليلاً إلى النهر وأغمد مديته في صدرها، ثم يقذف بها في النيل، بينما أنه في حالة الطلاق يستولي على جهاز مطلقته, ثم يحلق رأسها, ووجود هذه الشرائع والأعراف في المجتمع النوبي يؤكّد ضعف الأثر النصراني في البلاد, إذ أنها شرائع وأعراف تتنافى مع التعاليم النصرانية وشرائعها, إلا أنهم سرعان ما تأثروا بشريعة الإسلام, وآدابه في التعامل مع هذه المواقف, والجنايات, فتقلّصت إلى حدٍّ كبير تلك الثقافات الوثنية التي ظلت سائدة تحكم الحياة النوبية وتوجهها.
هذا، ولم يقف أثر الثقافة الإسلامية على عامّة النوبيين فحسب, بل نجده قد تجاوزهم إلى ملوكهم وحكامهم الذين عرفوا الكثير عن الإسلام وأركانه, وفرائضه, وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم, وعن سيرته صلى الله عليه وسلم, وعن أنساب القرشيين وقرابة الصحابة, والأسر الحاكمة بعضها من بعض, فيتضح ذلك من نصّ الحوار الذي دار بين عبيد الله بن مروان بن محمد (آخر الولاة الأمويين على مصر)، حين فرّ إلى بلاد النوبة خوفاً من العباسيين الذين أرسلوا في طلبه، وبين ملك النوبة حين علم بقدوم عبيد الله ودخوله أرض بلاده، إذ يبدو الأثر الإسلامي واضحاً في سؤال الملك النوبي لعبيد الله عن: «كيف سُلبتم ملككم, وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم؟»، فقال عبد الله: «إنّ الذي سلب منا ملكنا أقرب إلى نبينا منا (يقصد بذلك بني العباس)»، قال له ملك النوبة: «فكيف أنتم تلوذون إلى نبيكم بقرابة وأنتم تشربون ما حرم عليكم من الخمور، وتلبسون الديباج وهو محرم عليكم, وتركبون في السروج الذهب والفضة وهي محرمة عليكم، ولم يفعل نبيكم شيئاً من هذا؟»(110).
كما أنّ النوبيين كانوا ينظرون إلى المسلمين على أنهم أصحاب حضارة وثقافة أرقى وأسمى، فما كانوا ليترددوا في الإقبال عليها والأخذ منها، ومما يؤكد نظرتهم تلك مبادرة الملك النوبي إلى يد الأمير عبيد الله وتقبيلها حين التقيا(111), بالرغم من أنّ عبيد الله لم يكن رأس الدولة الإسلامية, وإنما هو أمير من الأمراء، أو والي من الولاة، بينما كان النوبي ملكاً على البلاد كلها.
انتشار اللغة العربية:
لقد سبقت الإشارة إلى أنّ انتشار الدعوة الإسلامية في الحقيقة هو انتشار لثلاث ظواهر: انتشار للعقيدة الإسلامية والشريعة، وانتشار للثقافة العربية الإسلامية، وانتشار للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم والدعوة، وهذا لا يعني بحالٍ أنّ كلّ ظاهرة من هذه الظواهر منفصلة عن الأخرى، بل هي ظواهر متداخلة تسير جنباً إلى جنب، وتتفاعل كلها في وقت واحد، وتخضع لمؤثرات واحدة كذلك(112).
وقد انتشرت اللغة العربية وازدهرت بعد توقيع (معاهدة البقط)، وفتح بلاد النوبة لهجرة القبائل العربية مع حركة الفتوح الإسلامية، ولم يحدث ذلك في يسر وسهولة، بل صارعت كثيراً من اللغات واللهجات التي كانت سائدة في تلك المناطق ونافستها، وخرجت من صراعها ذلك متغلبة عليها على مرّ الأجيال, وعبر الحقب التاريخية المختلفة.
وقد ساعدت عوامل كثيرة في ذلك الانتشار، أهمها الآتي:
العامل الديني: فحيثما انتشر الإسلام واستقرت قواعده انتشرت اللغة العربية، وقد ساعد على ذلك ما أجمع عليه أغلب أئمة المسلمين من عدم جواز ترجمة القرآن الكريم، وعدم جواز كتابته بغير اللغة العربية، وعدم جواز القراءة بغير اللغة العربية في الصلاة(113)، فهي لغة العبادة في الإسلام، لذا أقبلت عليها الشعوب المختلفة التي اعتنقت الإسلام، تحاول تعلّمها، ومعرفة ألفاظها ومعانيها، ومعاني القرآن الكريم، حتى تصحّ العبادة، وتُؤدى على الوجه الصحيح المطلوب.
وهناك عوامل لغوية أيضاً: ساهمت في انتشار العربية؛ لأن انتشار الدين وحده ليس كافياً في تعليل سرعة هذا الانتشار؛ إذ إنّ انتشار الإسلام كان أسبق من تعلّم اللغة العربية بعدة قرون, وهذا العامل هو وجه القرابة بين اللغة العربية وبين أخواتها الساميات في كثير من المظاهر الصوتية واللفظية والنحوية من جهة, وبين اللغات السامية والحامية من جهة أخرى, مثل ذلك التشابه بين اللغات السامية والقبطية في الضمائر, وأسماء العدد والتثنية وقواعد الصرف(114).
إضافة لذلك هناك العامل الحضاري: فالمعلوم أنه إذا التقت لغة ذات تراث حضاري متفوق مع أخرى حظها من التراث قليل فإنّ الأمر ينتهي بسيادة اللغة العريقة التراث والثقافة، وهذا ما حدث في كثير من المناطق التي انتشر فيها الإسلام في القارة الإفريقية.
وبالنسبة لبلاد النوبة؛ فإنّ (معاهدة البقط) قد ظلت تمثّل الركن الأساسي في مسار العلاقة بين البلدين، وفي فترة سريانها تسربت المؤثرات الإسلامية في هدوء، أدى في نهاية الأمر إلى تغيير مسارها الديني والسياسي والاجتماعي، ولم يحدث ذلك التأثير إلا عبر مراحل مختلفة، وفترات طويلة من المجاهدات والإسهامات التي قدّمها المهاجرون من الدعاة والتجار والأفراد والرعاة، وقد تبدّت تلك المؤثرات في كثير من مظاهر الحياة النوبية.
أما ظاهرة انتشار اللغة العربية؛ فقد كانت محدودة في أول الأمر, وبدأت الجماعات العربية الأولى التي استقرت في بلاد النوبة نشر الإسلام وسط النوبيين بعد أن تعلموا لغتهم، فسهلت مهمتهم بذلك(115).
وليس معنى هذا أنّ اللغة العربية لم تنتشر بين النوبيين في هذه الفترة المبكرة، ذلك أننا نجد كثيراً من الدلائل تشير إلى انتشارها في البلاد، منها وجود كتابات في مقابر نوبية باللغة القبطية، تحمل تاريخاً مزدوجاً من التقويمين القبطي والهجري، ثم تظهر بعد ذلك كتابات من هذا النوع لا تحمل سوى التاريخ الهجري(116), ثم في مراحل متقدمة تظهر شواهد قبور مكتوبة بالخط العربي تحمل أسماء عربية ترجع إلى القرن الثالث الهجري(117).
وفي هذه الفترة المبكرة ظلت اللغة العربية الفصحى لغة العبادة فقط إلى جانب اللهجة المحلية الدارجة لكلّ قبيلة(118), أما لغة الأدب والخطابة والمحادثة فكانت الدارجة وحدها، وقد ساعد على احتجازها في هذا الجانب قلّة عدد المتعلمين منهم، واشتداد العصبية القبلية، وصعوبة الاتصال بين الجماعات المتناثرة في أنحاء النوبة المختلفة(119), إضافة إلى أنّ اللغة النوبية كانت متمكنة في البلاد، إذ إنها تمثل إحدى اللغات الحامية التي هاجرت إلى النوبة في فترة ترجع إلى القرن الثالث قبل ميلاد المسيح(120), ومع تحوّل ملوك النوبة للنصرانية تُرجمت بعض النصوص الدينية إلى اللغة النوبية، لكنها لم تكن لغة الشعائر والطقوس, إذ ظلت اليونانية والقبطية هما لغتا الكنيسة النوبية(121), لكنها لم تتمكن من نفوس النوبيين برغم كونها لغات حية لها آدابها وعراقتها ووسعها، وذلك بسبب أنها بقيت لغة للشعائر الدينية محصورة في الكنيسة، فلم تغادرها أصلاً، فضلاً عن عدم فهم النوبة لها وتجاوبهم معها.
ولم يعرف النوبيون الذين اعتنقوا الإسلام في هذه الفترة المبكرة أداء الشعائر الإسلامية المفروضة على الوجه التام المطلوب، ففي الصلاة مثلاً لم يعرف قطاع كبير منهم من الصلاة إلا التهليل والتكبير(122), ومرد ذلك إلى قلّة الفقهاء والمتعلمين، أو المتخصصين في علوم اللغة ممن وفد إلى النوبة، إضافة إلى أنّ البلاد لم تشهد حركة علمية واسعة لها نشاطها، ولم تكن كذلك ثرية ثراء الحركات العلمية التي قامت في بقية البلدان الإسلامية، ولم يكن لعلمائها شهرة وصيت مثلما كان للعلماء في تلك البلاد(123).
إلا أنّ ذلك لم يحل دون تسرّب كثير من المفردات والألفاظ العربية إلى اللغة النوبية، حتى أضحت في فترات متقدمة تمثّل 30% من مجموع ألفاظ اللغة النوبية ومفرداتها(124), ومع مرور الزمن, وكثرة اختلاط العناصر العربية مع النوبيين، تحولت اللغة العربية من كونها لغة عبادة وشعائر إلى أن تصبح لغة ثانية بعد اللغة العامية النوبية، وأصبح النوبي يتحدث بها في معاملته التجارية مع التجار العرب، والتجار الآخرين القادمين من بلاد البجة وعلوة وغيرها؛ فأصبحت العربية بذلك لغة تخاطب بينهم، وقاسماً مشتركاً بين النوبيين أنفسهم، حيث يتكلم بها النوبي إضافة إلى لغته المحلية(125).
على أنّ اللغة العربية التي انتشرت في النوبة لم تكد تخلو من ظهور بعض الاختلافات الشكلية بين اللهجات العربية القبلية, ويظهر أنّ هذا التعدد يعود بأصولها إلى لهجات أقدم منها عاشت في شبه الجزيرة العربية(126)، بيد أنّ هذه الاختلافات الشكلية بين اللهجات العربية لا تعدو أن تكون تغيّراً طفيفاً في النطق, أو تغييراً لبعض الحروف والحركات بالإبدال أو الحذف.
وقد حصر بعض الباحثين هذه الاختلافات الشكلية في أربعة مسائل(127):
1 – تغيير نطق بعض الحروف.
2 – تغيير الحركات.
3 – حذف بعض الأصوات.
4 – تغيير مدلول الكلمة.
إلا أنّ هذه الفروق لا تمثّل اختلافاً جوهرياً يحول دون قيام ثقافة ذات مضمون وجوهر واحد, إضافة إلى كونها فوارق لا تمثل حاجزاً لغوياً يقف حائلاً دون وحدة الثقافة، والدليل على ذلك ما يشاهد اليوم في سودان وادي النيل، فبرغم ما بين اللهجات العامية من فوارق في النطق والحركات والأصوات, وأـحياناً تغيير مدلول الألفاظ والكلمات، إلا أنّ أهل السودان تنتظمهم ثقافة واحدة, هي الثقافة الإسلامية العربية(128).
هذا، وقد ظلت اللغة العربية تتقدم في المنطقة تبعاً لتقدم الإسلام الذي استمر انتشاره تبعاً لتوغل القبائل العربية في بلاد النوبة، حتى عمّ أجزاء كبيرة في شرقي ووسط وغربي بلاد السودان، حيث يلاحظ أنّ هذا الوجود قد وصل إلى بلاد الحبشة شرقاً، ودارفور في غرب السودان في أواخر القرن السادس الهجري(129)، وتمكنت اللغة العربية بذلك من محاصرة اللغة النوبية تماماً، وعزلها عن تلك المجتمعات(130).
إضافة إلى ذلك فقد أسهم الشيوخ – من الدعاة الذين وفدوا إلى النوبة، واستقروا في دنقلة، وقرروا البقاء هناك – مساهمة كبيرة في نشر تعاليم الإسلام واللغة العربية، بعد أن هالهم ما رأوا من جهل مستشر بتعاليم الدين والعقيدة الصحيحة، فأخذوا يعمرون المساجد، وينشؤون المدارس وحلقات تعليم القرآن الكريم وحفظه(131).
فكان لتلك الحركة العلمية على بساطتها، وضعفها أثر واضح في انتشار اللغة العربية، وذلك بإقبال الأهالي على هؤلاء الدعاة للتعلّم منهم، والتتلمذ على أيديهم.
على أنّ اللغة العربية لم تسلم من دخول بعض المفردات النوبية عليها، لكنها بقيت واضحة كألفاظ غريبة ودخيلة عليها، ولم تؤث ذر في جوهرها، وتتمثل في أسماء بعض الأدوات والصناعات التي لم يعرفها العرب في جزيرتهم، فظلت هذه الأسماء مستعملة في اللغة العربية في معظم سودان وادي النيل.
د. ربيع محمد القمر الحاج (*)