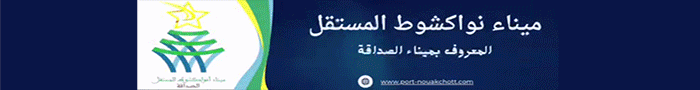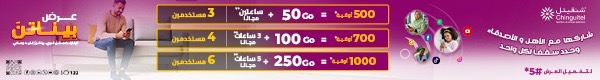بالرغم من اقتراب المسار الديمقراطي الموريتاني من إكمال عقده الثالث، ما تزال عملية التحول الديمقراطي إلى حد بعيد رهن إرادة السلطة الحاكمة بفعل غياب البديل الديمقراطي القادر على قيادة التغيير نحو الأفضل وصيانته وحمايته. فقد أسفرت عملية الانفجار الهائلة التي تعرضت لها الساحة السياسة الوطنية بعد انقلاب 2005 عن تداعيات جد خطيرة لم يكن من أهونها شأنا ما تعرض له ما كان يعرف بقوى التغيير الديمقراطي من تشرذم وتفسخ ووهن.
ومعأن انقلاب 2008 جاء في سياق صراع تلك القوى على السلطة، وتمكن في مرحلة أولى من تجيير ذلك الصراع لمصلحته، إلا أن التطورات اللاحقة أظهرت أنه كلما تعمقت القطيعة بين السلطة ومعارضتها وأوغلتا في محاولات الإفناء المتبادل، كلما تعرض المجال السياسي لغزو فاعلين جدد يسعون شيئا فشيئا لاحتلال واجهة المشهد السياسي وبسط هيمنتهم عليه.
وسواء كنا أمام حركات اجتماعية أو أمام تنظيمات حقوقية أو فئوية أو عرقية مثل "إيرا" و "نداء الوطن" و"لا تلمس جنسيتي"، أو تنظيمات سرية يمينية لم تتكشف حقيقة نواياها بعد، أو أمام الشبكات السابحة في فضاء التواصل الاجتماعي، أو كنا أمام شخصيات طامحة للعب دور وطني، فإننا قد أصبحنا اليوم أمام واقع جديد يتميز بتحجيم دور الفاعلين السياسيين التقليديين وبخلق تحديات إضافية أمام البلاد.
وتجري هذه التحولات في سياق دولي وإقليمي بالغ الخطورة، لم يعد فيه فشل الدول يجري وفق مسار تدريجي يمكن توقعه والتحكم فيه، بل إنه بات يحصل "فجأة" وبأكثر الطرق مأساوية. ومع أن بعض مؤشرات الاستقرار السياسي تدعو للتفاؤل بشأن مستقبل بلادنا، إلا أن بعضها الآخر يكشف أن البلاد ستظل ضمن دائرة الخطر مادامت وحدتها الوطنية عرضة للتصدع ومادامت القاعدة العريضة من شعبها لم تحقق طموحها المشروع في العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ضمن هذا السياق أيضا، تستعد البلاد للدخول في منافسة انتخابية مصيرية، ليس بالنسبة للبلاد التواقة إلى تحقيق عبور آمن نحو التناوب الديمقراطي، والنظام الحاكم الساعي للاستمرار في السلطة، فحسب، بل كذلك بالنسبة للمعارضة التي انتظرت هذه اللحظة منذ عقد، لتثبت أنها الأجدر بإدارة شؤون البلاد وأن سياساتها الراديكالية تجاه النظام، ستجني لها تضامنا شعبيا كفيلا بتحقيق حلمها في الوصول إلى السلطة. فهل تنتظر المعارضة فعلا دورها على الخشبة؟ أم أن سياساتها في المرحلة المنصرمة، وضعتها على حافة الإفلاس؟
مسار دحرجة كرة اللهب
تبنت المعارضة الراديكالية، منذ هزيمتها في انتخابات 2009، سياسة المقعد الشاغر، انطلاقا من مقاربة تفضل –بحسب ما هو معلن- الإبقاء على "وضعية أزمة"، سعيا لانتزاع تنازلات من النظام الحاكم تضمن "الشفافية الكاملة" للاقتراع من خلال حرمان السلطة من جميع وسائل التأثير عليه، وذلك بحجة أن زمن "القبول بما هو متاح فقط" قد ولى ولم يعد من الوارد القبول بما هو أقل مما توفر خلال "المرحلة الذهبية للديمقراطية الموريتانية".
ومع أن البحث عن تحسين شروط المنافسة يعتبر حقا مشروعا بل واجبا لا يمكن التنازل عنه لمن يسعى للوصول إلى السلطة، إلا أن محاولة تطبيق هذه السياسة–بغض النظر عن الدوافع الحقيقية لتبني هذا الطرف أو ذاك لها- من خلال القفز على الآليات الديمقراطية وعدم الاكتراث للأضرار التي تنجر عنها لديمقراطية البلاد والمؤسسات الحزبية، بالإضافة إلى تعارضه مع رغبات ومصالح الجماهير، كل ذلك يضعه في قفص الاتهام.
لا أحد ينبغي أن يجادل في مشروعية الطموح لبناء نظام ديمقراطي يتسع لحريات وحقوق الجميع، غير أن البحث عن "الديمقراطية الجاهزة" خصوصا حين يكون من خلال أدوات غير ديمقراطية وعلى حساب أولوية بناء البديل الديمقراطي، قد لا يخفي خلفه أكثر من الحنين للمراحل الانتقالية والأمل الزائف في إمكانية مغافلة التاريخ والقفز على كرسي بات الاهتمام به يطغى على غيره بما في ذلك مراكمة مصادر القوة التي تسمح بالوصول إليه وتمكن فيما بعد من الاحتفاظ به.
والواقع أنه لا شيء أخطر على التحول الديمقراطي من التعلق بالمراحل الانتقالية ليس لأنها فترات استثنائية مفتوحة على مختلف الاحتمالات فحسب، بل أيضا لأن التعود عليها يحرم مسار الانتقال من لحظته التأسيسية فائقة الأهمية ويجعله عرضة للإرتكاس الدائم بفعل الأزمات التي تعترضه مما يحكم عليه بالدوران في حلقة مفرغة بدل التطور باستمرار وبثقة نحو تحقيق غاياته.
أما حين تمتزج الرغبة الدائمة في "إعادة التأسيس" مع التخلف المستمر عن الاستحقاقات الانتخابية ويترك البحث عن التوافق مكانه لصناعة الأزمات، فإننا نكون أمام مساع مبيتة لإجهاض مسار التحول،تغذيها نزعة استعجالية ثأرية تتجاهل القواعد الرئيسية للممارسة السياسية وتضرب عرض الحائط بحساسية الوضعين الوطني وشبه الاقليمي.
ذلك أن محاولة القفز على واقع اختلال ميزان القوى والشغف الطفولي بحرق المراحل والتعالي على رغبات واستعداد الجماهير، هي صفات تنتمي إلى عالم الشجاعة بالفعل غير أنها لا تقود إلى أبعد من شعاراتية استعراضية قد تكون مفعمة بالغرور والنرجسية لكنها محملة أكثر بخيبات الأمل.
فهل من الوجاهة في شيء الاعتقاد بأن احتراف دحرجة لهب كرة الأزمة –في ظرفية كالتي يعيشها شعبنا اليوم وضمن سياق إقليمي كالذي يحف به- يبقى أفضل الحلول المتاحة؟ وهل في التجربة الذاتية لقوى التغيير الوطنية ما يثبت أن مسار الانتقال يتقدم من خلال مقاطعته والتحريض عليه، وليس من خلال مواكبته والثقة فيه؟ وأي مغزى لاختصار كل التحديات والهموم التي تواجهها البلاد وشعبها في مطالب سياسية تتعلق بتحديد مواصفات من هو الأجدر بحكمنا؟
ألمتكشف التحولات الحاصلة عن تنامي منافسة شرسة للقوى السياسية التقليدية تهدد بتحجيم أدوارها وبالحد من نفوذها إن لم يكن بتقويضه؟وفي مثل تلك الحالة، ألم يكن الانسحاب الطوعي من المشهد مجازفة تحمل مخاطر عدم إمكانية العودة إليه، خصوصا في ظل الصراع غير المتكافئ مع السلطة والمطالب المتصاعدة بضرورة تجديد الطبقة السياسية؟
لقد خبرت قوى التغيير المنافسات الانتخابية في ظروف أسوأ بكثير مما كان عليه الحال سنتي 2013 و2014 وحصدت النتائج السلبية لهجران حلبة الصراع ضمن مناخ خدمها أفضل مما عليه الحال آنذاك، غير أنها للأسف رفضت استخلاص الدروس من تجربتها الذاتية أو لكأن أهدافها قد تغيرت لدرجة بات معها التعرف عليها عملية بالغة الصعوبة.
تقاطع للخطوط وتبادل للمواقع
مع تقدم الأيام، تمكن ملاحظة أن طبيعة الصراع بين المعارضة والسلطة قد انحرفت بفعل تداعيات الانفجار الهائل الذي تعرضت له الساحة السياسيةسنة 2005،وعدم جاهزية قوى التغيير لمواكبة التطورات الحاصلة منذ ذلك الوقت.وكتجل لهذا الانحراف، تركت المعركة من أجل التحديث والتنمية السياسية، مكانها لنوع من "العناد" مع منافس تمكن على حين غفلة من الطبقة السياسية التقليدية، من التحول شيئا فشيئا إلى رقم صعب في المعادلة الوطنية.
ولأن العناد سلوك عاطفي أكثر منه موقف عقلاني، فإن الموضوعية ستنتحر على مذبح الرغبة العارمة في رفض الخصم وتدميره،وبدلا من التوقف أحيانا لإعادة النظر في المسار من أجل تحديد مكامن الخلل، سيتم اللجوء إلى أسهل الحلول متمثلا في تعليق الإخفاقات على مشجب الشعبوية وإلقاء اللوم على الجماهير "المتخلفة والمخدوعة والجبانة والمتهافتة على الفتات"!
بالفعل يمكننا أحيانا أن نتعالى على الجماهير ونتهمها بالغباء والنفاق، غير أننا مجبرين على الاعتراف بأنها على الأقل تعرف أين تكمن مصلحتها. فحين تكون أهداف الصراع واضحة يكون من لديهم مصلحة في التغيير قادرين على التعرف على حليفهم الطبيعي، أما حين تسود الضبابية ويختلط الحابل بالنابل فإنهم مع ذلك لا يفقدون القدرة على التمييز بين من يزج بهم في معارك خاسرة حين تكون المصلحة له ومن يتعالى عليهم حين تكون الحاجة لهم، وبين من يعايش همومهم ويسعى لتحقيق طموحاتهم.
لقد ولى ذلك الزمن الذي كانت فيه الخطوط جلية بين قطبين أحدهما يجسد التغيير الديمقراطي المنشود، بخطابه وقيمه وقاعدته الاجتماعية وأيضا بتقاليده النضالية الوضاءة، بينما يكافح القطب الثاني من أجل استبقاء الأوضاع على ما هي عليه. فهل يكون قد حصل تبادل في الأدوار بين فرقاء المشهد في خضم التحولات المكثفة التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة ومع ذلك ما يزال البعض –متكلسا في لحظة انقضت- ويتصرف وكأنه الناطق باسم "التغيير" بينما هو في الحقيقة –بممارساته وشخوصه والمصالح التي يدافع عنها- قد أصبح يمثل الماضي في كثير من جوانبه غير الإيجابية؟
وضمن هذا التبادل للمواقع وبعد تجريده من دلالته السياسية،سيتحول "التغيير" إلى أقنوم أو إلى شعار منزه عن المساءلة وكأننا لم نعد بحاجة إلى معرفة من وما الذي يجب أن يتغير؟ وإلى أين؟ ولمصلحة من؟ أو لكأننا نسعى إلى تفادي تساؤلات من نوع: ما الذي يتطلبه التغيير نحو الأفضل؟ ماذا لو كان التغيير الذي نبشر به تغييرا نحو الأسوأ؟ وأي موقف يتعين علينا أن نتخذه من التغيير الذي تشهده البلاد؟
وإذا كانت الرؤية الوثوقية للذات وللدور التاريخي المنوط بها وبها وحدها فقط تحقيقه، ستتكفل بوضع التساؤلات المتعلقة بنوعية "التغيير" ضمن خانة المسكوت عنه، فإن سؤال إعادة تقييم واقع البلاد غير مطروح أصلا ليس بسبب عدم الاعتراف بأن تطورات مهمة قد حصلت، بل لأن ما حصل منها تم في غياب شبه كامل لنخب ظنت يوما أن مصير البلد مرتبط بها، وفي ظل أحادية مطلقة ومركزية مكثفة للقرار.
حلقة "قوى التغيير" المفرغة
لا تكمن المشكلة في أن أخطاء كثيرة قد ارتكبت وقادت لعدد من الإخفاقات،وإنما في نقص الجرأة على الاعتراف بالأخطاء وفي الإصرار على الاحتفاء بالإخفاقات باعتبارها انتصارات عظيمة، مع تجاهل ما ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة إن على مستوى التنظيمات نفسها أو بسبب تضييع فرص التوصل إلى وفاق وطني يخدم استقرار البلاد وتنميتها وتعزيز وحدتها الوطنية.
وإذا كان من الدارج التساؤل حول مدى ارتهان القرار السلطوي في بلادنا لخدمة بعض القوى الدولية، فقد يكون من الوارد أيضا التساؤل حول ما إذا كانت أولويات بعض القوى الوطنية باتت تتحدد أولا في بعض عواصم العالم، ليس لأن مركز ثقل الفعل المعارض للسلطة الحالية قد انزاح منذ فترة من الداخل إلى الخارج فحسب، بل لأن "التغيير بأي ثمن وبأية وسيلة" هو أسلوب من يضعون مصالحهم الخصوصية فوق غيرها من الاعتبارات ولم يكن في أي يوم من الأيام هو كل ما لدى قوى التغيير من بضاعة لتعرضها على شعبها.
أما حين يصبح الأمر كذلك فإن قوى التغيير تكون قد كفت عن لعب دورها الخلاق لتتحول إلى قوة عطالة ولتسلك منعرجا يمكن أن يقود –للأسف- إلى ما هو أبعد من المأزق الحالي: الانكفاء والاستسلام لإغراء الراديكالية بدل الانفتاح والانخراط الايجابي في الحياة السياسية، خسارة المواقع والقواعد والوسائل والمكانة بدل توطيد المكاسب والتوسع ومراكمة القوى، هدر الطاقات والمجازفة باستقرار البلاد بدل جدولة الأولويات وتحقيق الأهم والمساهمة في خفض أجواء التوتر لصالح إجماع وطني يجنب البلاد منزلقات هي في غنى عن مواجهة تداعياتها المدمرة.
إنها النتيجة المنطقية للاستمرار في انتهاج خط مجابهة لا يرنو لأبعد من كرسي الرئاسة ولا يحلم بأكثر من تجريبية ليست شيئا آخر سوى الدوران في حلقة مفرغة من دون الشعور بالحاجة للتساؤل: إلى متى؟
لم يكن مفاجئا إذا ما آلت إليه أوضاع ما عرف سابقا بقوى التغيير: انتقال عدوى الإحباط من الأطر إلى القواعد الشعبية، أداء متواضع في الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الأخيرة، عجز عن تقديم مرشح رئاسي توافقي، تشتت بين المرشحين. وهي كلها مؤشرات على أن تلك القوى لم تعد تشكل –حتى في نظر بعض مكوناتها- البديل القادر على قيادة تغيير يلبي طموحات الشعب ويخدم ديمقراطيته.
ومع ملاحظة هذا الإخفاق والصعود المتسارع للحركات المرتبطة بالهوية، واتساع موجة التفاؤل التي تثيرها عملية التناوب الجارية، تصبح القوى الحية في البلاد مدعوة إلى وقفة تأمل لتقييم المرحلة المنصرمة، بغية تصفية الحساب مع فترة لم تنتج غير تعميق الهوة بين مكونات الشعب وانتشار الغلو والتطرف، بالإضافة إلى صناعة قادة يسعون بكل ما أوتوا من قوة لتأبيد هيمنتهم على المجال السياسي.
من هذا المنطلق، نوجه نداءنا إلى كل المهتمين بالشأن العام من تنظيمات سياسية ومدنية وحركات شبابية، من أجل التشاور والتنسيق لتشكيل جبهة إجماع وطني، تتأسس حول برنامج وطني، يحدد الأولويات الوطنية المجمع على أهميتها ويبحث في أفضل السبل التي تضمن تحقيقها. ومساهمة في تحديد ملامح هذا البرنامج، يمكننا منذ الآن أن نقترح بعض الأولويات التالية:
1-إنقاذ الشباب:
دفع الحراك الشبابي غداة اندلاع ثورات الربيع العربي لضرورة إعادة التفكير في دور الشباب في عملية التغيير الاجتماعي، باعتباره تأكيدا لعجز المؤسسات القائمة عن استيعاب طموحات هذه الفئة، وتأثير تراجع مستويات التعليم، وارتفاع نسب البطالة، والشعور بالاغتراب، وعدم اليقين من نجاعة مختلف السياسات المنتهجة.
ولم تستطع الأحزاب السياسية أن تمثل - بالنسبة للشباب - أملا في تغيير الواقع، وتحقيق الطموحات، فالأدوار التي ظلت تتاح أمامهم، لم تتجاوز تكليفهم بالمهام الهامشية، وظلت تحرص باستمرار على توجيه ولاءاتهم نحو القيادة بدل المشروع، محرمة عليهم الاقتراب من ميدان التأثير بصفته حكرا على جيل بعينه.
وقد حاول النظام استغلال هذا الواقع، موجها جماعات الشباب التي تدور في فلكه لتأسيس أحزاب سياسية، قدم لها الدعم للمشاركة في العملية الانتخابية، رافعا شعار "تجديد الطبقة السياسية"، ومعتمدا على حوارات أفضت لتأسيس مجلس للشباب واستقطب عدة جماعات شبابية أصبحت وقودا لحملاته الدعائية اللاحقة. غير أن هذه المسارات لم تكن في الحقيقة، أكثر من محاولة للتكيف مع الطموحات الصاعدة لهذه القوة الاجتماعية، فتحولت هذه المبادرات لأطر مهترئة وجامدة، تفتقد المشروعية، ما سيدفع السلطة لإهمالها في انتظار أن تسنح الفرصة للتخلص منها.
ويدفع الاستياء المتصاعد مما آلت إليه الأوضاع، الشباب نحو الهجرة، والتطرف، أو الانغماس في عوالم الجريمة والمخدرات، أو الوقوع في شراك الجماعات الإرهابية. وما يزال غموض الأهداف الوطنية في هذا المجال، والمخاطر الكثيرة المتجددة، تمثل تحديا يفرض ضرورة ترميم العلاقة بين الشباب والمجتمع، وإعادة بناء جسور الثقة بينهم مع الدولة والمجتمع، وإنقاذ هذه القوة من جحيم البطالة والتطرف.
2- مواجهة توحش اقتصاد السوق:
مثل غموض التوجهات الاقتصادية التي سلكها بلدنا في العقود الأخيرة سببا رئيسا لوجود الاقتصاد الوطني في وضع معقد وصعب، تعمق بفعل التمادي في انتهاج برامج اقتصادية غير واقعية، رسخت التبعية لمؤسسات التمويل الدولية، وأدت لعجز المقاولة الوطنية عن المنافسة، وتفكيك أسس الاقتصاد المحلي (الزراعة، التنمية الحيوانية).
ومن شأن استمرار هذه السياسات أن يقود لتأثيرات جد خطيرة على الطبقات المسحوقة، فغلاء المعيشة يجعل الأسر غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية من صحة وتعليم وحتى من المواد الأساسية الضرورية، كما أن استمرار اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، سيشكل تحديا مستمرا على الاستقرار الاجتماعي وبالتالي خطرا محدقا بالسلم الأهلي.
لقد بات من الملح اتخاذ تدابير عاجلة لوقف التأثيرات الحادة لاقتصاد السوق على الفقراء وذوي الدخول المحدودة، من خلال سياسات اجتماعية تعطي الأولوية لتوفير الحاجيات الضرورية للسكان ولدعم قدراتهم الشرائية. وينبغي ضمن هذا الإطار تنظيم حوار وطني بين مختلف الشركاء الاجتماعيين للاتفاق حول طبيعة السياسات الاجتماعية الملائمة لوضعيتنا الحالية والقادرة بالتالي على استئصال الجوع وتأمين حياة كريمة لشعبنا.
3-حالة طوارئ في مجال التعليم
يملك بلدنا ثروة بشرية هامة بصفته أحد البلدان التي يقع أكثر من نصف سكانها تحت سن 18 سنة، وهي القوة التي إذا ما تم تأهيلها ستشكل أحد أسس نهضتنا وإقلاعنا نحو المستقبل، فوحده الاستثمار في مجال التعليم يمكن أن يجعلنا نحجز مكانتنا في مصاف الأمم المتقدمة.
فبعد أكثر من نصف قرن على الاستقلال يظل التعليم في بلادنا ضحية لاختلالات جوهرية، عمقها عجزنا الدائم عن حسم اختياراتنا اللغوية، وهجرة الأطر والكوادر التربوية للقطاع،وضعف الاستثمار العمومي في مجال التعليم. لتصبح حقيقة التراجع المخيف لمنظومتنا التربوية ماثلة للجميع.
هذا الواقع يحتم على بلادنا إعلان حالة طوارئ، تهدف لتوفير التعليم الأساسي العادل والشامل والجيد لصالح المجتمعات المتضررة من الأزمة القائمة ومعالجة الوضع الكارثي للأسرة التربوية.
4-الوحدة الوطنية:
يكاد ينعقد الإجماع اليوم، بأن البلاد تجتاز إحدى أكثر مراحل تطورها خطورة، بعد أن تمايزت مكوناتها العرقية، لتصبح خيوط الفصل بينها مرئية أكثر من أي وقت مضى، سواء على مستوى المناطق السكنية أو في أماكن الدراسة والعمل. وبعد أن تحولت الفئات الاجتماعية من كونها مجموعة أفراد لديهم مراكز اجتماعية متشابهة، إلى أدوات لفرض المشاركة في عائدات غنائم السلطة.
لقد قاد الصراع على النفوذ والمناصب في بداية نشوء الدولة، الذي تدثر في مراحله الأولى بغطاء ثقافي، إلى اتساع الهوة شيئا فشيئا بين القوميتين العربية والزنجية الإفريقية، متسببا في أحداث مأساوية، أصبحت تلقي بثقلها على العلاقات بين هاتين المكونتين وعلى حاضر ومستقبل التعايش بينهما.
ومع عجز الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد عن الإدارة الرشيدة للصراع الاجتماعي الناجم عن تنامي الوعي والشعور المتزايد بالحرمان والتمييز، خصوصا لدى فئات اجتماعية تعرضت تاريخيا للغبن، تبلور خطاب تحريضي وجد ضالته في شبكات التواصل الاجتماعي، ليضع البلاد على ما يشبه حافة الانفجار.
ورغم خطورة الوضع وإغراء الدعايات المرتبطة بالهوية، فإن البحث عن الحل لن يكون ذا جدوى، خارج اليقظة الدائمة للسلطات المختصة وتشجيع الحوار والعمل الدؤوب على تحقيق مزيد من العدالة الاقتصادية والاجتماعية.تتكفل في إطاره الدولة بالنهوض بضحايا مختلف الممارسات الاجتماعية المتخلفة. ويمكن لمدرسة جمهورية لا تميز بين طلابها على أي أساس، أن تلعب دورا حيويا في تقوية اللحمة بين مختلف المكونات، كما يمكن للخدمة العسكرية الإجبارية تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
الخلاصة
بالنظر لما يميز الانتخابات الرئاسية القادمة من أهمية، فإن تنظيمها ينبغي أن يحاط بعناية خاصة، لتصبح الجسر الذي تعبر عليه البلاد من مرحلة التداول القسري للسلطة إلى مرحلة التناوب الديمقراطي، ومن الشرعية المفروضة بالقوة إلى الشرعية الممنوحة عبر صناديق الاقتراع والمعترف بها من طرف مختلف الفاعلين السياسيين.
وتبدو الحاجة اليوم ماسة للتأسيس لمرحلة إجماع وطني حول القواعد الضرورية للمنافسة، وتبني سياسات إعلامية تنهي عقود الترويج الفج للسلطة وشخوصها ومنجزاتها، والتباكي على عهود الإقطاع وتلميع الفكر الظلامي والشعوذة.
ويصبح العمل على قيام جبهة إجماع وطني رهانا وتحديا يتحتم على الديمقراطيين كسبه، والتضحية في سبيل نجاحه، لتتمكن البلاد من الاستفادة من تجربة وخبرة مختلف أطرها وكفاءاتها.
إن الإجماع المنشود سيدفع الأوضاع الوطنية للهدوء، وسيساهم في نجاح العبور الآمن نحو التناوب السلمي على السلطة، لتتمكن بلادنا من مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة وتتفرغ لمعركة التنمية والتحديث، في ظل ما حباها الله به من خيرات وموارد كفيلة بإسعاد جميع أبنائها.
عن اللجنة التأسيسية:
لمهابة ولد عبادي
محمد ولد تكدي
محمد غالي ولد اعبيدي
هادية ولد اليماني
الطالب ولد إبراهيم
أحمد ولد خطري
المصطفى ولد محمد الأمين ولد الفاضل
عبد الرحمن ولد حمودي