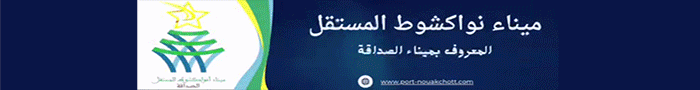ما الذي جرى حتى خفت صوت الرجل الذي كان صوته يملأ الساحة، وهدأت ماكينته الإعلامية التي لم تكن تهدأ؟ ما الذي جعل طيف ولد أجاي يتوارى شيئًا فشيئًا، بعد أن أوشك أن يُرسم على الجدران بوصفه "الرئيس القادم" أو "الحاكم الفعلي"؟ أهي عاصفة داخلية عصفت بالثقة؟ أم أن السقف الإعلامي الذي رُفع له كان أوهى من أن يصمد أمام دهاليز السياسة ومعادلاتها المتشابكة؟
لقد كانت حملة الترويج التي تقودها أذرعه الإعلامية تشي، بما لا يدع مجالًا للشك، بأن الرجل مشروع رئاسي يُصاغ بعناية، ويُقدم على أنه الممسك بخيوط الدولة، والمدعوم بجوقة من الأقلام والمواقع التي يُقال إن تمكينها لم يكن صدفة، بل تم بترتيب دقيق: عقود وُزّعت، وهبات قُدّرت بعشرات الملايين، وقطع أرضية نُثرت بسخاء في تفرغ زينة والصحراوي، في سياقٍ بدا وكأنه حملة مبكرة لكتابة اسم الرجل بالحبر الغليظ في دفتر الخلافة.
وقد بلغت تلك الحملة ذروتها حين استقبل ولد أجاي رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو ورافقه في محطات متعددة بين نواكشوط ونواذيبو، في لحظة دبلوماسية تزامنت مع زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي استقبله الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شخصيًا.
إلا أن التغطية الإعلامية ـ وعلى نحو لافت ـ أعطت الأولوية لحراك ولد أجاي، حتى كادت تُغيّب الاستقبال الرسمي للبرهان، مكتفية بلقطات عابرة من مطار أم التونسي وصور بروتوكولية في القصر الرئاسي، ما بدا وكأنه رسالة مبطنة مفادها أن مركز الثقل قد تغيّر، أو أن مشهدًا جديدًا يُراد له أن يُكرّس.
لكن ما إن مرّت تلك اللحظة حتى بدأت ملامح التراجع تلوح، وبدأ الظهور القوي للرجل يخفت تدريجيًا، إلى أن أصبح يوصف بالخجول.
روايات متداولة في الصالونات السياسية ومجالس النخبة تُرجع هذا التحول المفاجئ إلى ما نُقل عن ولد أجاي من أنه أسرّ لمسؤول إماراتي بأنه "المرشح المقبل لرئاسة الدولة بعد غزواني"، في محاولة لتسويق نفسه لدى أبوظبي طمعًا في دعمها المستقبلي.
غير أن تلك الروايات تقول إن هذه الرسالة وصلت إلى الرئيس، فأثارت امتعاضه، وربما غضبه الصامت، لأنها اختزلت رئاسته في مرحلة انتقالية، وفتحت شهية الطموح بطريقة أقرب إلى التسرع منها إلى الحصافة، في سياق لم يكن قد حُسم بعد.
وقد تكون تلك اللحظة بالذات هي بداية انحسار الثقة، وتدوين اسم الرجل في لائحة "الانتظار"، ريثما تتضح ملامح الحوار الوطني، الذي بدأ منسقه سلسلة لقاءات تمهيدية له، في إطار إعادة ترتيب للمشهد السياسي.
وما يعزز هذه التقديرات غيابه عن مناسبتين كان ظهوره فيهما من المُسلَّمات لمن اعتاد حب الأضواء وتصدُّر المشهد: الأولى، إفطار رئيس الجمهورية مع الحمالين في ميناء الصداقة، والثانية، الإفطار الرمضاني مع الطلاب في الجامعة؛ وهما مناسبتان تجتذبان عادةً صُنّاع الصورة والرمزية، خصوصًا من يحبون الظهور في هيئة الممسك بخيوط القرار، والقريب من نبض الشارع.
وتُضاف إلى هذه المؤشرات لقاءات سمح بها الرئيس لبعض الأسماء التي كانت تُعرف بأنها على خلاف واضح مع ولد أجاي، أو سبق أن أُبعدت من المشهد تحت وطأة تأثيره المباشر أو غير المباشر.
إن عودة هذه الشخصيات إلى دائرة الضوء لا تبدو مصادفة عابرة، بل رسالة سياسية مشفّرة، مفادها أن الخريطة يُعاد رسمها، وأن من كان يُحسب له كل نفس، لم يعد مركز الجذب الوحيد في دائرة السلطة.
وهكذا، تتناسل الأسئلة، وتضيق دوائر الإجابات، ويظل ولد أجاي، كما يبدو، في لحظة مراجعة صامتة، أو على هامش مشهد يترقبه كثيرون: إما أن يعيده إلى الضوء... أو أن يطيل مقامه في الظل.
-سيدي عثمان ولد صيكه