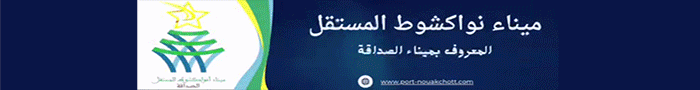المتابع لمايحدث الأن في الشارع الموريتاني من جرائم دخيلة علي مجتمعنا المسلم يتضح له بجلاء أن هنا ك آفة خطيرة تفتك بالمجتمع ككل وشبابه بشكل خاص حتي وصلت به إلي مستويات من الجريمة المنظمة لم يسبق لها مثيل وحتي أفقدته الوازع الديني الذي هو الأساس في بنية المجتمع .
حتي وقفنا عاجزين عن تفسير حول ما يحدث في يوميات الموريتانيين من جرائم بشعة، إلا أن الجميع أضحى يعطي تفسيرات وتحليلات هي أقرب للمنطق والصحة، وهي أن كل هذا وذاك، يحدث بفعل تأثير السموم التي تتهاطل علينا بشتى الطرق من الحدود ومرات من وراء البحار.
هذه المهلوسات بمختلف أنواعها وأشكالها المُذهِبة لعقول أصحابها، هي التي تجعل من بني آدم «ينزل إلى منزلة الحيوان» بلا ضمير أو رؤية وتبصر، بل تقوده غرائز وخيالات أحلام يقظته أينما حل وارتحل نحو ارتكاب كل محظور،
هذا عن الآليات التي ساقت هؤلاء الجناة وهم في مقتبل أعمارهم، يوم يتصرفون بطرق وحشية ما أنزل الله بها من سلطان، ثم تأتي بعدها الغايات والتي أغلبها من أجل السطو على أملاك الغير،حيث لم يسلم حي من أحياء العاصمة من سطو من اجل الحصول علي المال والمجوهرات، وبعض الأشياء المادية التي تمكنهم من بيعها وصرفها حتي يشمرو بها هذه السموم القاتلة
و نسرد هنا أمثلة حيّة، لأن الجميع سمع بها وتابع أغلبها على أكثر من منبر، فقط المخزي والباعث على الحسرة، هو كيف يحدث هذا في بلاد إسلامية ووسط شعيرة من أقدس الشعائر، ألا وهي عيد الأضحى المبارك؟!.
ونحن هنا لا نتحدث عن الجريمة في موريتانيا كمفهوم عام، ولكن عن جريمة ذات صبغة معينة وخصوصية نادرا ما تجد لها مثيلا حتى في الدول والأقاليم والقبائل الأكثر بعدا عن الإيمان حتى لا نقول الأكثر كفرا
مثلما حدث هذا في عيد الأضحى، حدث كذلك في شهر رمضان وعيد الفطر وفي عاشوراء وأشهر الحرم وذي الحجة، أي أن هؤلاء الجناة ليسم هناك سلطة تخيفهم أو تصدهم أو تحدهم، بل هم في رحلتهم سائرون من دون هوادة، ولا هدفا مرسوما أمامهم إلا كيفية الحصول على ما يملأ جيوبهم ولو على حساب أرواح البشر.
فعلى الرغم من ملايين الحملات التحسيسية لمكافحة المخدرات والندوات والملتقيات والورشات المقامة لنفس الشأن والهدف، وآلاف الدروس والخطب التي تفضل بها أئمتنا الميامين، إلا أن ذلك لم يضع حدا لهذه الآلة الجهنمية، والتي منذ أن بدأت حركيتها وأشغالها إلا وهي تزداد سرعة من دون توقف، حاصدة المزيد من الضحايا.
هذه المعضلة التاريخية والأولى من نوعها في تاريخ البلد، من المفروض أن تعلن عن نفسها كحالة طوارئ قصوى، وكان لا بد من تجنيد أدق الوسائل والتجهيزات وجلب كل الأفكار من شرقها لغربها، حتى تتمكن الوصايا من محاصرتها والحد منها بصفة نهائية.
وإلا ما معنى هذا ودولتنا الموقرة استطاعت بفضل حرصها ويقظتها الدائمة أن تخرج البلاد من أعسر الأزمات وأخطرها على الإطلاق، وأعادت الأمن وهيبة الدولة كما ظل خطابها يقر بذلك؟، وماذا عن الأمن الاجتماعي؟، ماذا عن الأخطار التي ستبقى أعينها مركزة ومهددة لسلامة الجميع؟، أليس هذا كذلك من أمن الدولة، إذا سلمنا بأن أمن المواطن يبدأ منها؟.
إن ما حرصنا على سمعه هو فعلا جرم فظيع يندى له الجبين ووصمة عار في جبيني الشناقطة ، فكيف ومتى الوصول إلى هذا الأمل المنشود؟، وما هي الآليات الأسرع والتي القصد منها هو بلوغ غاية سلامة الناس وتخليصهم من هذا البعبع المارق؟.
فإن كانت الوصاية بترسانتها المادية والفكرية المعنوية عاجزة حقا عن مكافحة الداء من جذوره وأصله ومرابض تحركه، فكيف لمجرد جمعيات أحياء وأقلام الصحافيين و«ريبورتاجاتهم» أن يخلصوا الجميع منه؟، وإلا فإنه لو حدث أن سُدّت كل المنافذ أمامنا.
سنسلم أمرنا لله ونترك للأقدار أن تفعل فعلتها، ونؤمن بأن البلاء يحدث في كل زمان ومكان وفي كل حين، والله سبحانه وحده مدرك بأسباب ذلك وحلولها، وهو يُبلي من يشاء وفي تلك حكمة يعلمها لدنه....
الياس محمد