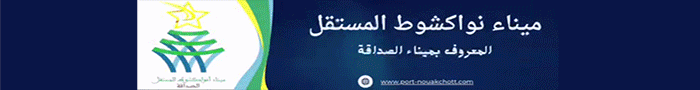في البدء لم تكن كورونا، كانت الفضاءات مفتوحة، والناس يخرجون كيفما شاءوا، يرتادون المقاهي وأشغالهم، تماما كما لو أن الشمس كانت تضرب صفارتها عند الشروق لتعلن مواعيد الخروج، يخرج الناس ليمارسوا الحياة، وسار الوضع على هذه الشاكلة منذ حين من الزمن، إلى أن أطل زمن كورونا برأسه، فانتشر الخوف، وانشغل العالم بوضع لم يكن في الحسبان.
الزمن المنزلي و«متلازمة الكوخ»:
حدث مروع ينشر الرعب والموت في كل يوم، لكن حب البقاء وجمال الحياة لم يَكونا ليُنسَيا بهذه السرعة التي انتشر فيها الوباء من بقعة إلى أخرى ومن دولة إلى غيرها، فمع الخوف بقي نبض حب الاستمرار لغوايات زمن العافية، وذاكرة الكوكب الأخضر، متماشيا مع انقباضة الفزع في الأحشاء، تلك الانقباضة التي لا تذكّر سوى بالموت، وما يخلفه الغياب من لذات ومتع تستمتع بها أجيال أخرى، أو من لم يحن أجله بعد، وهو ما يجعل الإنسان يفكر في الزمن، لا باعتباره لحظات مستقرة محددة يعرف بها أنه مازال حيا، وأن عليه في هذه الحياة واجبات وله حقوق تؤطر هويته المتناهية إلى الموت.
فرضت كورورنا على الإنسان وعيا مختلفا بالزمن، لقد وضعت أمامه سيناريو الموت لا كانتظار يؤجله التسويف، ولكن كواقع حال يتربص به من لحظة إلى أخرى، فأصبح معنى الموت محايثا للحياة، يتماشى مع سيرورتها كالظل، وهذا ما يفسر تمرد الإنسان على معايير السلامة، كالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي والحجر الصحي ووضع الكمامات والقفازات وما إلى ذاك، خصوصا تمرده على عدم البقاء في البيت، لأنه في النهاية، تحديد حركة الإنسان معناه الموت، والبيت يعتبر المعادل الرمزي للتابوت، ولهذا يرفض الإنسان أن يبقى فيه بغير إرادته، فهو مهما كان يرفض أن تدار حريته بأيدي غيره، ولهذا نرى الخروج في أمريكا وبعض من الدول، رفضا للحجر المنزلي، لأنه لا يلبي التعبير النفسي لدى الإنسان في ممارسة الحياة، رغم أن المنزل قد يحتوي على كل ما يحقق الرفاه ويبعد السأم.
لقد ظهرت ما تسمى «متلازمة الكوخ»، وهي إصابة نفسية طالت بعض الأفراد نتيجة الحجر المنزلي، إذ بعد التصريح بفك الحجر، لم يستطيعوا أن يعودوا إلى وضعهم الطبيعي وآثروا الاستمرار في البقاء في البيت، وهو ما يعتبر أمرا غير طبيعي، ولذلك أوصى المتخصصون أنه إذا استمرت هذه الحالة أكثر من ثلاثة أسابيع فعلى المصاب بها أن يزور مختصا نفسيا. فالخارج أصبح خطرا بعد أن كان استمرارا للحياة، إذ خوف الإنسان بعد التوصية، بعدم لمس الوجه أو جهة الأنف والفم، جعله ينكفئ على ذاته ويعين خارج حدود الجسد خطرا، ثم جاء الخطر المحدد بخارج البيت، فأصبح الفرد سجين جسمه وسجين الواقع.
ضوابط الحدود/ وعي الذات والشعور بالانتماء:
إن ما يميز المنزل هو الجدار والسقف، وكلها تعبيرات رمزية عن الحدود التي لا تُتجاوز، فمن يخرق تلك العناصر فقد تجاوز بالمنزل من الستر إلى الفضح، وهو ما يعني أن المنزل قبل كورونا، لم يكن له تصور في خيالنا، فلم نحدد له وجودا وشكلا في تفكيرنا، بالطريقة التي تجعله حاضرا حينما نأوي إليه، فلا يغدو التباسا طبوغرافيا وجماليا، فالعديد من المنزليين في زمن الجائحة، خصوصا في الغرب أصابهم الضيق من المكوث في البيت، لأنه أضاف إلى أعبائهم أعباء أخرى، كالقيام على شؤون الأطفال التي كانت تقع على عاتق المدرسة، وبالتالي يصبح مفهوم المنزل محددا خارج نطاق الألفة والشعور بالعائلة، إلى مفهوم العبء، لأنه ككيانٍ مفقودُ التحديد الجمالي طبوغرافيا ومعرفيا.
أنتج كورونا مجموعة من الهويات التي أخذ الإنسان في التعامل معها وإعادة اكتشافها، منها هوية المنزل، وهوية الموت، وهوية الخطر، وهوية العالم وهوية الانهيار، وهوية المستشفى، وكل هذه الهويات أنتجت علاقات متبادلة بين الخوف من الفناء والرغبة في التجاوز.
تتهيأ أوروبا للخروج الجزئي من حالة الإغلاق، ويتأكد الأمر عبر التنبيه الحكومي المحدد لنطاق الحركة والهيئات محل الفتح الجزئي، فوقع نوع من الترافق بين معنيي البيت والشارع، أي أن البيت يعتبر قطيعة مع الشارع في حالة الخطر، الذي يفرض الانزواء والانكفاء بين الجدران، والشارع الذي يعني في ما يعنيه الشوق إلى الحرية والمشي خارج رواق السقف، فرغم أن الحجر الصحي لا يؤدي مفهوم السجن، لأنه إجراء وقائي يهدف إلى حماية النفس من خطر المرض والموت، إلا أن تحديد حركة الإنسان ولو كانت في بيته تحت أي ظرف، تقع ثقيلة في وعيه الذي يخرج إلى الدنيا في انفصال تام مع المنزل الرحمي، قطع الحبل السري يمثل اللحظة الأمثل للبرهنة على أن الإنسان يتطلع إلى حياة بدون سقف.
إن كورونا لازم الزمن الأرضي بما هو قابل للعطب والانهيار، ولكن ليس ككينونة قابلة للمواجهة، لأن الأزمة الكورونية بقدر ما هي طارئ متوحش، إلا أنها تقع في مسار الإنسان كاختبار لمدى وعيه بإنسانيته، التي رُدمت تحت هدم الوصايا الرصينة للدين والمبادئ الخالدة، أو «مصادر الذات» كما يسميها فتحي المسكيني، فلم تتوافق في البدء طبيعة كورونا الاختبارية وطبيعة الإنسان المتخلية، فكانت الصدمة التي أعادته إلى ذاته جزئيا، لأن في العودة إلى البيت وملازمة الذات والجماعة الاجتماعية الصغيرة، إنما هي عودة إلى الوعي بالفرد في كينونته، القابل للتطور نحو المواطن والإنسان، فالالتزام بضرورات الوضع الوقائي المقررة من قبل السلطات، إنما تعني الشعور بالانتماء للوطن.
مفاصل الوعي الإنساني ووعي التاريخ:
ليس الوعي بتاريخ الإنسان هو ما يفصل بينه وبين الحيوان، إنما تحويل هذا الوعي إلى مفاصل تتحرك داخل الواقع الإنساني وهو يحقق إنجازاته في التاريخ، ولهذا يتفاعل الإنسان مع الطوارئ، التي لا تشكل تهديدا على حياته البيولوجية وحسب، بل على حياته التاريخية، بمعنى أن الهزيمة أمام الشكل الكورورني للحياة المهددة للبشر، هي هزيمة الإنسان في التاريخ الذي يتعطل مفهومه بالنسبة للحركة الإنسانية فيه، إذ يعتبر الإنسان تاريخيا، بمقدار ما ينجزه في مسار التاريخ، وبالتالي فهو محكوم بأن ينتصر على كورونا، ولا يكون كذلك إلا حين يستعيد الوعي بهويته الكونية وعلاقاته بالآخر في ظل الهوية الإنسانية المتبادلة، حيث يكون البحث عن عناصر التوافق مطلبا جوهريا لمواجهة عناصر التحول في كورونا.
أنتج كورونا مجموعة من الهويات التي أخذ الإنسان في التعامل معها وإعادة اكتشافها، منها هوية المنزل، وهوية الموت، وهوية الخطر، وهوية العالم وهوية الانهيار، وهوية المستشفى، وكل هذه الهويات أنتجت علاقات متبادلة بين الخوف من الفناء والرغبة في التجاوز، وبالتالي على الإنسان أن يعي هذه الهويات في تمظهراتها المرافقة لكورونا، ثم يقرأ ذاته في مرآة كل هوية ليكتشف علاقته معها، ومن ثمة يعيد بناء ذاته في ضوء تلك العلاقات، فالبيت قد يصبح في مستوى من مستويات التعايش مع الوضع الوبائي تابوتا حياتيا، ويصبح الموت شبحا أليفا، ويصبح انتظار الإعلان عن انعدام معدل الموت اليومي حالة من النشوة المرغوب فيها، بحيث يتلاشى الخوف المرعب من الموت الجماعي، ويعود شيئا فشيئا التطبيع مع الموت الحتمي «الفردي»، فنكتشف أننا لا نعير الموت اهتماما، إلا بالمقدار الذي يصبح فيه ظاهرة، ومنه نتساءل لماذا لا ننتبه إلى الموت الذي تحدثه الحروب والنزاعات التي يتسبب فيها التوحش الإنساني وطغيان شهوة التسلط والهيمنة؟
٭ كاتب جزائري