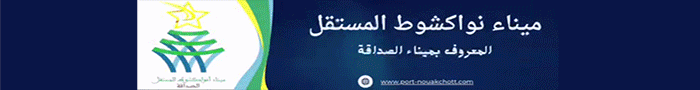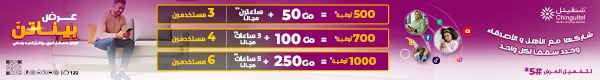إن لم يحصل ذلك اليوم فلم لا يحصل غدا؟ قد يدور في أذهان الكثيرين سؤال حائر حول الوقت الذي سيستغرقه ما يبدو انقلابا جذريا في موازين القوى بين الامبراطورية الفرنسية ومستعمراتها السابقة في الشمال الافريقي، والطريقة التي ستعجل بتحقيق ذلك. ولعل هناك من سيقول بأسى وحسرة متى يحين العصر الذي تهاب فيه فرنسا الليبيين، وتخشى التونسيين، وترتعد عند ذكر الجزائريين، ولا تجرؤ على إغضاب المغاربة، أو المس بأي شكل بالموريتانيين؟
والمؤكد أنه رغم مضي أكثر من نصف قرن على جلاء الفرنسيين عن المنطقة المغاربية، إلا أنه ليس باستطاعة أحد أن يجزم اليوم أن باريس، التي اندحرت نظريا من الشمال الافريقي، باتت تعامل أهله على قدر واسع من الاحترام والتقدير، فضلا عن أن يقر بأنها قد غيرت نظرتها لهم، وصارت تعتبرهم جديرين حقا بأن يعاملوا معاملة الند للند، لا التابع والمتبوع. وسوف لن يكون الجزائريون وحدهم من سيسعدون، إن كانوا حقا هم الاستثناء لذلك، أو إن كان ما قاله رئيسهم قبل أيام في تفنيد جزء من تلك الحقيقة الأليمة مطابقا الواقع.
فكل المغاربيين وبلا استثناء سيشاطرونهم حتما تلك المشاعر، وسيكونون بدورهم بمنتهى الغبطة والاعتزاز، متى ثبت أن فرنسا باتت تحسب بالفعل للجزائر ألف حساب، كما صرح بذلك الرئيس عبد المجيد تبون، في حديث تلفزيوني للصحافة المحلية. لكن ما قد يعكر المسألة قليلا هو الربط الذي حصل لما أراد تبون أن يؤكد في تلك المقابلة لمحاوره، على أن بلاده ليست محمية فرنسية، بين مسألتين متباعدتين، وهما تقدير الفرنسيين للجزائر من جهة، واستخفافهم واستهانتهم بإحدى الجارات المغاربيات من جهة أخرى، إذ بدلا من أن يشرح المسؤول الجزائري الأسباب الحقيقية، التي جعلت باريس تتصرف مع الجزائر على نحو مميز، كأن يعدد مظاهر القوة العسكرية والاقتصادية، أو النفوذ الدبلوماسي أو الثقافي الجزائري، فإنه اختزل كل ذلك في كلمة فضفاضة وهي، أن الفرنسيين يعرفون أن الجزائر قوة إقليمية في افريقيا، قبل أن يستطرد ليضيف بشكل غير متوقع وخارج تماما عن السياق: «نحن لسنا محمية، أنت تتحدث عن دولة أخرى لا يشاورونها أبدا، وتطبق ما يقولونه لها وتسكت» ما جعل كثيرا من التونسيين، بوجه خاص، يعتقدون أن بلدهم هو المقصود بتلك الإشارة، خصوصا أن رئيسهم نفسه لم يتورع وفي مفارقة عجيبة، خلال زيارته الأخيرة لفرنسا في يونيو الماضي، عن الإشارة في حديث لإحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، إلى أن تونس لم تكن أبدا مستعمرة مثل الجزائر، بل كانت محمية فرنسية. لكن ذلك الجدل الذي لم يستمر طويلا وتوقف بسرعة في تونس، ألقى للأسف الشديد الضوء على الطريقة التي قد يفكر بها بلد مغاربي، حين يلجأ إلى عقد المقارنات المختلة مع جيرانه، لمجرد التدليل على تميزه عنهم، والإشارة إلى أنه وحده القادر من بينهم على دفع المستعمر على التخلي في تعامله معه عن منطق الاستعلاء والهيمنة. فهل يمكن لأي قطر مغاربي مهما كان حجمه أو وزنه، أن يعدل من نظرة الفرنسيين له بشكل منفرد، وبمعزل عن باقي جيرانه المغاربيين، حتى لا نقول على حسابهم؟ إن ما زرعه الفرنسيون على مدى عقود طويلة في دول المغرب الكبير، هو ما جنوا ثماره في مراحل مختلفة، من خلال تحول التقسيمات الترابية، التي رسموها إلى مصدر انقسام إضافي بين المغاربيين، وصراعات لا يكاد يتوقف أحدها حتى يظهر الآخر. والوهم الكبير الذي رسخه هؤلاء عن قصد وبسوء نية، هو أن الجزائريين كانوا الوحيدين الذين استطاعوا أن ينتزعوا استقلالهم بالتضحية بأرواحهم، وتقديم أعز ما يملكون، فيما منحت فرنسا الباقين الاستقلال بمحض إرادتها، ومن دون أن تجبر عليه. وهذه المغالطة التاريخية هي التي زادت من تعميق الفجوة، لا بين الأقطار المغاربية فحسب، بل حتى بين الشعوب، وجعلت البعض منها يشعر بنوع من النقص، وربما يشك ويرتاب حتى في تاريخه المعاصر، مقابل إحساس آخر بالتفوق، أو التميز عليه بتضحياته من أجل الظفر بحريته.
أهم درس ينبغي على المغاربيين استخلاصه اليوم وبشكل تام، هو أنهم سيبقون دائما وأبدا بمثابة الجسد الواحد
ومن البديهي أن تبنّي الجزائر لشعارات ثورية، وميلها خلال الحرب الباردة إلى المعسكر الشرقي، كرّس ذلك الوضع، وجعل صورة المغرب الكبير الواحد تبدو مجزءة إلى نصفين، يظهر الأول ثوريا، من خلال النظر للجزائر وليبيا، فيما يلوح الثاني براغماتيا من خلال النظر لباقي الدول المغاربية. وأخطر ما أفرزه ذلك بعد تفكك المنظومة السوفييتية هو ليس فقط عجز المغاربيين عن تحقيق الغرض الأساسي من وراء إعلانهم عن إنشاء الاتحاد المغاربي، بالتوقيع على معاهدة مراكش عام 1989، بل تمترس كل واحد منهم وراء حدوده الوطنية، وفقدان الرغبة والدافع للعمل الجماعي، من أجل فرض الكلمة الواحدة والموقف الموحد من كل القضايا الإقليمية والدولية المعروضة على الساحة. لقد تواصل ما كان يوصف في فترة الحرب الباردة بالمناوشات المحدودة بين المعسكرين الشرقي والغربي على الأرض المغاربية، غير أنه خرج عن إطار المواجهات العسكرية الصرفة، كتلك التي دارت في الستينيات والسبعينيات بين الجزائر والمغرب، أو مطلع الثمانينيات بين ليبيا والجزائر من جهة، وتونس من جهة أخرى، من خلال حادثة قفصة، وتحول إلى صراع متعدد الأشكال، يطغى عليه البعد الإعلامي والدبلوماسي. وهذا ما جعل وجود تكتل مغاربي قوي باستطاعته الوقوف بوجه فرنسا، والتقدم لها مثلا بلائحة مشتركة تتضمن طلبات مشروعة، كالكشف عن الأرشيف المغاربي يبدو أمرا عسير المنال، في ظل احتدام التنافس بين قطبين كبيرين هما المغرب والجزائر، وتشتت باقي الدول المغاربية خصوصا بعد الحرب الأهلية في ليبيا، وتحولها إلى أطراف تدور كل واحدة منها تقريبا في فلك مخالف للآخر. وفي خضم ذلك فإنه يبدو أشبه بالمعجزة أن تتمكن الجزائر، أو أي قطر مغاربي آخر من أن يحوز كل عناصر القوة المطلوبة لتغيير المعادلة بمفرده، ويجبر بالتالي الامبراطورية الاستعمارية على أن تعامله بشكل مختلف تماما عن جيرانه، اللهم إلا إذا استثينا بعض المظاهر الشكلية فحسب. فهل من المنطقي أن يحسب الفرنسيون ألف حساب للجزائر وحدها، وهم الذين دخلوا ليبيا وتقاسموا أجزاء منها من دون استشارتها؟ وهل من المعقول أنهم يضعونها في تلك المنزلة العليا، في الوقت الذي يواصلون فيه التلاعب بالملف الصحراوي، الذي يؤجج الخلاف الجزائري المغربي، ويضعون قواتهم بشكل مريب على مرمى حجر من الحدود الجنوبية للجزائر؟ ثم إن كانوا يملون بالفعل خياراتهم على الجارة المغاربية، التي تخضع لحمايتهم، والتي يفترض أنها تونس، فكيف يحسبون بذلك الفعل إذن لشقيقتها الكبرى ألف حساب؟ إن أهم درس ينبغي على المغاربيين استخلاصه اليوم وبشكل تام، هو أنهم سيبقون دائما وأبدا بمثابة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، حتى إن نسي البعض منهم ذلك، وادعى أنه بإمكانه أن يجبر فرنسا على أن تحسب له وحده ومن دون الآخرين ألف حساب.
كاتب وصحافي من تونس