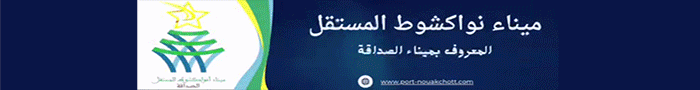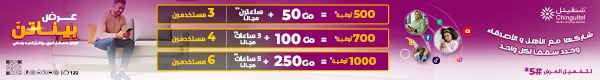من المسلم به أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت شريكا رئيسيا في صناعة الرأي العام، وأداة مهمة في مجال الديمقراطية وحرية التعبير، والسلم الاجتماعي والتنمية الوطنية.
ومنذ عامين حظيت هذه الوسائط في بلادنا بمكانة معتبرة لدى صناع القرار، تجلت في تكليف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لجنة خبراء من مختلف الأجيال الصحفية من أجل بلورة رؤية إصلاحية للقطاع، صادق على حصيلة عملها مجلس الوزراء..
وبسبب هذه العناية أضحت وسائل التواصل الاجتماعي من أهم مصادر الأخبار ومنابر متابعة الأحداث وعرض الآراء والمظالم، وأبانت عن ظواهر جديدة تفاعلت فيها جهات الدولة مع ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي، بدرجة أنه قلما تعلن إحداها خبرا ذا شأن عام إلا ويبادر المرفق المعني إلى التجاوب مع ما ينشر توضيحا أو تصويبا أو تكذيبا، أو تصحيحا؛ وكثيرا ما نقرأ على صفحات هذه الوسائط أن جهة كذا تدخلت، أو أن قرارا ما اتُخٍذَ أو عُدِلَ عنه، بناء على خبر نشر أو تظلم دُوِّن.
ومن غير الممكن نكران هذه الحقيقة المتواترة، أو جحود أنها تعبر بشكل لا لبس فيه عن انفتاح السلطات بشكل إيجابي على هذه الوسائل وعن إفساح المجال لتأثيرها في تشكيل الرأي العام، من جهة، وفي اعتبارها على مستوى، اتخاذ القرارات من جهة أخرى.
إلا أنها تعبر من جانب آخر عن سلبية بالغة إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار ما تنطوي عليه وضعيتها الحالية وقواعد اشتغالها وموجهات منصاتها وحدود تقيدها بما تلزم به أخلاقيات المهنة وتمليه المصالح الوطنية العليا.
وأخشى أن تكون تجربة العامين، في هذا المجال، غلبت حصائدها السلبية على محاصيلها الايجابية، بدرجة تدفع إلى الإحساس بخيبة أمل كبيرة، ليس بالنسبة للجهات التي منحت هذه الوسائط الأهمية والرعاية، وإنما بالنسبة للرأي العام الذي صدَّق كثيرا مما تبثه، وانساق خلف ما تنشره من محتوى جرى التحكم فيه بشكل بدا في معظمه متحيزا وانتقائيا ودعائيا كأنما بصره عمٍ عن غير جانب الكأس الفارغ، وكأن لغته أخذت من إناء لا يرشح بغير مفردات التأزيم والتضخيم والتسفيه والشائعات وإثارة الهلع والتحريض، وإغلاق الأفق وطمس أي صورة تدفع إلى الإحساس بالطمأنينة.
وربما يعود سبب كثير من ذلك إلى أن هذا الميدان استولى عليه أقوام، نحترم لهم أفكارهم وآراءهم وطرائق تعبيرهم، لكننا نأخذ على بعضهم قلة زاده المعرفي وخفة وازعه المهني وتهافته الشخصي نحو الشعبوية والرموزية والشطط في وحل المصالح الخاصة والمنافع الضيقة، بمزاجية حادة متشنجة غالبا ما يجري التعبير عنها بسادية صاخبة تنثر فرقعات صوتية كثيرا ما ينقشع ضجيجها عن زوبعة في فنجان.
ورغم مضي عامين أو أكثر على هذه التجربة، فإن من الصعب تلمس أي تطور يشي بتحسنٍ، لا في أسلوب التعبير ولا أفق النظر، ولا بما يستوجبه التحليل الموضوعي لحركة الواقع ولو من زاوية المقارنة بين الطموحات المشروعة، وبين المعطى الاقتصادي المعاش، ولا بدراسة الظروف المحدِّدة لإمكانية وجود نسق تقوم فيه علاقة عادلة بين الضغط السكاني، والموارد المتاحة وطرائق توزيع الثروة.
وعوضا عن ذلك تعزز الجنوح نحو النفق شبه المسدود كلما ازدادت هيمنة “صحافة المواطن” على بقية مفردات الوسائط الأخرى، وتمكّنت من بسط سلطة قمعٍ الكتروني عنيفة أرهبت النخبة الثقافية والإعلامية وحَيَّدَتْها وحشرتها في وضعية "الصامت"، مما قوض مسوغات الآمل في أن تقوم هذه الوسائل بدورها في محاربة الفساد والقيم الفاسدة ؛ وإرساء القيم الإيجابية كالولاء للوطن والانتماء للمجتمع والمشاركة الفاعلة في بنائه وتعزيز لحمته وحماية وحدته، إلى جانب تكريس الوعي بأهمية الالتزام بضوابط حرية التعبير وقواعد العمل الإعلامي وأخلاقيات مهنته.
بيد أن خيبة الأمل هذه لن تهز قناعتنا الراسخة بأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي وحاجة المجتمع إليها. لكنها تدفعنا للدعوة إلى إعادة تصويب مسار هذه الوسائط وتقنين أساليبها بما يبعدها من أن تكون مجرد محفظة سب وقذف وتوتير وهدم وشقاق..
ولن يكون لذلك سبيل ما لم تندمج فيه جهود كافة النخب الثقافية والإعلامية، بشكل مباشر لا تردد ولا تقاعس فيه، وما لم يصبح الجسم الإعلامي مهيئا لأن يقول لمن خالف الضوابط وخرج على القانون أخطأت وأسأت وعليك أن تتحمل وزر ما اقترفت، مهما تكن درجة العلاقات الشخصية أو مستوى التضامن المهني، وأيا تكن درجة المعارضة للجهات التي أنيط بها واجب حفظ الأمن الوطني أو تطبيق القانون
أحد الأطر الداعمة للرئيس غزواني