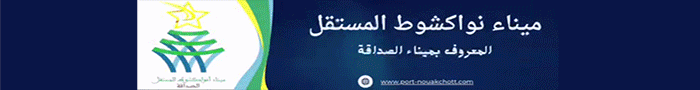الفضول العلمي والمعرفي فطرة مركوزة في الذات الإنسانية، وعلى هذه الطبيعة نشأ الإنسان وتربى واستمر في حياته البحثية، وقد دأب على البحث والتنقيب والاستقصاء عن حقائق الأشياء وماهياتها، من غير سأم ولا ملل ولا فتور، وواظب على ذلك جاهدًا نفسه في حركة موصولة، واستطاع أن يترقى بعقله إلى مدارك عليا من التبصّر والإدراك، وتمكّن من تجاوز حُجب الغيب بفكره وإدراكه للمعقولات، من الأشياء التي هي من عوالم التجريد، باحثا مستقصيا عن حقائق الوجود، وماهيات الأشياء والموجودات في العالم الميتافيزيقي (عالم ما وراء الطبيعة)، وهو العالم الذي تحكمه قوانين فيزيائية غير القوانين التي تحكم العالم الفيزيقي (عالم المادة المحسوس).
والعالم الفيزيقي هو العالم الذي ندركه بحواسنا، ويقع تحت إدراكنا المرئي، ونختبر مادته وطاقته وحركته وتفاعلاته وأحجامه وكتله وأبعاده بمعاييرنا العلمية، وهي المعايير التي ابتكرها الإنسان من نظم الحياة، وقوانينها ونواميسها المدرَكة بالتجربة والبرهان المادي، وقد شكّل البحث في هذا القسم اهتماما كبيرا، بالتفكير في علل الموجودات وحركاتها، وفي الأسباب التي أدت إلى وجود هذا العالم المادي بكل عناصره وأبعاده وتفاصيله.
ووجودُ العالم الميتافيزيقي وراء المادة، خلق إشكالية مفهومية في البحث الفلسفي الماورائي، إذ لم يستطع الفكر الإنساني أن يضع له تصورا محسوسا كما وضع تصوراته لعالم المادة المرئية، التي جرد منها معاني موجودة متعقّلة بالتفكير والإدراك، وليست لها صور خارجة عن الحيّز الذهني، ولكن حقائقها وماهياتها المجردة، مستوحاة من الصور الحسية المرتبطة بعالم الأشياء المدرَكة، وعدم إدراك العقل الإنساني للعالم الميتافيزيقي حسيا، خلق له مشكلة مفهومية جعلته يشك في حقائق وجوده، وعلى هذا انقسم البشر إلى قسمين، الأول: وهم الأكثرية من المؤمنين اعتمدوا على الوحي ورسالات الأنبياء والرسل، فتشكلت من هذه الرسالات الفلسفة الروحية (الأديان السماوية)، وقد صورت عالم الغيب تصويرا دقيقا، باستخدام قياس التمثيل الحسي.
والقسم الثاني من البشر: وهم الفئة اللاأدرية، والطبيعيون الماديون، ممن اختلت لديهم موازين التفكير والإدراك، ووقفوا حيارى بين الإيمان والتكذيب ثم استقر رأيهم على الإلحاد، وقد فسَّروا مظاهر الطبيعة والحياة تفسيرا ماديا بحتا، واعتبروا التفسير الروحي للغيب خرافة ابتدعها عقل الإنسان القديم في مراحل ضعفه وبؤسه، حين كان يواجه قساوة الطبيعة وآلام الجوع والأسقام وظلم المستبدين، ولما عجز عن المواجهة اخترع عالما مثاليا كي يتخلص فيه من البؤس والظلم والآلام، ويسعد فيه بطيب العيش ولذيذه، ولكنّ الفلاسفة المؤمنين استدلوا على وجود الله بالدليل العقلي المركّب كدليل الإمكان ودليل الوجوب، الذي استعمله الفلاسفة المسلمون ومن جاء من بعدهم من فلاسفة الغرب، وهو الدليل الذي يقوم على المقدمات التي أساسها البديهيات العقلية، كوجود الإنسان الذي اعتبره ديكارت مقدمة بديهية، لا يمكن أن نبرهن على وجودها، أي: على وجود الإنسان، لأنه موجود حقيقة وليس من طريق الوهم أو الخيال، موجود بجسمه وعقله وفكره وإدراكه وإحساسه وحركته ونشاطه، ومن الإنسان كحقيقة أولية بديهية، ركب ديكارت دليل الوجوب الذي استدل به على وجود الباري سبحانه.
الاستدلال بالمنهج التجريبي:
والطبيعيون ومنهم علماء الأحياء كالدارونيين مثلا، يعتمدون على المنهج التجريبي، الذي يتخذ عناصر الطبيعة في تفسير الحقائق والظواهر والإنسان والعقل والإدراك والحياة، وهم لا يؤمنون بالأدلة العقلية التي استعملها الفلاسفة المؤمنون، وسبيلهم الوحيد في إثبات الحقيقة هو المنهج التجريبي الحسي، الذي وضع أسسه جون لوك.
ولهؤلاء المفكرين أصلٌ يعودون إليه في نزعتهم الطبيعية، إذ تأثروا بالفلسفة الطبيعية والمادية التي انتشرت في اليونان على أيدي الفلاسفة الطبيعيين والأبيقوريين بخاصة، فهم يؤمنون بالمنهج التجريبي الذي يُثبت حقائق الأشياء والماهيات حسيا، وكان أستاذهم في انتهاج النزعة الطبيعية، الفيلسوف اليوناني أبيقور، الذي ارتكز في فلسفته على المبدأ الذري، إذ لا وجود عنده لعنصر الروح المنفصلة عن المادة، فهو يرى بأن المادة هي التي تملأ الكون كله ولا شيء غير ذلك، والمبدأ الذري الذي آمن به استوحاه من فلسفة ديموقريطس الذرية، التي أسسها من قبل.
وكان أبيقور يرى بأن الأشياء كلها مكونة من الذرات، ومذهبه الذري هو الذي بنى عليه منهجه الفلسفي، والذرات -في زعمه- تختلف في شكلها ووزنها لا في كيفيتها، والنفس الإنسانية ليست إلا تكوينا من الذرات تتلاشى عند الموت، وكأنه أراد أن يقول: إن النفس هي حركة وظيفية داخلية للجسم، فإذا انتهى الجسم بالموت فنيت ذرات تكوينه وانتهت من الوجود، وعلى هذا المبدأ الفلسفي المادي بنى الملاحدة الطبيعيون فلسفتهم حول الوجود ونفي الغيب، ولذلك نفوا وجود العقل والروح، إذ اعتبروا العقل وظيفة الدماغ وحسب، وإقرارهم هذا النفي للروح والعقل كماهيات منفصلة عن الجسد، إنما كان لأنهم يريدون نفي وجود الله والجزاء والجنة والنار والخلود في عالم ما وراء المادة.
يقول أبيقور: إن الإنسان مُلِئَ خوفًا من الله ومن العقاب على أعماله، ومن الموت بسبب ما قيل عن الحياة بعد الموت، وهذا الخوف أكبرُ منغص لحياة الإنسان ومضيِّع لسعادته، فإذا ذهب الخوف تخلصنا من أكبر عائق يعيق السعادة، ولا وسيلة إلى إزالة هذا الخوف إلا بدراسة الطبيعة، وفهمنا أن هذا العالم آلة ميكانيكية، محكومٌ بأسباب طبيعية لها نتائجها الطبيعية، وليس فيه كائنات فوق الطبيعة، والإنسان في هذا العالم حرّ، يبحث عن سعادته حيث كانت وكيفما يريد، وهو حر الإرادة -عكس ما يقول الرواقيون- ووظيفة الفلسفة أن تعين على تحقيق سعادته في هذا العالم.
والفلاسفة العقلانيون المؤمنون، هم الذين تضاعف اهتمامهم حول البحوث الفلسفية الماورائية، إذ بحثوا في العالم الميتافيزيقي بعقولهم المجرَّدة، واستعانوا على إثبات حقائق الميتافيزيقا بالأدلة العقلية المركَّبة، التي انطلقوا بها من تأمّلهم العميق لنظام الكون البديع، وما فيه من خلق للحياة والإنسان والعقل والتفكير والإدراك، وهو الخلق الذي يدلّ على أن وراء هذا الإتقان العجيب، علّة موجودة بذاتها فوق المادة، مفكرة عليمة حكيمة قديرة تتصف بالكمال المطلق، وهو (الله جلّ ذكره)، وأول من أثبت هذه العلة الحكيمة هم فلاسفة الإغريق، (سقراط أرسطو أفلاطون)، ممن يسمّون “الفلاسفة المؤلهة”، ثم اقتفى أثرَهم فلاسفة الأفلاطونية الحديثة، ثم الفلاسفة المسلمون ثم بعض الفلاسفة الغربيين الكبار، وهؤلاء الفلاسفة وإن اختلفوا في مناهج الاستدلال الجزئي، إلا أنهم اتفقوا على أن الأدلة العقلية المركّبة، هي الأدلة التي تثبت حقيقة الميتافيزيقا، وهي دليل الإمكان والوجوب، الذي وضعه الفارابي أوّلا.
وقد دحض الفلاسفة فكرة تسلسل العلل من بعضها بلا نهاية، كأن نقول: من خلق هذا ومن خلق هذا وسيبقى السؤال بلا نهاية، لأن التسلسل اللانهائي ينتج عنه استحالة عقلية، إذ إن التسلسل اللانهائي في نشوء العلل من بعضها يتعارض مع القوة العقلية المركوزة فيه فطريا، وهي القوة التي يركِّب بها الأدلة المستدَل بها على الأفكار الكلية المجردة التي لا صور لها في عالم الحس، ومنها ينطلق في البرهان على صحة الفرضيات وحقائق الأشياء والموجودات الغامضة، والأفكار القيمية التي تبنى عليها الأخلاق وقيم الفضيلة والخير والجمال.
بعرض برهان هذا الفيلسوف العقلاني الرياضياتي الكبير، أكون قد لخصّت الكلام عن أدلة فلاسفة الغرب المؤمنين بالله، وهم فلاسفة كبار يعود الفضل إليهم في بناء أسس الفلسفة الحديثة، واختراع نظريات جديدة في الرياضيات والفيزياء، وابتكار بعض المنتجات الصناعية والتكنولوجية، وهؤلاء ليسوا دراويش متنطعين متسكعين أو أنصاف متعلمين متظاهرين، أو أدعياء علم وفلسفة مقلدين.
وأحسن دليل عقلي مركّب أسوقه، هو دليل الفيلسوف الألماني الكبير (غوتفريد فيلهيلم لايبنتز: (1646-1716)، وهو فيلسوف ورياضياتي وعالم طبيعة وسياسي، أخذ لايبنتز شهرته في الرياضيات والفلسفة، بما أسَّسه في علم التفاضل والتكامل في الرياضيات، وكان مستقلا في نظرياته عن إسحاق نيوتن، وبقيت الرموز التي وضعها في الرياضيات تُستخدم بشكل واسع بعد أن نُشرت في المحافل العلمية، وقد استنتج بعقله الرياضياتي والفلسفي الناقد أن الكون هو أكمل خلق الله إبداعا ونظاما وتصميما، ولذلك لا يمكن أن يوجد أكمل منه، وقد أسس هو وديكارت وسبينوزا منهج الفلسفة العقلانية في القرن السابع عشر، وكان منهجه الجديد في الفلسفة منطلقا للمنطق الحديث والفلسفة التحليلية، ولكنه مع ذلك التجديد إلا أنه كان متأثرا بالنزعة العقلية للقرون الوسطى، التي كان الاستدلال فيها قائما على الأفكار العقلية البديهية، وليس على الدليل التجريبي الذي يميل إليه الطبيعيون.
كان لايبنتز في تفكيره الفلسفي، على مذهب ديكارت، في اعتبار الأفكار الفطرية جوهر البرهان والاستدلال على وجود الله، ولكنه كان يعارض جون لوك في اعتبار عقولنا عبارة عن لوحة جرداء بيضاء لا تأتيها المعارف والأوليات الفطرية إلا من التجربة، وقام باختبارات على العقل البشري فأتى بنتائج حاول أن يوفّق برأي وسط بين ديكارت ولوك، فقال: إنه لا يمكن أبدا أن نفسِّر المعرفة حين نسندها إلى التجربة وحدها، فالتجربة ليست كل شيء في المعرفة كما زعم لوك، ولكن يوجد فينا معارف ضرورية كلية، أسمى من التجربة ولكن تكشفها التجربة، أي: إن هذه الحقائق الأولية الضرورية موجودة في عقولنا بالفطرة والقوة، ولكن لا نستطيع اكتشافها إلا بواسطة التجربة.
وبعد أن أكد لا يبنتز الأفكار الفطرية الأولية، أي: المبادئ العقلية الضرورية، وهي الأفكار البديهية التي تدرك بداهة، لأن معناها مدرَكٌ بالعقل ضرورة لبساطتها ووضوحها، عقلا، استخدم الأدلة ذاتها التي استعملها فلاسفة المسلمين، وديكارت ولوك، ولكنه كان أبرع في صياغة دليله بصياغة دقيقة واضحة تدل على إثبات وجود الله تعالى، فقال: إن كل حقيقة عقلية يقررها العقل إثباتا أو نفيا لابد له أن يعتمد في إثباتها أو نفيها على مبدأين عقليين ضروريين وهما مبدأ التناقض ومبدأ العلة الكافية، وإيضاح ذلك أن كل ما نتصوره لابد أن يكون ممكنا أو مستحيلا أو واجبا، وكل شيء يوجِب تصوُّرُ وقوعه تناقضا عقليا فهو مستحيل، وكل شيء لا يوجِب تصوُّرُ وقوعه تناقضا عقليا فهو ممكن، وكل شيء يوجِب تصوّرُ عدم وجوده تناقضا عقليا فهو واجب.
على هذه المبادئ العقلية (الأدلة العقلية المركبة)، بنى لايبنتز دليله على أن فكرة وجود الله العليم القدير، هي فكرة ممكنة عقلا وليست مستحيلة على الإدراك، أي: إنها لا توجِب تناقضا عقليا، وبعد أن برهن على وجود الله عقلا برهن على أن الخلق من العدم ممكنٌ ولا يوجب تناقضا عقليا، وإن كان العقل يكلّ في تصور ذلك، لأن الخلق من العدم بعيد عن تجاربه الحسية.
كذلك كل واقع نشاهده، لابد على أساس قانون العلة الضروري أن تكون له علة سبّبت وقوعه، ولا بد أن تكون هذه العلة كافية لوقوعه، والقول بعدم وجود علة كافية لوقوعه يوجب تناقضا عقليا، وعلى أساس هذين المبدأين، مبدأ التناقض ومبدأ العلة الكافية، يمكننا معرفة الممكن ويمكننا تعليل الواقع، فلكي نحكم بإمكان حصول شيء يكفينا أن نتساءل على أساس مبدأ التناقض، هل يستلزم تصور حصوله ووقوعه تناقضا عقليا أم لا؟ فإن استلزم تصور وقوعه تناقضا عقليا حكمنا بأنه مستحيل، وإن لم يستلزم تصور وقوعه تناقضا عقليا حكمنا بأنه ممكن، ولو كان العقل يستبعده أو يكلّ ويعجز عن تصوره، كذلك لكي نحكم بتوجّب وجود شيء نتساءل هل يوجب تصور عدم وجوده تناقضا عقليا أم لا؟ فإن أوجب عدم تصور وجوده تناقضا عقليا حكمنا بأنه واجب الوجود وإلا فلا، وبعد هذا ننتقل إلى الواقع المشاهد فنرى على أساس مبدأ العلة الكافية أنه لابد لهذا الواقع من علة لوقوعه، ولا بد أن تكون هذه العلة كافية لوقوعه، فوجود العلة الكافية إذن أمرٌ واجب عقلا، وإنكار هذه العلة الكافية يوجب لنا تناقضا عقليا لأنها من نوع الواجب.
بنى دليله على وجود الله بدليل عدم التناقض:
على هذه المبادئ العقلية (الأدلة العقلية المركبة)، بنى لايبنتز دليله على أن فكرة وجود الله العليم القدير، هي فكرة ممكنة عقلا وليست مستحيلة على الإدراك، أي: إنها لا توجِب تناقضا عقليا، وبعد أن برهن على وجود الله عقلا برهن على أن الخلق من العدم ممكنٌ ولا يوجب تناقضا عقليا، وإن كان العقل يكلّ في تصور ذلك، لأن الخلق من العدم بعيد عن تجاربه الحسية، ثم انتقل إلى العالم المشاهَد (الكون)، فبيّن أنه عالم مشاهَد بالحس والمعاينة والتجربة، وهو بكمال صنعه وتصميمه ونظامه وجماله لا يمكن أن يوجِد نفسه، لأن القول إنه أوجد نفسه ذاتيا اتفاقا وصدفة يوجب تناقضا عقليا، وحيث إنه موجود حسيا فلابد له من علة كافية لوجوده، لأن وجوده بدون علة كافية يوجب تناقضا عقليا، ومادام موجودا بهذا النظام العجيب الغريب إلى درجة الكمال، يَلزم ذلك أن تكون العلة التي أوجدته كاملة العلم والقدرة والحكمة، وهذه العلة كاملة الصفات هي الله الواجب الوجود بذاته، لأننا إذا فرضنا عدم وجوده يوجب ذلك تناقضا عقليا، لأن الموجود يوجب أن يكون له موجِد.
وبعرض برهان هذا الفيلسوف العقلاني الرياضياتي الكبير، أكون قد لخصّت الكلام عن أدلة فلاسفة الغرب المؤمنين بالله، وهم فلاسفة كبار يعود الفضل إليهم في بناء أسس الفلسفة الحديثة، واختراع نظريات جديدة في الرياضيات والفيزياء، وابتكار بعض المنتجات الصناعية والتكنولوجية، وهؤلاء ليسوا دراويش متنطعين متسكعين أو أنصاف متعلمين متظاهرين، أو أدعياء علم وفلسفة مقلدين