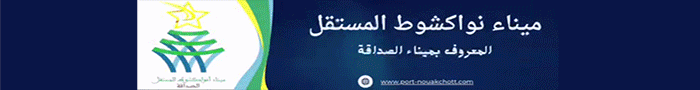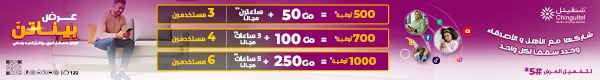لم يكن ولد الغزواني هو الرئيس المرتقب بعد 27 سنة من التعددية ومن النضال من أجل التناوب، وبصفة أساسية عقب مرحلة الشطط التي ترأسها ولد عبد العزيز والتي تتطلب إصلاحا عاما وحازما حيث تم العبث بكل الرهانات والتحديات الأساسية لنظام الدولة الوطنية، وتسجيل مستويات تراجع عميقة بالنسبة للمفاهيم العامة وللإدارة والقانون والتسيير وقلب معايير النجاح في المجتمع والدولة من روح التضحية والمثابرة والنبوغ والخبرة إلى الصدفة والزبونية والقبلية والعلاقات المشبوهة بأصحاب المراكز والنفوذ. وهكذا صار العلم والتعلم مضيعة للوقت في بلد ينجح فيه عادة الأقل تعليما ومؤهلات وحتى أخلاقا. أما بالنسبة للديمقراطية فقد أحرزنا تراجعا حادا لم يكن بمجهوده وحده بل بمجهود قادة المؤسسة العسكرية الذين آزروه ضد عرسين ديمقراطيين بديعين بما يحملانه من طموح طافح نحو حكم مدني يصبو إليه الشعب من أعماقه (2008-2019) ولا يدري أحد هل توصلوا لتقييم موضوعي بشأن آثار ذلك المجهود السلبي وانعكاسه على المستقبل أو لقناعة بتصحيحه قبل أن ينقلب على البلد!. كانت الأمور تتجه نحو الذروة في كل شيء: نفاذ صبر الفئات المهمشة الواقفة عند نقطة فقدان الأمل والثقة في الدولة، وتزايد مستويات الحنق الإثني وخواء الروح الجمهورية: أي تلاشي مشاعر الانتماء والجد في الخدمة العمومية وكذلك روح الإصلاحات والقوانين التي تعطي للمواطن الإيمان بالدولة الوطنية وحرمة مؤسساتها وقراراتها وتوجهاتها كذات فعلية للإصلاح ولتسوية المشاكل و توفير الحلول المطلوبة، أي دولة بلا جوهر. ولهذا ظلت سلسلة التعديلات الدستورية والإصلاحات في الخدمات والسياسات القطاعية غير فعالة ولا وظيفية،لأنها لا تحمل أي رسالة ولا تخاطب المواطن، كما تم تفكيك آخر الرموز التي كانت تعطي شعورا موحدا بالانتماء للدولة مثل العلم والنشيد الذين رافقا النشأة، وكذلك تم شطب غرفة دستورية كانت تلعب ثلاثة أدوار مهمة في ملف التوازنات الإجتماعية المتفاهم عليها ضمنيا: تنويع التمثيل، وطريقة الإنتخابات، وخلق توازن القوى داخل المؤسسة التشريعية، رغم أن كل ذلك لم يكن مطلبا عند أي أحد من الطبقة السياسية وكانت مزيته الأساسية أنه قلل مخزون الثقة في الرموز الوطنية وأرجأ فاعلية الديمقراطية. وبشكل أكثر تدميرا تم التراجع في الخطاب السياسي عن نمط الثقافة الوطنية الواحدة المبنية على اللغة الأم، وهي التي تحددها الدولة، وهو النمط الموروث عن الإستعمار الفرنسي، إلى النموذج الإنجلو ساكسوني: ثقافة المجموعات أو القوميات داخل الدولة الواحدة. وقد صار جنوح مثقفي المكونات الإجتماعية له بادٍ للعيان بسبب فشل النموذج الأصلي وليس لنجاح الآخر، وهو ما يشكل في الأساس إحدى أكبر صور تجليات الانفصام الاجتماعي دون أي محاولة تصحيح أو إعادة بناء المفاهيم ولا المناهج المدرسية خاصة أثناء غياب التعليم الأساسي الجمهوري، وبالفعل قاد كل ذلك إلى انكسار خطوط التوافق أو تعدد الاتجاهات الرامية إلى التمايز في المجتمع والتقليل من أهمية تاريخ وجغرافية البلد، فليس هناك أي شعور بالعزة ولا بالفخر عند الحديث عن محطات من تاريخ البلد القديم أو الحديث على أساس أنه تاريخ أشخاص أو مجموعات، ولا بالنسبة للجغرافيا حيث لا يوجد أي تفكير ولا رؤية استراتيجية لجني المصالح المتطورة من مسألة الموضع الثابت ولا الموقع المتحرك، وكأنه بلد من دون نخبة ومن دون عمق أو أبعاد، يختزل التفكير في لون البشرة وجردة الحساب للوقوف عند الفرص الضائعة وإلزام الأجيال الحالية بدفع فاتورة متشعبة، أو البحث عن الحلول بواسطة التسلق في أنظمة بائسة من صناعة الصدفة أو السطو المسلح على السلطة، بل في أشخاص بعيدين كل البعد من النبوغ والإلهام، وكأن القدر يختار لنا دائما من القاع. وعلى هذا الأساس أخذت الاختلالات تستهدف جوهر الحياة الاجتماعية خاصة اللحمة، وأخذت نقاط الثقل والارتكاز في الدولة والمجتمع تصاب بالوهن، كما لو أن الموت يتسلل إليها لتتحلل من الجسم الواحد إلى مكونات مختلفة الله وحده يعلم كيف ستكون. ولهذا صارت حتمية التغيير أو الإنهيار واقعية، أي بصفة أساسية ضرورة إعادة نفخ روح ودم جديدين في القوانين والقواعد التي تحكم البلد وبناء المفاهيم والأساسات الفكرية والنظرية للتعايش، أي بمعنى صب قوالب ونقاط إرتكاز جديدة تُشعر الكل بالأمان والرضا ولو على مستوى التصورات، بواسطة الفرص المتاحة حاليا والآئلة للانكماش غدا، وإلا فستجد الفوضى أو العنف طريقهما؟. لقد ظل البلد في النصف بين الطريقين لبعض الوقت، لكن تسارع الأحداث التي لا يِـُطرح الحساب لعواقبها جعلته يتدحرج عن الطريق العقلاني والآمن نحو الطريق الآخر.
وللأسف الشديد، لم تُفهم الانتخابات الماضية على أي مستوى في سياقها الطبيعي من أنها فرصة للعودة بالبلد لإدارة الظهر لطريق التمايز هذه والحصول على ضمانات على المستقبل، ليس من حيث الروعة والجمال، لكن بتدشين طريق الإنفتاح على كل النتائج في المستقبل مهما كانت درجة مفاجأتها أو صعوبة تقبلها، وذلك لأن نظام المساواة وتكافؤ الفرص بدأ يعمل، وذلك أجود ما في الديمقراطية، وعلى ذلك كان الترشح للرئاسيات الماضية بصفة أساسية يستدعي الوعي الكامل بتحقيق ذلك الهدف الوطني الكبير، ولم يكن مجرد إسداء خدمة لرئيس مكلوم بفقدانه منصبا تعود أن يلعب منه دور الملك من دون أية تقاليد، والبقية معروفة، ولا لتفعيل دستور ميت بالمشاركة في استحقاق لا يساهم في رفع تحدي موت الاستقرار.
لم يكن ولد الغزواني بأي وجه رجل مرحلة ما بعد ولد عبد العزيز لما تتطلبه من إصلاحات مؤلمة تستأصل الوجع الذي تمثل تركة ولد عبد العزيز ورمه الكبير، بل لم يكن يملك الرغبة على الإطلاق أو الطموح في المشاركة في هذا الاستحقاق على هذا النحو، ولم يشارك فيه إلا قبل أربعة أشهر من انطلاق الحملة الإنتخابية في إطار اتفاق بين شخصين وفق شروط أقرب للإذعان (حماية العودة أو الحكم بالنيابة)، وليس بدوافع الوعي أو الإحساس بالمسؤولية انطلاقا من دقة الوضع، بل وعلى جانب من تسلية النفس بـ"استمرار النهج" وتمجيد الإنجازات أو تزيين الخراب على الأصح، والابتعاد عن التطلعات العامة للناخبين نحو "التغيير والإصلاح" الذي تلتف حوله أغلبية الشعب الموريتاني مهما اختلفت مواقفهم في الانتخابات. وهذا هو ما يميز الشرعية السياسية على نحو صريح بالنسبة لأي رئيس يريد أن يحكم البلد في هذه الظروف، وهو أيضا أكبر تعقيد واجهه وسيواجهه ولد الغزواني طوال مأموريته أو سيدفع به للترجل وسط الطريق، وبمعنى أدق أن يكون، أو أن لا يكون. وقد يحرز في بنيات طريقه لأن يكون عطية سخية من معارضة ظلت حازمة وراسية ضد سلفه، من يدري ! كان التعقيد الثاني والجوهري هو كيف غابت المشروعية على نحو مذهل عن هذا الإستحقاق، وقد كان أسوأها النتيجة الصادمة التي وُجهت لمشروع التغيير في البلد خلال ذلك الإستحقاق بنتيجة 17% وبقاء 48 % بعد جميع محاولات تعديل النتيجة على خط رفضها لها تماما وبانسجام، خاصة بعدما لم تلتزم أي جهة بالحياد كما يفرضه القانون، بل تدخلت كلها لتعديل رغبة الناخبين بالتواطؤ وبالخداع، ولم يمنع اليمين ولا القانون ولا واجب التحفظ أي أحد من أن يقوم بالدور المطلوب منه بالضبط بالنسبة لشروط تعديل نتيجة الإنتخابات لمصلحة الطرف الفائز. وهكذا نجحت كل الأمور التي ظل البلد بحاجة لتغييرها: نفس السيناريو، نفس الوجوه والبزات، نفس النظام، نفس الميكانيزما ونفس النهج، أي فتح سجن ابروتوكولي للرئيس الجديد ووضعه فيه، ومع ذلك ظل الأمل معقودا على إمكانية انتفاضة غزواني من الأسر وتطوير الخطاب والأدوات بالنسبة لأكثر الذين تركوا مواقعهم في المعارضة أو في السبات السياسي وراهنوا عليه رغم أنف الوقائع والأحداث التي تدفع بذلك للتجلي والسطوع. وقد صار من الممكن بعد تصريح الناطق الرسمي، الأسبوع الماضي، بأنهم امتداد لنظام "فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز " القول بهذه السرعة أنهم قاب قوسين أو أدنى من خيبة الأمل في تحقيق ذلك. لقد أضحى ولد الغزواني في نفس صورة الرجل الثاني دائما، وإلى اليوم لم يتمكن من وقف طبول التغني بإنجازات ولد عبد العزيز على التلفزيون الرسمي وكأن مسيرة عشر سنوات من الدعاية عن الرخاء والإنجازات ومحاربة الفساد عن صديقه لم تشف غليله رغم أن الحصيلة كانت مسارا مقززا من الفساد وبطالة ضاربة بجذورها في الشباب وفقرا مدقعا وهدما للطبقة المتوسطة في المجتمع وديونا تنوء بها الدولة، والتهام كل خيرات البلد، وأوضاعا اجتماعية واقتصادية وسياسية على نحو من السوء يفوق الوصف. وعلى ذلك يقاس التعليم والصحة وكل شيء. وهكذا صار الخطاب الذي يبعث بالأمل ويجعل الأغلبية تصطف خلف النظام من داخل استمرار النهج ضربا من العبث، أو نمطا من إيديولوجيا بالية لم تعد تقنع ولا تجذب أحدا، ومع ذلك يتم إعلانه استمرارا لها، يالصدمتهم!. لم يساعد تصريح الناطق الرسمي للحكومة ولد الغزواني في إخفاء موقعه لبعض الوقت، ومع ذلك لم يكن تصريحه أقل مسؤولية من الحفاظ على نفس جهاز التنصت على المواطنين والإبقاء على وزراء من البطانة الشخصية لولد عبد العزيز شاركوه بمواقف واطئة. كان التعقيد الثالث بالنسبة لولد الغزواني هو تعديل شرعية نظامه لكي يحظى بدعم التيارات الشعبية والفكرية، ويلبي في طياته طموح الشباب، ويأخذ على عاتقه رفع الرهانات بالنسبة لمجتمع صغير وسط مجتمعات أكبر، أو غني وسط الجياع. إنها محاولة كسب الرهانات الداخلية من أجل ضبط التسيير الخارجي أو الوضع الجيوبولوتيكي، لكن الدعاية العامة التي صاحبت تثمين غزواني أثناء الحملة الإنتخابية الماضية بكونه الرجل المناسب لكسب الرهان الأمني، اختزلت كل مشاكل البلد في هذا الملف، وهذا هو التعقيد الكبير الذي قد يعصف به، فرغم المغالطة الكبيرة التي تم الترويج لها بتلك الدعاية، فإن المقاربة الأمنية المعتمدة بالنسبة لدول الساحل والصحراء اعتمدت بالمقلوب، ذلك أن المشكل الأساسي في المنطقة مشكل اعتراف ومعاش: سياسي وإقتصادي، أي أن أكبر دوافع ودواعي عدم الإستقرار مرتبط بالأزمة السياسية وبالوضع الاقتصادي، فليس التحدي الأمني هو جوهر المشكلة لأي من بلدان الساحل الخمسة، بل الجوع والتهميش وسيطرة الأجانب على الموارد، وبالنسبة لموريتانيا فإنها توجد ضمن تحالف دولي واسع يراقب وضع وحدات قتالية معزولة في شمال مالي، أي أن الأوضاع المزرية (من بطالة وجوع ومرض وجهل بسبب فشل السياسات، وبسط سلطان الظلم والأوامر والتعليمات بدل القوانين والإجراءات، وتحويل الأملاك العمومية لملكيات خاصة، وسد الطريق أمام التناوب خاصة عندما يكون ضروريا) هي الخطر الحقيقي الذي يواجهه البلد وتواجهه البلدان الأخرى، ولذلك يتم صرف النظر إلى المقاربة الأمنية بالشكل الخاطئ والمتعمد بتعلة كسب الرهانات الإقتصادية والاستقرار لكي تستمر الدول الكبرى، صاحبة المقاربة، في السيطرة على موارد البلدان الضعيفة كما تفعل فرنسا في إفريقيا والولايات المتحدة في العالم العربي وإنجلترا في آسيا، فلو حصل النيجر مثلا على دخل معدن اليورانيوم في امروورن الذي تستغله فرنسا، بل تحافظ به على المرتبة الأولى عالميا في مجال الطاقة النووية، لم يبق النيجر في المرتبة الأخيرة في العالم من حيث الفقر كما أنه منذ معركة آصاغ إمبك 1905 حكمت فرنسا على تهميش سكان شمال مالي إلي اليوم . لم يكن ولد الغزواني ليفهم ذلك مبكرا لأنها استراتيجية عالمية تعود إلى النظر إليها من الزاوية العسكرية، لكن أوردغان عندما أراد أن يقف في وجه زخم حرب الخليج، برفض استخدام طائرات التحالف لأجواء تركيا لضرب العراق، تذرع بالشعب أي بالديمقراطية، وعرض الأمر على البرلمان الذي رفض. إن بإمكان ولد الغزواني أن يفعل من ديمقراطيته الشيء نفسه لتساعده في القرارات الكبرى، ولن يتأتى له ذلك إلا بحل الأزمة الإنتخابية التي رافقت نجاحه أولا، ثم الأزمة السياسية العامة التي ظل سلفه يجرها وراءه طيلة فترة حكمه السيئ. إن مشاكل ولد الغزواني الأساسية سياسية واقتصادية وليست أمنية، وبالتالي سيواجه زيادة المصاعب عندما يعتمد النظرة العسكرية وهواجس الأمن في تسيير شؤون البلد، فقد انصبت جهود ولد عبد العزيز في تقوية الجيش الذي مازال في مرتبة تحتها دولتان فقط عالميا، دون أن يكسب أي رهان وطني، وليس في مقدور ولد الغزواني أن يكون مدجنا إلى هذه الدرجة.